 لوضع حد لمناوشات البوليساريو ـ التي اتبعت سياسة حرب العصابات ـ بالحدود الصحرواية لفرض الذات ككيان سياسي له حق في إدارة الأقاليم الصحرواية ما خلق شوشرة بالمنطقة، تم بناء جدار دفاعي عازل من طرف المغرب لوقف التأثير السلبي من جهة الجبهة المدعومة من طرف الجارة الجزائرية ـ بهدف ـ زعزعة الاستقرار القائم بالمنطقة الأمر الذي يلمس الأمن الداخلي للمغرب، وهو المسعى السيكولوجي للجزائر منذ حرب الرمال، وسنرى العوامل النفسية الدفينة وراء ذلك.
لوضع حد لمناوشات البوليساريو ـ التي اتبعت سياسة حرب العصابات ـ بالحدود الصحرواية لفرض الذات ككيان سياسي له حق في إدارة الأقاليم الصحرواية ما خلق شوشرة بالمنطقة، تم بناء جدار دفاعي عازل من طرف المغرب لوقف التأثير السلبي من جهة الجبهة المدعومة من طرف الجارة الجزائرية ـ بهدف ـ زعزعة الاستقرار القائم بالمنطقة الأمر الذي يلمس الأمن الداخلي للمغرب، وهو المسعى السيكولوجي للجزائر منذ حرب الرمال، وسنرى العوامل النفسية الدفينة وراء ذلك.
وكرد فعل من جهة المغرب على التصعيد العسكري الذي اتخذته الأطراف في النزاع ـ البوليساريو في الواجهة والجزائر خلفيا بالدعم ـ تقرر إنشاء الجدار العازل لحماية المنطقة وأمن الأقاليم. ف" بناء جدار الصحراء يعتبر أهم قرار عسكري اتخذه المغرب في هذا الملف. وبدأ المغرب بتشييد هذا الجدار الرملي سنة 1980 عبر مجموعة من المراحل، وانتهى منه سنة 1987، وبعد بناء 2200 كيلومتر من هذا الجدار، تغيرت إستراتيجية الصراع على الصحراء لصالح الجانب المغربي"(1).
أكذوبة المغالاة في حبّ الوطن وتراجيديا الإنسان العربي ـ فتحي الحبّوبي
 قد كان لي وطنٌ أبكي لـ نكبته ... واليوم لا وطنٌ عندي ولا سكنُ
قد كان لي وطنٌ أبكي لـ نكبته ... واليوم لا وطنٌ عندي ولا سكنُ
ولا أرى في بلادٍ كنت أسكُنها .... إلا حُثالة ناس قاءها الزمنُ" .
معروف الرصافي ( 1875م - 1945م)
ليس هناك في بلاد العرب "إلا حُثالة ناس قاءها الزمنُ"، هكذا قال معروف الرصافي شاعر العراق وكلّ العرب منذ أكثر من سبعة عقود من الزمن، في رؤية استتشرافية شديدة الوضوح، تحاكي وتتماهى مع واقع العرب اليوم ولا سيّما منهم السياسيين على وجه التحديد والتخصيص . حيث أنّه باستغباء واستخفاف مفضوح بذكاء الشعوب العربية، وفي محاولة بائسة ويائسة لاستبلاهها، يدّعي الكثير من السياسيين العرب أنّهم ابتلوا بالمغالاة في حبّ الوطن منذ نعومة أظفارهم بما يجعل هذا الحبّ يسري في عروقهم كمكوّن أساس لدمائهم "الملوّثة بفيروس الفساد والخيانة". فيما هم في حقيقة الأمر والواقع، قد ابتلوا بالمغالاة في حبّ ذواتهم على حساب الوطن الذي نكب، بالتأكيد، وابتلى بوجودهم أيّما نكبة وابتلاء . فهؤلاء السياسيون"محترفو التجارة بالوطنيّة " إنّما ابتلوا بالمغالاة "بكفاءة واقتدار"، في نهب الوطن كلّ حسب ما تيسّر له وما استطاع إلى النهب سبيلا. لذلك فالوطن العربي كان ولا يزال وسيظلّ على الأرجح، واقعا بين مطرقة نهب ساسته، محترفي الدجل والنصب من أبنائه "الوطنيين " المغالين في حبّ نهبه لا في حبّه كما يزعمون، وسندان الأطماع والديون الخارجيّة التي ستؤدّي به إلى إستجلاب المستعمر المتربّص به على الدّوام بمساعدة هؤلاء المغالين في حبّ الوطن إلى حدّ خيانته والتآمر عليه وفق مقولة "ما زاد على الحدّ إنقلب إلى الضدّ".
تاريخ الصراع الجيوبولوتيكي حول الصحراء في المغرب 3/5 : ـ جبهة البوليساريو ـ حمودة إسماعيلي
 مع بداية عقد السبعينيات، شهدت منطقة الصحراء نزاعا مصعدا بين المستعمر الإسباني من جهة، والأطراف المطالبة بأحقية السيادة على المنطقة من جهة أخرى : متمثلة في دولة المغرب وموريتانيا والجزائر، هذه الأخيرة فقط كداعم لحق الشعوب في الدفاع عن استقلالها وتحرير أراضيها. فاستمر التصعيد مع استمرار المستعمر الإسباني في رفض تسليم الصحراء والتخلي عن سياسة الاستعمار التعسفي. ف"رفض إسبانيا تخليها عن إقليم الصحراء كان يبرره منطق واحد، هو مخطط هذه الأخيرة حول إنشاء دولة مستقلة ذات حكومة محلية تحت وصاية وسيطرة إسبانية"(1).
مع بداية عقد السبعينيات، شهدت منطقة الصحراء نزاعا مصعدا بين المستعمر الإسباني من جهة، والأطراف المطالبة بأحقية السيادة على المنطقة من جهة أخرى : متمثلة في دولة المغرب وموريتانيا والجزائر، هذه الأخيرة فقط كداعم لحق الشعوب في الدفاع عن استقلالها وتحرير أراضيها. فاستمر التصعيد مع استمرار المستعمر الإسباني في رفض تسليم الصحراء والتخلي عن سياسة الاستعمار التعسفي. ف"رفض إسبانيا تخليها عن إقليم الصحراء كان يبرره منطق واحد، هو مخطط هذه الأخيرة حول إنشاء دولة مستقلة ذات حكومة محلية تحت وصاية وسيطرة إسبانية"(1).
بهذا، وإثر إحالة كل من المغرب وموريتانيا لملف القضية إلى محكمة العدل الدولية (1974) مع التساؤل حول الروابط التاريخية للمنطقة جغرافيا، وما تبعه من رد المحكمة (1975) المشوش حول القضية بتحفظها عن تأكيد تبعية المنطقة للسيادة المغربية، أعلن العاهل المغربي في خضم ما نتج عن ذلك ـ يوم 5 نوفمبر 1975 ـ عن تنظيمه لمسيرة وطنية شعبية لعبور منطقة الصحراء تأكيدا لمغربيتها سميت بالمسيرة الخضراء. "وبعد أربعة أيام على انطلاق المسيرة الخضراء بدأت اتصالات دبلوماسية مكثفة بين المغرب وإسبانيا للوصول إلى حل يضمن للمغرب حقوقه على أقاليمه الصحراوية وفي 14 نوفمبر 1975 وقع المغرب وإسبانيا وموريتانيا اتفاقية"(2). وهي اتفاقية مدريد التي تم بموجبها "إنهاء الوجود الإسباني على الأراضي نهائيا قبل 28 فبراير 1976"، مقابل "إشراكها (إسبانيا) في استغلال مناجم فوسفات بوكراع، وبقاء أسطول صيدها البحري في المياه الإقليمية الصحراوية، وبضمان قاعدتين عسكريتين لها قبالة جزر الكناري"(3). فسارعت كل من الدولتين المغربية والموريتانية لضم المناطق الممنوحة حسب الاتفاقية المذكورة بسيادة المغرب على ثلثي المنطقة وموريتانيا على الثلث الجنوبي، والذي سرعان ما تخلت عنه اثر الاشتباكات بينها وبين الجيش الشعبي لتحرير الصحراء (التابع للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب «البوليساريو» : المطالبة بتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية):
تاريخ الصراع الجيوبولوتيكي حول الصحراء في المغرب 2/5 : ما بعد فترة الاستعمار ـ حمودة إسماعيلي
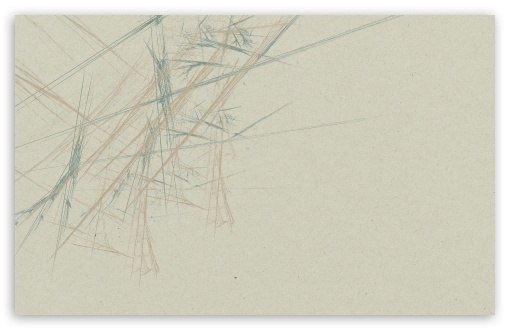 كسياسة احتواء للمقاومة الجزائرية، قامت فرنسا بفرض ضغوط على الدولة المغربية إثر دعمها للمقاومين الجزائريين، من خلال رسم مقنن للحدود بين البلدين حسب "معاهدة للا مغنية وهي تقييد إلزامي للمملكة المغربية سنة 1845 بعدم دعم المجاهدين الجزائريين. يأتي هذا الإلزام بعد تعنت من السلطان المغربي ضد مطالبة فرنسا المتكرر له بالكف عن دعم المجاهدين ضدها بالجزائر"(1). ولأهداف توسعية ذات مصالح اقتصادية قامت السلطة الاستعمارية الفرنسية بزيادة ضم أراضي حدودية مغربية لخريطة الجزائر.
كسياسة احتواء للمقاومة الجزائرية، قامت فرنسا بفرض ضغوط على الدولة المغربية إثر دعمها للمقاومين الجزائريين، من خلال رسم مقنن للحدود بين البلدين حسب "معاهدة للا مغنية وهي تقييد إلزامي للمملكة المغربية سنة 1845 بعدم دعم المجاهدين الجزائريين. يأتي هذا الإلزام بعد تعنت من السلطان المغربي ضد مطالبة فرنسا المتكرر له بالكف عن دعم المجاهدين ضدها بالجزائر"(1). ولأهداف توسعية ذات مصالح اقتصادية قامت السلطة الاستعمارية الفرنسية بزيادة ضم أراضي حدودية مغربية لخريطة الجزائر.
باستقلال المغرب، طالب هذا الأخير باسترجاع الأراضي التي ضمتها السلطة الفرنسية للجزائر، غير أن الاقتراحات التي اشترطتها فرنسا كتفاوض حول الموقف تم رفضها من طرف المغرب على اعتبار أنها تضر بمصالح الجارة الجزائرية. على إثر ذلك تم الاتفاق ـ من جهة المغرب ـ مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية (1958 - 1962) التي تم تشكيلها كتنفيذ لمقترح المجلس الوطني للثورة لأجل التفاوض حول مطلب الاستقلال وإعادة هيكلة الدولة. لكن مع تغير رموز السلطة بالحكومة الجزائرية إثر تنحية فرحات عباس من الرئاسة (1961) ثم استقالة بن يوسف بن خدة بعده من نفس المنصب (1962) وتولي أحمد بن بلة لرئاسة البلاد (1963) وما شهده الموقف من تصعيد لأزمة الحدود بين البلدين أسفرت عن اشتباكات مسلحة بالمنطقة، تم فتح فجوة في العلاقات السياسية بي البلدين أخذت شكل عدوان مباشر، نتيجة فشل التفاوض ورفض المقترح المغربي باستعادة الحدود. فسارعت التحالفات الدولية ـ المنقسمة سياسيا ـ لجذب الطرف الأقرب ميولا نحوها : بعرض المساعدات على الجزائر من طرف الكيانات الاشتراكية، وعلى المغرب من طرف الحلفاء الغربيين. الأمر الذي رسم بوضوح شكل العلاقة بين البلدين وسلط الضوء على أبعادها، في الفترة التي تلت حقبة الاستعمار.
تاريخ الصراع الجيوبولوتيكي حول الصحراء في المغرب 1/5 : كرونولوجيا الصراع ـ حمودة إسماعيلي
 قبل سقوط الفاشية متمثلة بأبرز أنظمة (دول) المحور على رأسها النظام النازي بقيادة هتلر Hitler، "وجد الأمريكان والسوفيات والبريطانيون فجأة أنهم يحاربون عدوٍّا مشتركًا، وهي الحقيقة التي أخذت صورتها الرسمية مع إعلان هتلر الحرب على الولايات المتحدة بعد يومين من الهجوم على بيرل هاربر Pearl Harbor. تدفق ما يزيد عن أحد عشر مليار دولار من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة إلى الاتحاد السوفييتي خلال الحرب، وهو ما يمثل أكبر تجسيد ملموس لحس المصلحة المشتركة الجديد الذي جمع بين واشنطن وموسكو"(1).
قبل سقوط الفاشية متمثلة بأبرز أنظمة (دول) المحور على رأسها النظام النازي بقيادة هتلر Hitler، "وجد الأمريكان والسوفيات والبريطانيون فجأة أنهم يحاربون عدوٍّا مشتركًا، وهي الحقيقة التي أخذت صورتها الرسمية مع إعلان هتلر الحرب على الولايات المتحدة بعد يومين من الهجوم على بيرل هاربر Pearl Harbor. تدفق ما يزيد عن أحد عشر مليار دولار من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة إلى الاتحاد السوفييتي خلال الحرب، وهو ما يمثل أكبر تجسيد ملموس لحس المصلحة المشتركة الجديد الذي جمع بين واشنطن وموسكو"(1).
أعلن هتلر الحرب على الاتحاد السوفياتي (روسيا)، ليتلقى مركز قيادة القوات المسلحة السوفياتية تقريرا عن بدء غزو القوات الألمانية للحدود السوفياتية وهي ما يعرف بعملية بارباروسا Unternehmen Barbarossa يوم 22 يونيو من سنة 1941. بعدها ب5 أشهر وفي نفس السنة ـ يوم 7 دجنبر 1941 ـ شنت اليابان هجوما على الولايات المتحدة الأمريكية عبر تنفيذ غارة جوية أدت إلى تدمير قاعدة بحرية بميناء بيرل هاربر بجزيرة أواهو (هاواي)، ما دفع بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في الحرب العالمية الثانية بإعلان الحرب على اليابان في 8 دجنبر 1941. بعد ذلك بسنة كانت القوات الأمريكية قد حطت الرحال بالأراضي الأوروبية للمساعدة في ردع العدوان الألماني التوسعي الممارس على بريطانيا.
حرية المعتقد بين العقل والنقل ـ اسماعيل فائز
 على سبيل التمهيد :
على سبيل التمهيد :
إن إثارة موضوع الحريات الفردية عامة، وحرية المعتقد خاصة في مجتمعاتنا الإسلامية لا يمكن تصنيفه في باب الترف الفكري، أو مضيعة الوقت، بل إنه ضرورة ملحة تدخل ضمن سيرورة بناء المجتمع. وأحيانا لا يكون البناء إلا عبر الهدم، هدم الأفكار والمقولات الجاهزة التي تستولي على القلوب والعقول .
نعتقد أن بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي يقتضي الدفاع عن حقوق الإنسان، والعمل على احترامها. وقد ينازعنا البعض في مشروعية طرح هذا الموضوع لاعتبارات عدة يمكن إدراجها تحت مسمى "الوصاية" سواء الفكرية أو الدينية أو الاجتماعية. وحتى نبسط الإشكال بوضوح، ويسهل علينا وعلى القارئ تتبع الخيط الناظم للموضوع، سنسترشد بالتساؤلات الآتية :
ما المبررات التي تضفي المشروعية على إثارة موضوع كهذا في مجتمعاتنا التي تعيش استبدادا سياسيا وأزمات اقتصادية واجتماعية؟ ثم هل ينبغي فعلا الدفاع عن حرية المعتقد؟ ولماذا؟ وهل انتصر الإسلام، فعلا، لحرية المعتقد؟ ماذا بشأن الأحكام الفقهية التي توجب قتل المرتد في الإسلام؟...هذه إذن ثلة من الأسئلة التي نروم في هذه الورقة تسليط الضوء عليها، ومناقشتها بغية بلورة إجابة تظل بدورها قابلة للنقاش.
تعقل الإرهاب من منظور الفلسفة المعاصرة ـ خالد كلبوسي
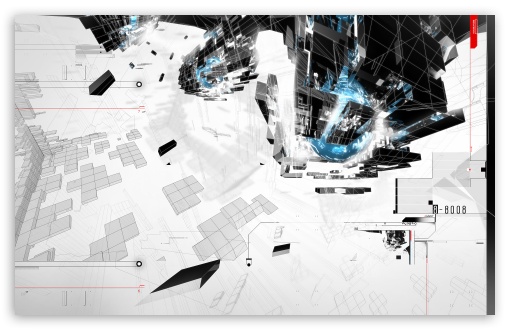 تسارعت , كما نعلم , خلال شهر نوفمبر 2015 وتيرة العمليات الإرهابية ـــ و التي تسميها الجهة التي تتبناها عمليات جهادية أو استشهادية ــ خارج الخارطة الجيوسياسية المعروفة منذ التدخل الأمريكي في أفغانستان و العراق حيث برزت القاعدة في المشهد بداية و تلاها بروز ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق و الشام (داعش) لاحقا ليشمل سوريا ثم بقية العالم . فمن بيروت , مرورا بباريس و باماكو و تونس العاصمة ,و أخيرا داخل الولايات المتحدة الأمريكية ,و يبدو أن القائمة مرشحة للازدياد , خلفت هذه العمليات مئات القتلى و الجرحى بين المدنيين خاصة ,مثيرة مشاعر الأسى و الهلع و ردود أفعال سياسية عالمية , الأمر الذي يستنهض من جديد التساؤل و الجدل حول هذه الظاهرة بين عموم الناس و لكن كذلك بين صفوف الدارسين و المحللين و المفكرين و الفلاسفة مثلما وقع بعيد تفجيرات 11 سبتمبر 2001 الشهيرة حيث شملت العمليات الإرهابية لأول مرة الدولة التي يعتقد , إثر انتهاء "الحرب الباردة" أنها القوة العظمى في العالم .
تسارعت , كما نعلم , خلال شهر نوفمبر 2015 وتيرة العمليات الإرهابية ـــ و التي تسميها الجهة التي تتبناها عمليات جهادية أو استشهادية ــ خارج الخارطة الجيوسياسية المعروفة منذ التدخل الأمريكي في أفغانستان و العراق حيث برزت القاعدة في المشهد بداية و تلاها بروز ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق و الشام (داعش) لاحقا ليشمل سوريا ثم بقية العالم . فمن بيروت , مرورا بباريس و باماكو و تونس العاصمة ,و أخيرا داخل الولايات المتحدة الأمريكية ,و يبدو أن القائمة مرشحة للازدياد , خلفت هذه العمليات مئات القتلى و الجرحى بين المدنيين خاصة ,مثيرة مشاعر الأسى و الهلع و ردود أفعال سياسية عالمية , الأمر الذي يستنهض من جديد التساؤل و الجدل حول هذه الظاهرة بين عموم الناس و لكن كذلك بين صفوف الدارسين و المحللين و المفكرين و الفلاسفة مثلما وقع بعيد تفجيرات 11 سبتمبر 2001 الشهيرة حيث شملت العمليات الإرهابية لأول مرة الدولة التي يعتقد , إثر انتهاء "الحرب الباردة" أنها القوة العظمى في العالم .
ــ الفلسفة كتفكير في الراهن أو كانطولوجيا للزمن الحاضر:
من المعلوم أن هيغل اعتبر أن قراءة الصحف هو من بين الأمور التي تميز إيقاع العصر الحديث , كونها تهتم بالراهن.لكن اهتمام الفيلسوف بالأحداث الراهنة المعاصرة له تختلف عن اهتمام الصحفي بالأمر. و وجه الاختلاف يتمثل أساسا في عدم الاكتفاء بنقل الحدث أو المعلومة بلغة الحياة اليومية التي تثير صعوبات أكثر مما تقدم توضيحات ,بينما المطلوب التفكير في الحدث نفسه من خلال مفهمته , أي طلب ما هو كلي في الجزئي .هكذا كان الأمر مع كانط حينما قدم إجابة عن سؤال: ما هو عصر الأنوار ؟, ذلك النص الذي اعتبره فوكو فاتحة للفلسفة كتفكير في الراهن أو كانطولوجيا الزمن الحاضر,حيث قدم كانط مفهوما لعصر معين هو عصر الأنوار أي محاولة لعقلنة الأمر على نحو فلسفي كلي.مثل هذا الأمر قام به كارل ماركس كذلك في " 18 برومير" حيث أخضع أحداث ذلك التاريخ للتحليل المادي التاريخي الذي أسس له في "الإيديولوجيا الألمانية" .
رسالة إلى الوالي ـ رشيد اليملولي
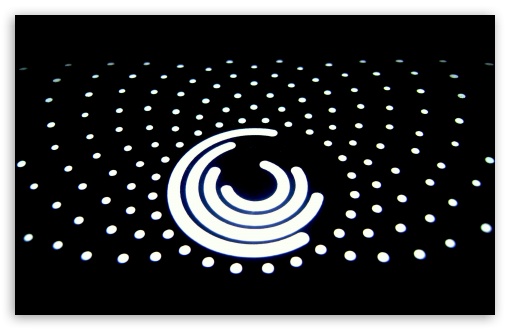 تتنازعنا المخاوف و تلتحفنا الهواجس ، و نرابط مكاننا علنا نجد السلوى و الأمان ، و ترمح في دواخلنا المزيد من أنواع الرهاب ، و تتراءى لنا مقولة الأمن شطحة من شطحات الخيال ، و لعلها في أحسن الأحوال صنعة يعتاش بها النظام السياسي و الاجتماعي ، و لا يأبه بارتداداتها المتعلقة بالاقتصاد النفسي الذي يحفز الذات على إنتاج السلبية و العدمية و الاستقالة ، تتحول بموجبها الوطنية إلى إحساس عابر تغيب فيه القدرة على التضحية ، و تزف فيه ساعة الموت الحضاري .
تتنازعنا المخاوف و تلتحفنا الهواجس ، و نرابط مكاننا علنا نجد السلوى و الأمان ، و ترمح في دواخلنا المزيد من أنواع الرهاب ، و تتراءى لنا مقولة الأمن شطحة من شطحات الخيال ، و لعلها في أحسن الأحوال صنعة يعتاش بها النظام السياسي و الاجتماعي ، و لا يأبه بارتداداتها المتعلقة بالاقتصاد النفسي الذي يحفز الذات على إنتاج السلبية و العدمية و الاستقالة ، تتحول بموجبها الوطنية إلى إحساس عابر تغيب فيه القدرة على التضحية ، و تزف فيه ساعة الموت الحضاري .
تستمد السلط النامية كينونتها من الطاعة و الإذعان ، و من اقتصاد الخوف على الشرعية و المشروعية سواء بسواء ، و تبرر القول و اللجاج بالخوف من الفتنة لدرجة تحولت معه السلطة إلى فتنة ، تسور ذاتها بالسيف و تستقوي على الاختلاف بالآرية و الشرف و نبالة الدم ، و تغد السير قدما نحو إنتاج و إعادة إنتاج الإدماج بمفهوم الصهر و التذويب ، و إحلال الفزاعات البشرية محل الذوات و الكائنات النوعية .
الأرجح أن الخطر الحقيقي لا يكمن في الاستبداد نفسه ، بقدر ما يتمثل في مناورات إخفائه لتمييع مواجهته و التسليم بخيرته ، و تأجيل لحظات الانتقال ، فلا السلطة تملك ناصية إنتاج ذاتها ( تنميتها ) ، و لا المجتمع قادر على تجاوز أزماته ، لتنحل المسألة تدبيرا للأزمة ، و تعميقا للعطل الحضاري الشامل ، لترتد العملية في محصلتها النهائية العجز عن التفرقة بين ضرورة الاستبداد سواء كان مستنيرا أو طاغيا ، و مضاعفاته الخطيرة .










