 يرنو الحديث عن جدل الديني والسياسي في الفضاء العربي الاسلامي لحظة تحول صعب، تعتور جسدا على وشك الوضع، أو ما يسمه الباحث الفرنسي أوليفي روا ب"الإسلام السياسي" انشغالا مركزيا، يدخل ضمن خارطة اهتمامات باحثي العلوم السياسية والحركات الدينية وغيرهم، ويتغدى هذا الاهتمام راهنا، من كونه أضحى نقاشا يثير صخبا حادا من طرف جل أطياف الفعل السياسي، قياسا بحساسيته لدى البعض، وبراهنيته لدى الآخر في فهم مخاضات عميقة تعتمل داخل مختبر السياسة بالعالم العربي الاسلامي .
يرنو الحديث عن جدل الديني والسياسي في الفضاء العربي الاسلامي لحظة تحول صعب، تعتور جسدا على وشك الوضع، أو ما يسمه الباحث الفرنسي أوليفي روا ب"الإسلام السياسي" انشغالا مركزيا، يدخل ضمن خارطة اهتمامات باحثي العلوم السياسية والحركات الدينية وغيرهم، ويتغدى هذا الاهتمام راهنا، من كونه أضحى نقاشا يثير صخبا حادا من طرف جل أطياف الفعل السياسي، قياسا بحساسيته لدى البعض، وبراهنيته لدى الآخر في فهم مخاضات عميقة تعتمل داخل مختبر السياسة بالعالم العربي الاسلامي .
ولئن بدا ظاهريا الحضور القوي اليوم للحركات الاسلامية في المشهد السياسي، منذ انطلاقة ما يعرف بثورات الربيع العربي، فلأن هناك حديثا موازيا عن بداية مراجعات عميقة داخل هذه الحركات الاسلامية، في سياق ما ينعت ب"أسلمة الحداثة" أو "تحديت الاسلام" تكيفا مع واقع جديد.
أثارت إشكالية علاقة الدين بالسياسة جلبة واسعة بين المختصين، بدرجات مختلفة، وفي سياقات جغرافية متغايرة، وركزت مجمل هذه المساهمات التنظيرية عند منطلقات ولادة ما يسمى ب"الحركات الاسلامية"، وحدود اخفاق سكب ورسكلة الحداثة الغربية في الأصالة الحضارية ضمن مسيرة التاريخ للعالم العربي الاسلامي، إلى درجة جعلت البعض يتحدث عن حدوت زمن احتمالي رابع جديد للتطور الحضاري.
تنطرح جملة تساؤلات جديدة حول ما يرهن وضع العالم العربي الاسلامي، في سياق الصعود المفاجئ لحركات الاسلام السياسي، واعتلائها السلطة في معظم دول الثورات العربية، ثم السقوط السريع لبعضها في مصر مثلا، بلد المنشأ، وما استتبعه من موجات غضب متصاعدة، وصلت إلى درجة المواجهة مع هذه التيارات في عدد من هذه الدول ، مما يغذي نظريا ضرورة إعادة فتح النقاش حول هكذا موضوع بتساؤلات راهنة، تستقرئ المنجز السياسي للحركات الاسلامية، وتقف عند مطباتها في سياق الانتقال من الدعوي نحو السياسي، من السري نحو العلني، كيف يمكن فهم وتفسير أسباب سقوط السريع للإسلام السياسي في بعض من الدول العربية؟ وهل فكرة الاسلام السياسي تؤدي بالضرورة إلى الشمولية، ومن ثمة العنف؟ أية سيناريوهات مستقبلية تطرح بخصوص هذه الحركات؟ وبأية منطلقات فكرية ونظرية ستصمد حركات الاسلام السياسي أمام لهيب الشارع العربي ومطالب الشباب المستفحلة؟
التنسيقيات أو البديل النقابي بالمغرب : نحو محاولة للفهم ـ احمد اولاد عيسى
 من العادي جدا أن ينتمي الفرد لتنظيم ما, كيفما كانت طبيعة اشتغاله, سواء أكان في المجال الحقوقي أو السياسي أو النقابي....على أن يتم الانخراط على أساس البرامج أو المشاريع المعتمدة من قبل هذا التنظيم المختار.
من العادي جدا أن ينتمي الفرد لتنظيم ما, كيفما كانت طبيعة اشتغاله, سواء أكان في المجال الحقوقي أو السياسي أو النقابي....على أن يتم الانخراط على أساس البرامج أو المشاريع المعتمدة من قبل هذا التنظيم المختار.
غير أن الواقع يعج بالكثير من المتناقضات بخصوص محددات الانتماء إلى هذه التنظيمات واخص بالذكر التنظيمات النقابية، إذ لم يعد البرنامج أو المشروع النقابي محددا مركزيا في تحديد الانتماء ،بل هيمنت محددات أخرى ليس لها طبيعة معينة ،غير أنها تظل هي المحدد الأساسي و الغالب في الانتماء هذه الأخيرة لها تمظهرات عدة اغلبها تطبعها السمة النفعية و البرغماتية بشكل صرف، سواء تعلق الأمر بعلاقة الفرد بالقيادة التنظيمية أو القيادة بالفرد.
فعن هذه الجدلية في الارتباط والتي أملتها سياقات تاريخية اجتمعت فيها عوامل عدة، سياسية و اقتصادية وثقافية،ساهمت بشكل مباشر بتفكيك و انقسام الجسم النقابي بالمغرب، وإيصاله إلى وضعية الترهل والوهن البنيوي .
ولمحاولة فهم هده الأنساق والمسببات، يتطلب الأمر منا طرح مجموعة من الفرضيات من قبيل: هل الانتماء إلى النقابة مسألة ظرفية أم قناعة وجدانية ؟ هل بنية التنظيم قادرة على الاستمرار في فرض هذه المحددات أم أن الضرورة فرضت ذلك ؟
فن الإصغاء إلى الذات وتنمية الاهتمام بالعالم ـ د.زهير الخويلدي
 " على الإنسان أن يعرف كل شيء لكي يقرر...لأن أفضل ما يمكن من الاقتدار في العيش يعتمد على الدرجة التي نعرف بها أنفسنا بوصفها الأداة التي توجه نفسها في العالم وتكون القرارات."1[1]
" على الإنسان أن يعرف كل شيء لكي يقرر...لأن أفضل ما يمكن من الاقتدار في العيش يعتمد على الدرجة التي نعرف بها أنفسنا بوصفها الأداة التي توجه نفسها في العالم وتكون القرارات."1[1]
ما انفك البعض يدق النواقيس حول جدية المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العرب في المستقبل ، والسبب ما يعانونه من أزمة حقيقية عصفت بكل مقدراتهم في الوجود وأضعفت مدخراتهم في الاستثبات والبقاء.
لقد بدأت علامات التأخر الحضاري تظهر بوضوح يوم توقف الاجتهاد الفقهي وتفككت جل مؤسساتهم الروحية التي ظلت ترعى لقرون طويلة وحدتهم الرمزية وأخفق المشروع النهضوي الأول بصورة مسترابة وذهبت الوعود الغربية بعيد الثورة بالمساعدة على إقامة الدولة الأمة الواحدة أدراج الرياح.
لم تنقشع الظلمات القروسطية التي خيمت على الأجواء العربية بمجرد تعبير بعض التيارات السياسية الوليدة عن نواياها في استعادة بعض الكنوز النيرة ورغباتهم في تشغيل عدد من الخيارات العقلانية.
حال الحرية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان ـ د.زهير الخويلدي
 "ماهي لحظة الشعور باحترام الذات؟...احترام ذاتي الذي أبحث عنه عن طريق احترام الآخر ليس من طبيعة مختلفة عن الاحترام الذي أبديه نحو الآخر، فإذا كانت الإنسانية هي التي أحترمها في الآخر وفي ذاتي ، فإني أحترم ذاتي كأنت بالنسبة للآخر، أحترم ذاتي كشخص آخر... وأحب نفسي كآخر"1[1]
"ماهي لحظة الشعور باحترام الذات؟...احترام ذاتي الذي أبحث عنه عن طريق احترام الآخر ليس من طبيعة مختلفة عن الاحترام الذي أبديه نحو الآخر، فإذا كانت الإنسانية هي التي أحترمها في الآخر وفي ذاتي ، فإني أحترم ذاتي كأنت بالنسبة للآخر، أحترم ذاتي كشخص آخر... وأحب نفسي كآخر"1[1]
يحتفل البشر في جميع أنحاء المعمورة باليوم العالمي لحقوق الإنسان ولقد اقترن هذا العيد بالإعلان العالمي 10 ديسمبر 1948 والذي قامت فيه منظمة الأمم المتحدة بتدويل قضية الحريات والحقوق على مختلف الشعوب والجماعات والأفراد خارج منطق التمييز والإقصاء وجدلنة العلاقة بين المحلي والكوني.
غير أن واقع الاعتداء على حقوق الإنسان اليوم وتغييب مفاهيم الحريات التي ينبغي أن تتمتع بها كل ذات هو أمر لا يمكن تغييبه ومعطى لا يجب إهماله وتناسيه بما أن الحروب والفتن بين الدول بلغت حدا لا يطاق وأصابت مخلفاتها مقومات الحياة ولم يسلم من أخطارها أحد في الكوكب. ولعل الحرية الإنسانية هي أكبر الأضرار وأشد القيم التي تسير نحو الاختفاء بسبب انتشار نزعات التدمير الممنهج وغزوات دعاة الهمجية وصعود موجات امبراطورية مضادة تكرس منطق القوة وتستعدي قيم العدل والمساواة والكرامة.
في هذا السياق ماهي الشروط التي يجب توفيرها من أجل صيانة منظومة حقوق الإنسان من كل اعتداء؟ وكيف توضع مقولة الحرية على رأس الأولويات التي ينبغي على الهيئات والدول أن تعتني بتوفيرها؟
عقلانية التشاؤم وتفاؤل الإرادة : قراءة في كتاب " الإهانة في زمن الميغا إمبريالية" للمهدي المنجرة ـ عبد الحكيم الزاوي

وفاة "مثقف الكرامة" وصف ب" الخسارة الفادحة" التي عرفها الوسط الاكاديمي المغربي والاقليمي والدولي قيمة وقامة، ورمزا لمناهضة الظلم والذل والفقر و"الاستعمار الناعم "، فإستطاع أن ينقل المقررات الأكاديمية من مدرجات الجامعات والمختبرات العاجية إلى ميدان الاصلاح والتقدم والنهضة، من موقع الخبير الاستراتيجي الذي لا يتوقف عند حدود التشخيص، بل يتعداه الى التوقع والتدخل لمعالجة الاعطاب التنموية التي راكمها العالم الثالث على امتداد مساره.
التنمية السياسية ـ رشيد اليملولي
 يقصد بالتنمية السياسية مجمل القيم و التصورات و الأفكار و الاتجاهات ، التي تؤسس للنهضة و القطيعة مع عوائق و معيقات الارتداد ، في سبيل تأبيد و استدامة السلطوية و الميتافيزيقا ، و المطلق و داء التراث ، عبر التوسل بخطاب يمتح خصوصيته من مجال الفتنة و الرهاب من الاختلاف و من الأفق .
يقصد بالتنمية السياسية مجمل القيم و التصورات و الأفكار و الاتجاهات ، التي تؤسس للنهضة و القطيعة مع عوائق و معيقات الارتداد ، في سبيل تأبيد و استدامة السلطوية و الميتافيزيقا ، و المطلق و داء التراث ، عبر التوسل بخطاب يمتح خصوصيته من مجال الفتنة و الرهاب من الاختلاف و من الأفق .
لذا ؛ يكتسي مفهوم التنمية السياسية بعدا حضاريا من خلال قدرته على تقديم بدائل الرقي و البناء ، بعيدا عن الصيغ و القوالب الجاهزة ، و استحضار القيمة الإشكالية للبناء و إعادة البناء ، انطلاقا من الهاجس و البعد التنموي ، الذي يرفض المحافظة و التقليد و المحاكاة ، و يستثمر البعد الخلاق للرصيد الحضاري لدى الشعوب التي حققت النقلة و الطفرة المرجوة .
يتركز المستوى النوعي للرؤية السياسية على سمات و خصائص و مستوى تطور المجالات الأخرى ؛ إذ تبطن هذه الرؤية مضامين اجتماعية و اقتصادية و حقوقية و ثقافية و تربوية و إدارية [1] ، لذا ركزت نظريات التحديث و التنمية السياسية على أن التنمية متغير مستقل ، و الديمقراطية متغير تابع ، ذلك ما يفيد أن تحقق الديمقراطية يتأتى انطلاقا من شروط النمو الاقتصادي و التعليم و الصحة و الثقافة المدنية [2] ؛ بمعنى أن الديمقراطية السياسية مرهونة بالمشروع المجتمعي الذي يقف فيه مفهوم الإنسان مقياسا لنظام القيم و العقل و العمل و الإنتاج و المعرفة ، إنسان الحضارة و الثقافة و التمدن [3] ، بعيدا عن التوظيف الأداتي لمفهوم الديمقراطية ، أي إرجاءها أو تعطيلها تحت مبررات الخصوصية الدينية أو الثقافية ، عن طريق فتح هوامش ضيقة للحرية و المساواة ، أو ببناء أجيال ضعيفة الوعي ضحلة النضج [4] ، و هو ما صاغ التخلف باعتباره قاعدة القمع الاجتماعية التي تنتج أنظمة القمع ، و توطد قيم و مفاهيم و مؤسسات التخلف [5] .
جدل الهوية الوطنية والدين والعلمانية في الدولة الديمقراطية ـ د. حبيب حداد
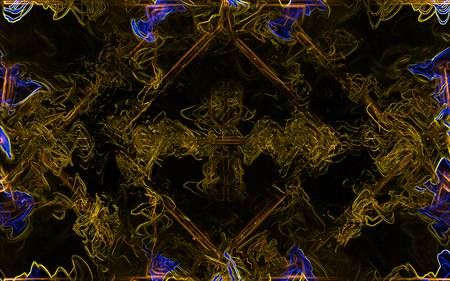 شغلت مسالة العلاقة بين العلمانية والديمقراطية من جهة، وكذلك العلاقة بين كل من الهوية الوطنية والدين، اي الدين الإسلامي، العلمانية والديمقراطية من جهة ثانية، حيزا واسعا كما هو معروف في الرؤية الفكرية والسياسية للنخب والأحزاب والحركات الاصلاحية على امتداد القرن الماضي وفي كل المجتمعات العربية تقريبا. وبطبيعة الحال فقد كان الجدل والصراع حيال هذه القضايا على اشده في هذه المجتمعات وخاصة بعد الانتقال من مرحلة الكفاح الوطني لنيل الاستقلال من الاستعمار المباشر الى مرحلة الكفاح والتحرر المجتمعي الذي كان هدفه المحوري بناء الدولة المدنية الديمقراطية على اسس الحرية والعدالة والحداثة ومواكبة مسار العصر. واذ نكرس حديثنا هنا لهذا الموضوع فان ما نرغب في توكيده هو اننا لا نرمي من وراء ذلك الغوص في مسائل نظرية او ايديولوجية بحتة فليس هذا هو مكانها ,وليس الأن هو زمانها، حيث بلادنا تغرق في خضم مأساة مصيرية تهدد مستقبلها بل ووجودها من اساسه، وتستدعي منا قبل أي شيء آخر توحيد ارادتنا واستعادة وتمتين وحدتنا الوطنية والمبادرة الجماعية للقيام بكل ما من شأنه انقاذ وطننا. لكن الاستعراض الوجيز للموقف من تلك القضايا وفي مرحلة. المد التحرري لشعوبنا العربية في عقدي الخمسينات والستينات من القرن الماضي وكيف كان نهج واسلوب التعامل معها ,وبالتالي الى اي مدى امكن التعايش معها ,ومن ثم مقارنة دروس تجارب تلك المرحلة التاريخية بما نشهده من ازمة شاملة تعيشها بلداننا اليوم بعد اخفاق مشاريع الثورات التحررية التي جاءت في سياق ما سمي بالربيع العربي , ان ذلك هو امر ضروري وحيوي كي نعي وندرك الى اين نحن سائرون؟ وما هي صورة المستقبل الذي ينتظرنا اذا نحن لم نستعد ذاتنا المغيبة ونمتلك مصيرنا المرتهن ونستعيد مسارنا في الاتجاه الصحيح ؟
شغلت مسالة العلاقة بين العلمانية والديمقراطية من جهة، وكذلك العلاقة بين كل من الهوية الوطنية والدين، اي الدين الإسلامي، العلمانية والديمقراطية من جهة ثانية، حيزا واسعا كما هو معروف في الرؤية الفكرية والسياسية للنخب والأحزاب والحركات الاصلاحية على امتداد القرن الماضي وفي كل المجتمعات العربية تقريبا. وبطبيعة الحال فقد كان الجدل والصراع حيال هذه القضايا على اشده في هذه المجتمعات وخاصة بعد الانتقال من مرحلة الكفاح الوطني لنيل الاستقلال من الاستعمار المباشر الى مرحلة الكفاح والتحرر المجتمعي الذي كان هدفه المحوري بناء الدولة المدنية الديمقراطية على اسس الحرية والعدالة والحداثة ومواكبة مسار العصر. واذ نكرس حديثنا هنا لهذا الموضوع فان ما نرغب في توكيده هو اننا لا نرمي من وراء ذلك الغوص في مسائل نظرية او ايديولوجية بحتة فليس هذا هو مكانها ,وليس الأن هو زمانها، حيث بلادنا تغرق في خضم مأساة مصيرية تهدد مستقبلها بل ووجودها من اساسه، وتستدعي منا قبل أي شيء آخر توحيد ارادتنا واستعادة وتمتين وحدتنا الوطنية والمبادرة الجماعية للقيام بكل ما من شأنه انقاذ وطننا. لكن الاستعراض الوجيز للموقف من تلك القضايا وفي مرحلة. المد التحرري لشعوبنا العربية في عقدي الخمسينات والستينات من القرن الماضي وكيف كان نهج واسلوب التعامل معها ,وبالتالي الى اي مدى امكن التعايش معها ,ومن ثم مقارنة دروس تجارب تلك المرحلة التاريخية بما نشهده من ازمة شاملة تعيشها بلداننا اليوم بعد اخفاق مشاريع الثورات التحررية التي جاءت في سياق ما سمي بالربيع العربي , ان ذلك هو امر ضروري وحيوي كي نعي وندرك الى اين نحن سائرون؟ وما هي صورة المستقبل الذي ينتظرنا اذا نحن لم نستعد ذاتنا المغيبة ونمتلك مصيرنا المرتهن ونستعيد مسارنا في الاتجاه الصحيح ؟
صنعة السياسي في سياق غير مُعرّف ـ د.زهير الخويلدي
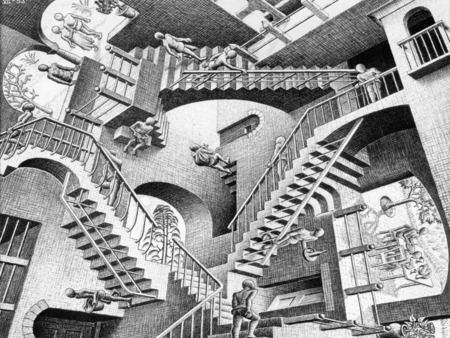 " ثمة أزمة بما أن الميدان السياسي يهدد ما يُكَوِّنُ مُسَوِّغَهُ الوحيد. لقد تغير في هذه الوضعية السؤال عن معنى السياسة. و لم يعد اليوم، بالكاد: ماهو معنى السياسة؟. انه من المناسب... التساؤل ومسائلة الآخرين: هل مازال للسياسة معنى في نهاية المطاف."1[1]
" ثمة أزمة بما أن الميدان السياسي يهدد ما يُكَوِّنُ مُسَوِّغَهُ الوحيد. لقد تغير في هذه الوضعية السؤال عن معنى السياسة. و لم يعد اليوم، بالكاد: ماهو معنى السياسة؟. انه من المناسب... التساؤل ومسائلة الآخرين: هل مازال للسياسة معنى في نهاية المطاف."1[1]
لقد أدى تكرار التعثر في المجال السياسي زمن اللاّيقين واشتداد الاضطراب وفشل الانتقال بعد حدوث ثورات الحراك العربي إلى طرح مسألة التقييم بصورة جدية لأن مستقبل الجماعة التاريخية الناطقة بلغة الضاد صار مهددا وباتت مسألة صيانة الوجود وحفظ الكيان من الأمور الحيوية والتدبيرات المصيرية.
لقد صارت السياسة عدنا من كثرة الاهتمام بها والاشتغال عليها روتينا ضاغطا وشأنا يوميا وفقدت بريقها وطمست معالمها واستهلكت من شدة تداولها ولكي يتم تحريرها حيثما كانت أسيرة يجدر التساؤل عن السياسي في السياسة من وجهة النظر التي تخص حضارة أقرأ ومن زاوية السوسيولوجيا وفلسفة الحق.
لقد ألقيت كل التهم والتشكيك على كاهل السياسي وتحملت الطبقة السياسية الصاعدة معظم التعزيرات ونعتت بالتقصير وعدم الكفاءة وقلة الخبرة وغياب الأهلية ونقص في الجدارة ووجهت أصابع الاتهام الى رؤساء الأحزاب وزعماء التيارات ورجالات الدولة وتحملت النخب المتعلمة والمثقفة قسطا من الشتائم.










