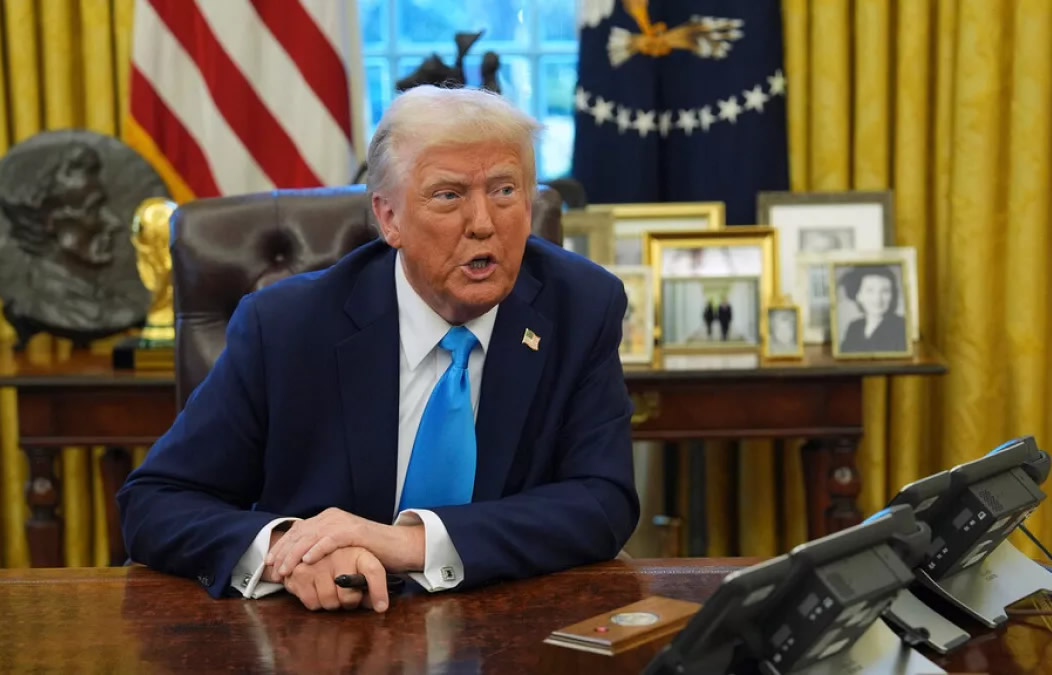توجيه الوعي لتعزيز الثقافة الرأسمالية النيو ليبرالية
إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي لتعظيم الأرباح وترسيخ السيطرة الاجتماعية، تُوظَّف هذه التكنولوجيا بشكل ممنهج لتشكيل وعي الأفراد وتوجيهه تدريجيًا، بهدف تعزيز الثقافة والأفكار الرأسمالية، وخصوصًا تمجيد الحضارة الغربية، وبشكل أكثر تحديدًا القيم الرأسمالية الأمريكية. من خلال تحليل البيانات وسلوك المستخدمين والمستخدمات، تُستخدم الخوارزميات للتحكم في المحتوى الذي يُعرض لهم عبر المنصات الرقمية، مثل شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وغيرها، ويتم تصميمها بحيث تُغذّي الأفراد بمحتوى يتماشى مع القيم التي تدعم الرؤية الرأسمالية وسياساتها وافكارها.
على سبيل المثال، وفي معظم المنصات الرقمية، تُعرض الإعلانات والمحتويات الترويجية التي تُشجّع الأفراد على شراء المزيد من المنتجات، حتى عندما لا تكون لديهم حاجة حقيقية لها. كما يتم الترويج لقيم الرأسمالية مثل أزلية الملكية الخاصة، والتفاوت الطبقي، والنجاح الفردي، والثروة، والاستهلاك، وأنماط الحياة الفاخرة كمعيار للحياة "الناجحة". مثال آخر على ذلك هو خوارزميات محرك البحث "غوغل"، التي تُصنّف النتائج وفقًا لمنطق السوق والإعلانات المدفوعة، لا وفقًا للأهمية الاجتماعية أو الفكرية أو العلمية للمحتوى. فعند البحث عن مفاهيم مثل "النجاح"، "التنمية الذاتية"، أو حتى "السعادة"، تظهر النتائج الأولى مرتبطة بشركات تطوير الذات، ودورات مدفوعة، ونصائح استهلاكية تقوم على الفردانية والربح، في مقابل تغييب أو تهميش التحليلات العلمية الرصينة والأفكار اليسارية والتقدمية، بل وحتى عدم اظهارها ويعني حضرها بأشكال مباشرة أو غير مباشرة في العديد من الحالات.
يؤدي هذا إلى توجيه الوعي الجماعي نحو قبول هذه القيم باعتبارها طبيعية وحتمية. ويتم ذلك بأسلوب تدريجي ناعم وغير محسوس وعلى مدى زمني طويل، إلى الحد الذي يجعل معظم مستخدمي ومستخدمات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بمن فيهم أصحاب الفكر اليساري والتقدمي، يعتقدون أنها أدوات محايدة. إن هذه السياسة تُشكل خطرًا بالغًا على الأجيال القادمة، التي أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من حياتها اليومية، وتُسهم هذه الأساليب والسياسات الدقيقة في تكريس الهيمنة الرأسمالية أكثر فأكثر، وتعزيز ولاء الجماهير وخنوعها للنظام القائم.