 مقدمة:
مقدمة:
لقد ظهرت الحاجة إلى مكافحة الجريمة، عندما بدأ الإنسان ينظم حياته في إطار تجمعات بشرية، بدأت صغيرة متفرقة لتصبح على ما هي عليه الآن من التوسع والكثرة، وقد شكل تطور الإنسان والحضارة عبر التاريخ وتآلف الأفراد في مجتمعات ودول وقارات، علة وضع قوانين وأحكام أقرت حماية الحقوق، والتحمل بالالتزامات، فأدت إلى تجريم التصرفات التي لا تتوافق مع النظام العام، ولهذا أحدثت لهذه الغاية جهات مختلفة أنيط بها وضع القوانين، وإقامة الدعوى العمومية وتوقيع العقوبات والعمل على تنفيذها، في إطار ما يعرف بآليات السياسة الجنائية[1].
واعتبرت الجريمة منذ بروز البشرية، مشكلة مستعصية، لم توفر لها العقوبة إلا حلا جزئيا مؤقتا[2]، لذا تضافرت جهود دول العالم لإظهار معالم سياساتها الجنائية، في تشريعاتها، فهي التي تشكل في تلازمها وشموليتها مدى نجاعة السياسة الجنائية المتبعة لمكافحة الجريمة[3]، مع العلم بأنه من الحقائق الثابتة تاريخيا، أن الجريمة ظاهرة مادية في كل مجتمع إنساني، غير أن سبل محاربتها وطرق مجابهتها، تختلف من بلد إلى أخر وهو ما يتضح من خلال التعريف الذي أعطاه فيورباخ feurbach للسياسة الجنائية باعتبارها مجموعة الوسائل التي يمكن اتخاذها في وقت معين وفي بلد معين من أجل مكافحة الإجرام[4].
فالسياسة الجنائية لا تجمع كل الإجراءات التي تتصرف بها الدولة في مواجهة الجريمة، هذه الإجراءات نوعان قد تكون وقائية وقد تكون زجرية(أو ردعية).
فالسياسة الجنائية لا تخص الوقاية أي أنها لا تتضمن الإجراءات الوقائية، لأن هذه الأخيرة من اختصاص الدولة، والسياسة الوقائية مهما كانت جيدة، لا يمكنها بأي حال أن تقبر الإجرام، لهذا تجد الدولة نفسها أمام ضرورة ممارسة مهمتها الثانية والتي تتمثل في السياسة الجنائية لزجر ومعاقبة المجرمين[5]. هذه المهمة تظهر جليا ويعنى بها جيدا في الدول التي تميل سياساتها إلى الطابع السلطوي أو الاستبدادي ومن هنا تتبين العلاقة الوطيدة بين السياسة العامة والسياسة الجنائية للدولة بحيث الأولى ترسم الثانية.
نجومية السياسة - إدغار موران ـ ترجمة : مصطفى ناجي
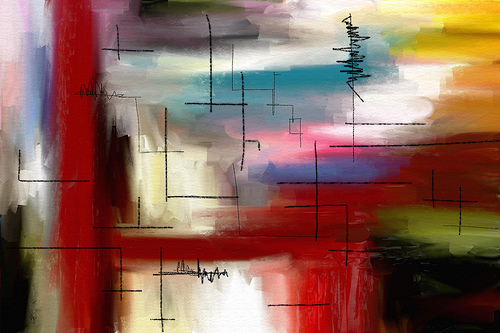 تقديم
تقديم
يقارب موران في هذا المقال موضوعا راهنا تمثل في التحول الكبير الذي تشهده الحياة السياسية في الغرب، حيث انتقلت علاقة المواطن بالشأن السياسي من الاهتمام بالقضايا الكبرى والأفكار والبرامج إلى الانشغال بالأمور الشخصية للفاعلين السياسيين، وأضحت الممارسة السياسية فرجة وحلبة صراع بين الخصوم السياسيين، وأصبح المواطن مجرد متفرج يتطلع إلى الفائز. ولكي تكون هذه الفرجة أكثر تشويقا، فإن كل الضربات بين هؤلاء المتنافسين تصبح مباحة، تقحم فيها حياتهم الشخصية، وفضائحهم الأخلاقية وماضيهم الشخصي.
وقد انتقلت عدوى هذا الابتذال إلينا، فأصبحنا نعيش على وقع الخصومات الشخصية التي لا صلة لها بحرمة تدبير الشأن العام . من هنا تأتي راهنية هذا المقال وفائدته بالنسبة إلى مجتمعنا، لأنه مقال يعالج ظاهرة سلبية تزداد استفحالا، لكنه يعالجها من منظور معرفي، ومن زاوية تحليل سوسيولوجي هادئ ينأى بنفسه عن السجال السياسي العابر. ( المترجم)
نص إدغار موران
إن للثقافة الجماهيرية، شأن كل الثقافات، آلهتها وأبطالها الذين سنسميهم الأولمبيين. يصلح هؤلاء الأولمبيون كنماذج من جهة، ويمكنهم، من جهة أخرى، أن يشكلوا l موضوعا للإسقاط (تنعكس عليه) الأحلام والتطلعات الجماهيرية.
إننا نشهد، منذ ثلاثين سنة، ظاهرة هامة تتمثل في تطور عالم الأولمبيين هذا، وفي مقدمتهم نجد طبعا نجوم السينما. يرتكز هذا العالم على شخصيات مزدوجة الجوهر والمادة. من جهة أولى ، يتوفر الأولمبيون على خصال مجدتها السينما: الجمال، الحضور، الخ؛ كما يتوفرون على حياة خارقة حافلة بالمهرجانات والغراميات العديدة والمكثفة. وهي تجارب لا يتاح مثلها للعامة. ومن جهة أخرى، فإن هؤلاء النجوم يعرضون علينا، في أغلب الأحيان وبشكل متزايد، أثناء حياتهم اليومية؛ يعرضون علينا في بيوتهم، يتعرضون للاغتياب، وتنشر تفاصيل حياتهم الخاصة. قبل الثلاثينات، كان من الصعب أن نتصور أن نجما سينمائيا يمكن أن ينجب طفلا، لأن هذا الفعل يعني تورطا مشينا في عالم مادي بيولوجي غريب عن جوهر النجم السينمائي آنذاك، على الأقل من الزاوية الأسطورية التي صنعت له. أما في الوقت الراهن، فإن إنجاب طفل لم يعد فقط أمرا ممكنا، بل صار حدثا يستقبل بحماس جماعي يشبه الهذيان، كما حدث مع طفل جينا لولوبريجيدا Gina Lollobrigida أو طفل بريجيت باردوBrigitte Bardot .
"السخرة" والحقوق المهضومة.... ـ المصطفى بلمرابط
 "السخرة" هو نظام يتم بواسطته استعباد الإنسان واذلاله... وانتزاع حقوقه المعيشية في الحياة الطبيعية...، ومن هذا المنطلق، لابد أن نتطرق لتعاريفه المعجمية... وآثره التاريخي ...والمطالبة الأممية بتجريمه قانونيا وحقوقيا...
"السخرة" هو نظام يتم بواسطته استعباد الإنسان واذلاله... وانتزاع حقوقه المعيشية في الحياة الطبيعية...، ومن هذا المنطلق، لابد أن نتطرق لتعاريفه المعجمية... وآثره التاريخي ...والمطالبة الأممية بتجريمه قانونيا وحقوقيا...
1\ تعريف نظام السخرة:
أ\ لغويا: حسب تعريفات المعاجم العربية الحديثة أن السخرة: خدمة اجبارية بغير أجر معلوم.
ـ رجال السخرة: العبيد والأرقاء ـ نظام السخرة التأجيري: نظام يتم من خلاله تسخير مدين من قبل مقرضه...حتى يتم دفع الدين ...
ب\ اصطلاحا وتداولا: نظام السخرة هو طريقة إجبار الأفراد أو الجماعات... على أداء أعمال أو خدمات... في ظروف صعبة قاسية لاإنسانية... بدون رغبة أو إرادة ذاتية... مقابل أجر مادي غير معلوم وغير متفاوض عليه... على المجهود القسري ...وغالبا ما يكون بالإطعام ...طعاما رديئا، أو بالكساء ...كساء لا يستر العورة أحيانا...
2\ نظام السخرة وآثره التاريخي: ظهر نظام السخرة في فرنسا أيام الملكية، حيث إن الملك لويس السادس عشر كان يأمر الفلاحين والمزارعين بإسكات "نقيق الضفادع" في نهر السين حيث يقع قصره... لكي يستطيع أن ينام...ويقال كذلك أن العمال المصريين عملوا بنظام السخرة في حفر قناة السويس... وكما استغل النازيون العمل بالسخرة , من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية بعد هزيمتهم في معركة "ستالين جراد" في 1942ـ1943 , ومما أدى الى نقص العمالة في اقتصاديات الحرب الألمانية واستغلال السجناء كعمال بالسخرة في المصانع الألمانية وتأسيس مئات المحتشدات بالقرب من المؤسسات الصناعية ...كمحتشدات أشفيتز في ببولندا...ومحتشدات بوخينفالد في وسط ألمانيا...الخ , حيث زجوا بكل السجناء الدين تتراوح أعمارهم بين 14سنة و 60 سنة ـ اجباريا، للعمل بالسخرة ومدة العمل تتراوح ما بين 10 الى 12 ساعة يوميا في ظروف قاسية مزرية ...مقابل ما يقتاتون به...
الأفكار السياسية لأبي القاسم الزياني من خلال كتاب الترجمانة ـ المولودي نور الزين
 عرف المغرب ظروفا موضوعية، جعلت عدة أسئلة منذ القرن الثامن عشر(18) تطرح نفسها بحدة، من بينها التساؤل حول أهمية هذه المرحلة بالنسبة للعالم العربي عامة والمغرب خاصة: فهل بالفعل شكل الاندحار المغربي على جميع الواجهات نقطة تحول أفادت أن الاندحار ليس انحدار مجتمع عسكريا فقط أمام الأوربيين، بل إنه انحطاط حضاري شامل؟
عرف المغرب ظروفا موضوعية، جعلت عدة أسئلة منذ القرن الثامن عشر(18) تطرح نفسها بحدة، من بينها التساؤل حول أهمية هذه المرحلة بالنسبة للعالم العربي عامة والمغرب خاصة: فهل بالفعل شكل الاندحار المغربي على جميع الواجهات نقطة تحول أفادت أن الاندحار ليس انحدار مجتمع عسكريا فقط أمام الأوربيين، بل إنه انحطاط حضاري شامل؟
لقد شكل هذا المعطي علامة هامة ليس داخل المجتمعات فحسب، بل حتى على الصعيد الفكري، سواء بالمغرب أو المشرق وإن كان لكل جانب خصوصياته وتاريخه الخاص. ذلك أن مصر وتونس والجزائر عرفت احتكاكا مبكرا ومباشرا مع المستعمر، أما المغرب فقد احتفظ حتى نهاية القرن 18 وبداية القرن 19 بمهابته التي خلقتها له معركة وادي المخازن، رغم ذلك فالعقال أصبح يضيق حوله بفعل الضغوط القوية مع نهاية القرن 19. من جهة ثانية فالمعطي صورة أخرى أفرزتها الوضعية العامة، فكانت مختفية وراء المقابلة بين طرفين متناقضين متنافرين بين عالم عربي إسلامي "دار الإسلام" لا حول ولا قوة له، أمام عالم أوربي متقدم يتباهى بكل مظاهر القوة والازدهار. في حقيقة الأمر كان الهدف هو محاولة استكشاف نتائج هذا التواصل المختلف الأوجه فشكل رد الفعل الهاجس الأكبر لهذه الأدبيات التي أرخت لهذه الفترة، لكن مع توالي الهزائم، جعل الوعي أكبر بمشاكل المجتمع المغربي، فكان أكيدا أن تتبلور نظرات تؤكد على تطور الآخر وتميزه بالمبادرة والقوة والاعتراف بأن الهزيمة هي حضارية قبل أن تكون عسكرية.
فأين يكمن رد الفعل ضد الآخر الذي اعتبر "كافرا" أكثر مما هو متحضر وقوي؟
في الحقيقة لقد تباينت الردود الصادرة عن عدة وجوه مختلفة تراوحت بين ضرورة الدفاع عن الدين وأرض الإسلام وهو اتجاه لم يع أكثر بواقعه، وآخر أقر بضرورة الاعتراف بالواقع ونهج طريق "المهادنة" و"حرب الضعفاء"، في حين هناك من لم يصدر عنه أي تعليق وهذا الاتجاه اندهش لأمره وبقي في حيرة لما وقع للمغرب فاستجد بالتصوف.
الديمقراطية الإسلامية ـ محمد شودان
 قد نشأت الديمقراطية كنظام للحكم في تربة المجتمع اليوناني، ومعلوم أنه قد سبقها مخاض اجتماعي وسياسي عسير، أعقب قرونا طويلة من الحكم المستبد الذي كان يستمد فيه الحاكم شرعيته من العصبية أو الدين، ومعلوم أيضا أن الديمقراطية تعني حرفيا حكم الشعب، بحيث تقابل لفظة ديموس معنى الأحرار من أفراد الشعب، وكراتوس تعني الحكم، وذلك بانتخابهم ممثلين لهم. وقد تطورت مدلولات اللفظة مع مرور الزمن وتعاقب العصور، ففي عهد الإمبراطورية الرومانية مثلا كان الشعب ينتخب أعضاء مجلس الشيوخ وقد كانت لهذه الهيئة ــ في فترات عدة ــ صلاحيات كبرى قد تقيض حكم الإمبراطور وتقلص من نفوذه.
قد نشأت الديمقراطية كنظام للحكم في تربة المجتمع اليوناني، ومعلوم أنه قد سبقها مخاض اجتماعي وسياسي عسير، أعقب قرونا طويلة من الحكم المستبد الذي كان يستمد فيه الحاكم شرعيته من العصبية أو الدين، ومعلوم أيضا أن الديمقراطية تعني حرفيا حكم الشعب، بحيث تقابل لفظة ديموس معنى الأحرار من أفراد الشعب، وكراتوس تعني الحكم، وذلك بانتخابهم ممثلين لهم. وقد تطورت مدلولات اللفظة مع مرور الزمن وتعاقب العصور، ففي عهد الإمبراطورية الرومانية مثلا كان الشعب ينتخب أعضاء مجلس الشيوخ وقد كانت لهذه الهيئة ــ في فترات عدة ــ صلاحيات كبرى قد تقيض حكم الإمبراطور وتقلص من نفوذه.
ولفهم الديمقراطية الغربية في شكلها الحديث يجب العودة إلى عصر التنوير وأفكار النزعة الإنسانية، ولاسيما الاطلاع على كتاب العقد الاجتماعي وغيره من المؤلفات التي ناقشت الدولة وأشكال الحكم، ثم المرور بالفكر الماركسي وتنظيره للديمقراطية في صيغتها الاشتراكية، ويمكن الوقوف أيضا عند النزعات العنصرية والشمولية التي سبقت الحرب العالمية الثانية. كل هذا الحراك الفكري والسياسي الذي امتد لقرون جعل من الديمقراطية وسيلة للتدبير التشاركي ولا يمكن فهم الديمقراطية خارج إطار الدولة، فالدولة في الغرب لا تتجاوز كونها هيئات ومؤسسات في خدمة المواطن، والمواطن بوعيه يساهم في تقوية هذه المؤسسات، وهذا مما لا يختلف فيه النظام الملكي عن الجمهوري. إن هذه العلاقة التي تربط دولة المؤسسات بمواطنيها هي التي أفرزت مدلولات الديمقراطية الغربية الحديثة، فالديمقراطية لا تتوقف عند صناديق القتراع بل تتجاوزه إلى إشراك المواطن والحرص على تمثيلية فاعلة للأقليات الدينية والعرقية والفكرية.
الديمقراطية: عود على بدء ـ أحمد العكيدي
 تعتبر الديمقراطية من أفضل ما أبدعه العقل الإنساني في مجال الحكم وتدبير الاختلاف. وتم اقرار هذا النمط من الحكم في مجموعة كبيرة من دول العالم رغم اختلاف أنظمتها السياسية: برلمانية، رئاسية، شبه رئاسية، ملكية برلمانية بل حتى الأنظمة الديكتاتورية والشمولية...
تعتبر الديمقراطية من أفضل ما أبدعه العقل الإنساني في مجال الحكم وتدبير الاختلاف. وتم اقرار هذا النمط من الحكم في مجموعة كبيرة من دول العالم رغم اختلاف أنظمتها السياسية: برلمانية، رئاسية، شبه رئاسية، ملكية برلمانية بل حتى الأنظمة الديكتاتورية والشمولية...
كما أنها ساهمت في استقرار وازدهار دول كثيرة خاصة دول أوروبا التي كانت تعاني من ويلات الحروب والاستبداد على مر تاريخها.
بيد أن هذا الإرث الإنساني لم يسلم من مظاهر الشيخوخة التي تفرض عليه تجاوزها من خلال تشبيب ذاته إن هو أراد تجاوز دورة ابن خلدون القاتلة ولو إلى حين. تتجلى هذه المظاهر بالخصوص في الأزمة التي باتت تعاني منها جل الأنظمة السياسية العالمية من خلال تركيز جزء كبير من السلطة الفعلية في يد مجموعات أو أفراد لا تفرزهم بالضرورة صناديق الاقتراع (مجموعات الضغط، الاعلام، أفراد لهم نفود، مراكز التفكير...)، وهذا ما يؤثر أحيانا كثيرة على استقلالية المنتخبين وانحيازهم ضد إرادة الشعوب حتى في الدول المتقدمة ولعل في ولاية الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" خير مثال حيت لم يستطيع طوال ولايتين رئاسيتين تنفيد وعده بإغلاق معتقل كونتانامو والأمثلة كثيرة لا يصعب ايجادها.
نحاول من خلال هذا المقال المقتضب التذكير بأبرز محطات تطور الديمقراطية عبر التاريخ ابتداءً من شكلها اليوناني مرورا بالديمقراطية التمثيلية والعودة إلى منبعا لتنهل منه لعلها تتجاوز بعض مظاهر أزمتها.
غياب الفرد في الثقافة العربية: المفارقة المسكوت عنها لمطلب الديمقراطية في العالم العربي ـ محمد عادل مطيمط
 1- طرح المشكل: (مفارقة المشهد السياسي العربي المعاصر)
1- طرح المشكل: (مفارقة المشهد السياسي العربي المعاصر)
من البديهي أن يكون الشرط الأوّلي للديمقراطية هو احترام حرّية الفرد Individu . ولكن السؤال الأول الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو السؤال حول ماهية هذا الفرد وحول نطاق تلك الحرية الفردية الذي ترتكز عليه الديمقراطية. ولنتفق على أن ذلك السؤال هو سؤال مركزي في الفكر السياسي ونظريات الدولة قديما وحديثا.
بيد أن المقصود بالحرية الفردية واضح هنا، وهو محلّ اتفاق واسع:
فلا يقصد في هذا السياق بالحرية الفردية حريّة طبيعية Liberté naturelle أو حيوانية لا حدود لها سوى الطبيعة (ما توجبه قوانين الطبيعة: الغريزة، الفطرة)، بل المقصود حرية مدنية Liberté civile يحدّها الحساب والعقل ويقودها القانون المدني في الإطار العام للمصالح المشتركة بين الأفراد. لقد تبيّن ذلك منذ فلسفة العقد الاجتماعي (هوبزHobbes ، سبينوزا Spinoza، رسّو Rousseau ...) في القرن السابع عشر من خلال نظريات أصبحت اليوم مرجعيّة رغم النقد والمراجعات التي تمّت: فالانتقال من حالة الطبيعة الافتراضيةétat de nature إلى الحالة المدنية أو السياسيةétat politique في فلسفات العقد الاجتماعي (Philosophies du contrat social)لا ينفي فردية الفرد بل يهذّبها ويجعل لها أُطرا مقننة لتصبح منسجمة مع الوجود المشترك. ولذلك فان الفرد الذي نتحدث عنه هنا بمناسبة التطرّق إلى الديمقراطية ليس الفرد الأناني أنانية مطلقة، بمعنى ذلك الكائن الذي لا ينظر إلى مصلحته الخاصة إلاّ من المنظور الضيق لتلك المصلحة الخاصة، بل هو الفرد الذي ينظر إلى مصلحته في ارتباطها العضوي بالمصلحة العامة. فلا تتحدد الفردية من منظور سياسي وأخلاقي باعتبارها ضربا من العزلة أو الانفراد المطلق الذي يفضي إلى تذْريرAtomisation المجتمع، ولكن باعتبارها جزءا من المنظومة العامة للمصلحة المشتركة. ذلك هو ما يرشح عن تعريف "رسّو" الشهير للحرية المدنية في العقد الاجتماعي (1762) Du Contrat socialعندما بيّن أن ما يخسره الفرد بسبب العقد الاجتماعي هو الحرية الطبيعية وحق مطلق في كل ما يستطيع أن يحققه، في حين أن ما يغنمه هو الحرّية المدنية وملكيته لكل ما يكتسبه. ولذلك يجب التمييز بين الحرية الطبيعية التي لا حدود لها سوى قوّة الفرد والحرية المدنية التي تحددها الإرادة العامة.
رؤية فلسفية: الثقافة لا تنشأ بقرارات فوقية ـ نبيل عودة
 لم نعد نسمع شيئا عن تيار الثقافة والفن الذي عرف باسم "الواقعية الاشتراكية"، جدير بالذكر ان هذا التيار احتل الواجهة الثقافية الاعلامية للتيارات الماركسية بعد ثورة اكتوبر وقيام الاتحاد السوفييتي، الاصطلاح نفسه صاغه الأديب الروسي – السوفييتي مكسيم غوركي صاحب رواية "الأم" الرائعة، التي اعتبرت بداية أدب الواقعية الاشتراكية.
لم نعد نسمع شيئا عن تيار الثقافة والفن الذي عرف باسم "الواقعية الاشتراكية"، جدير بالذكر ان هذا التيار احتل الواجهة الثقافية الاعلامية للتيارات الماركسية بعد ثورة اكتوبر وقيام الاتحاد السوفييتي، الاصطلاح نفسه صاغه الأديب الروسي – السوفييتي مكسيم غوركي صاحب رواية "الأم" الرائعة، التي اعتبرت بداية أدب الواقعية الاشتراكية.
خلال عقود وجود الاتحاد السوفييتي أصبحت الواقعية الاشتراكية معيارا ل "ألأدب الجيد" و"الأديب المناضل الثوري التحرري" في مواجهة التيارات الأدبية "البرجوازية والامبريالية المعادية للإنسان" حسب الصيغة التي روجها النظام السوفييتي واتباعه، لدرجة ان المدارس الأدبية التي برزت في الثقافة الانسانية مثل المذهب التاريخي، المذهب الاجتماعي، المذهب الجمالي، المذهب الكلاسيكي، المذهب الرومانسي، المذهب الواقعي (اطلق عليه ايضا اسم الواقعية البرجوازية)، المذهب الرمزي، المذهب الوجودي، المذهب العبثي وغيرها من التيارات الجديدة مثل تيار الحداثة وما بعد الحداثة... اختصرت كلها تحت صيغة "ثقافة برجوازية" مهمتها فقط تبرير النظام الرأسمالي الاستغلالي.. الخ، بتجاهل كامل لأعمال ابداعية انسانية وفكرية غير مهادنة وداعمة لحقوق الانسان، وحق الشعوب المستعمرة بالتحرر من نير الاستعمار!!










