 ما بين بطاقتي الانتخابية الأولى وبطاقتي الانتخابية الأخيرة
ما بين بطاقتي الانتخابية الأولى وبطاقتي الانتخابية الأخيرة
ذاكرة البطاقة الانتخابية الأولى:
ذكرت لي والدتي تغمدها الله بواسع رحمته وأدخلها فسيح جنانه أنها لما أرادت الحصول، كأي مواطن ومواطنة، على بطاقة التعريف الوطنية في عقد السبعينيات من القرن الماضي؛ طلب منها عون السلطة المحلية الحالة المدنية لكنها لم تكن تتوفر على هده الوثيقة الإدارية فمدت عوضا عنها "laisser-passer" أو جواز المرور بين الأقاليم المغربية الخاضعة لسلطة المحتل الإسباني شمالا والأقاليم المغربية الخاضعة لسلطة المعمر الفرنسي جنوبا. لكن عون السلطة انتبه إلى أن جواز المرور عمره أكثر من عشرين عاما فسألها إن كانت تتوفر على وثيقة إدارية أخرى بديلة، "بطاقة الناخب" مثلا. ولأن والدتي، رغم عدم توفرها على أية وثيقة إدارية، شاركت في أول انتخابات مغربية تلت حالة الاستثناء التي عاشها المغرب ما بين 1965-1975، فقد حلت المشكلة الإدارية لدى مكتب عون السلطة المحلية بحصول والدتي على الحالة المدنية والبطاقة الوطنية معا. لكن حل المشكل الإداري كان نواة نمو مشكل جديد من نوع خاص جدا. فقد ارتبطت الحادثة في ذاكرة والدتي بأن "بطاقة الناخب" مصباح سحري يفك العقد مهما تعقدت وأن الانتخابات "واجب" نبرهن من خلاله على "طيبوبتنا وطاعتنا" في انتظار قضاء حاجاتنا الإدارية وغير الإدارية...
ولأن والدتي رحمها الله كانت ترى الانتخابات المغربية بهذا الشكل، فقد حدث لنا، نحن الاثنين، أول احتكاك بسبب المشاركة في الانتخابات في بداية التسعينيات من القرن الماضي حين حصلت على أول "بطاقة ناخب" في حياتي. فقد قررت مقاطعة انتخابات 1993ورفضت الذهاب إلى صندوق الاقتراع احتجاجا على انتهازية الأحزاب التي كانت تصف نفسها حتى ذلك الحين ب "الأحزاب الجماهيرية" وتنعث غيرها ب "الأحزاب الإدارية"، تلك "الأحزاب الجماهيرية" التي قاطعت الاستفتاء على دستور 1992 وقبلت بدخول، أمام إغراءات المواقع والمناصب وأعداد الكراسي، الانتخابات تحت ظلة ذات الدستور الذي قاطعته...
ولأنني صممت على مقاطعة الانتخابات، فقد تأججت نار الاختلاف بيني وبين والدتي التي، "بحكم تجربتها"، تنبأت لي بالإقصاء الإداري والحرمان من قضاء مصالحي الإدارية... وكعاطفة أي أم، توسلت بكل وسائلها أن أذهب لمركز التصويت ما دام الأمر لا يتعلق سوى بظرف مجاني ينتظرني لوضعه في شقة صندوق الاقتراع أمام أعين ممثلي السلطة ونواب المرشحين.
ولأن الأمر صار غير محتمل، فقد خرجت من البيت لتخفيف الضغط علي فلم أعد إلا في ساعة متأخرة من الليل بعدما سمعت النتائج الكاملة من المقرات الحزبية بالمدينة. لكن، عكس كل التوقعات، وجدت والدتي في معنويات عالية وهي تعلن في انتصار بأنها صوتت في مكاني:
- "الأمُور مْشَتْ كَمَا يَنْبَغي. رَانَا صَوّت لَك!"
الدولة والسلطة - هنري لوفيفر- ترجمة : حسن أحجيج
 أثار وجود الدولة والسلطات السياسية، الذي يتميز بالوضوح والغموض في آن واحد، عديدا من التساؤلات التي أصبحت تشكل مركز التفكير والمعرفة في العالم الحديث. إن هناك طلبا عاما بهذا الصدد؛ إذ لا يمكن لأية فلسفة ولأي تفكير نظري حول المجتمع والواقع البشري أن يتجنب هذه التساؤلات. فحياة كل فرد منا ترتبط بـهذا المجهول الذي عُـرِف بما فيه الكفاية والذي مازال يجهله الكثيرون أيضا ؛ وكذا يشعر كل فرد منا بأن هذا المجهول يعنيه مباشرة؛ أضف إلى ذلك أن مزيجا من الفضول والقلق يحيط بـهذه التساؤلات. كيف يمكن للمرء ألا يتساءل اليوم عن السبل والوسائل التي انتهجها كل من هتلر وستالين للتوصل إلى الهيمنـة على شعوب كبيرة ولإقحام عصرهما في هذا المسار الأكثر دموية في التـاريخ البشري ؟ ويصدر التساؤل عن شروط المعرفة أيضا : ألم تصبح المعرفة منذئذ مرتبطة عضويا أو مؤسسيا بالسلطة السياسية ؟ أيمكن للمرء أن يلغي هذا الرابط الذي لا يختلف اثنان في سمته الواقعية، أيمكنه أن يخترق هامشا من الحرية أو يحافظ عليه ؟ هل يمكن للمعرفة أن تصبح مستقلة بذاتـها، أن ترتد عن السلطات وأن تدرسها دراسة نقدية ؟ فإذا كان الجواب بالإيجاب، ما هي أهمية هذه المعرفة وما هي فعاليتها ؟ إن التساؤلات تتضاعف وتنصب على الأسئلة نفسها، على المعنى الذي تحمله والـهدف الذي تصبو إليه.
أثار وجود الدولة والسلطات السياسية، الذي يتميز بالوضوح والغموض في آن واحد، عديدا من التساؤلات التي أصبحت تشكل مركز التفكير والمعرفة في العالم الحديث. إن هناك طلبا عاما بهذا الصدد؛ إذ لا يمكن لأية فلسفة ولأي تفكير نظري حول المجتمع والواقع البشري أن يتجنب هذه التساؤلات. فحياة كل فرد منا ترتبط بـهذا المجهول الذي عُـرِف بما فيه الكفاية والذي مازال يجهله الكثيرون أيضا ؛ وكذا يشعر كل فرد منا بأن هذا المجهول يعنيه مباشرة؛ أضف إلى ذلك أن مزيجا من الفضول والقلق يحيط بـهذه التساؤلات. كيف يمكن للمرء ألا يتساءل اليوم عن السبل والوسائل التي انتهجها كل من هتلر وستالين للتوصل إلى الهيمنـة على شعوب كبيرة ولإقحام عصرهما في هذا المسار الأكثر دموية في التـاريخ البشري ؟ ويصدر التساؤل عن شروط المعرفة أيضا : ألم تصبح المعرفة منذئذ مرتبطة عضويا أو مؤسسيا بالسلطة السياسية ؟ أيمكن للمرء أن يلغي هذا الرابط الذي لا يختلف اثنان في سمته الواقعية، أيمكنه أن يخترق هامشا من الحرية أو يحافظ عليه ؟ هل يمكن للمعرفة أن تصبح مستقلة بذاتـها، أن ترتد عن السلطات وأن تدرسها دراسة نقدية ؟ فإذا كان الجواب بالإيجاب، ما هي أهمية هذه المعرفة وما هي فعاليتها ؟ إن التساؤلات تتضاعف وتنصب على الأسئلة نفسها، على المعنى الذي تحمله والـهدف الذي تصبو إليه.
إن الفلسفات والبحوث العلمية التي تتجنب هذه الأسئلة المسماة "سياسية" تظل محط ريبة. إذ أنـها لا تجيب على مشاكل عصرنا الذي يتميز بتزايد قوة الدولة وتصاعد العنف وبارتباط الدولة بالمعرفي والاقتصادي واليومي والإعلامي…
لا تجرى هذه البحوث في هذا الميدان بدون التعرض لبعض المخاطر ؛ فهذه البؤرة المركزية في الحياة الاجتماعية وفي الفكر تحتوي بالفعل علـى مناطق معتمة وعمياء؛ وتلتقي فيها كل من المعرفة و اللا معرفة، النفوذ الصارخ والسرية. تتموضع هذه البؤرة المركزية خارج مقولات الفلسفة التقليدية ومفاهيمها (كالذات والموضوع أو الجوهر والعلاقة، مثلا)، مع أن هذه المفاهيم تظل ضرورية لصياغة التساؤلات. فالفلسفة بمعناها التقليدي تمر بمحاذاة هذه البؤرة، على الرغم من أن هيغل Hegel أولا، ثم نيتشه Nietzsche ، مرورا بماركس طرحوا مجموعة من الأسئلة القوية والواضحة حول هذه البؤرة وبينوا مظاهرها المتعددة التي مازال البعض منها مقبولا إلى اليوم وتم تجاوز بعضها الآخر.
1 ـ أساطير السلطة :
إن كل سلطة سياسية، مرتبطة بـهذا الشكل التاريخي من الدولة أو ذاك، قد ولدت مجموعة من التمثلات بكل ما تحمله الكلمة من معنى : احتفالات، أعياد، إخراج ومسرحية، صور، أفكار وإيديولوجيا، تصـورات للعالم وللمجتمع، إلخ. لقد كان البعض من هذه التمثلات يستعمل استعمالا شعبيا من أجل الإبقاء على المسودين تحت الهيمنة؛ وكان بعضها يستعمل استعمالا أكثر ضيقا: إذ أنه كان مخصصا للمهيمنين، يمجدهم باعتبارهم مرتبطين بالسلطة وأدواتها. وأخيرا، لم يكن يستعمل الجزء المتبقي منها إلا بشكل داخلي خاص بالأسياد، باعتباره إجراءات ضرورية للحفاظ على وعيهم بالسيادة وتمريره إلى خلفهم.
أثر أبي الأعلى المودودي على الجماعات الدينية المعاصرة - د. حسن حنفي

مقدمة:
بالرغم من وجود أسباب اجتماعية وسياسية واقتصادية لظهور الجماعات الدينية المعاصرة خاصة تلك التي تحاول أن تحقق أهدافها بالقوة الا ان الأسباب الفكرية أو الاسس العقائدية لا تقل أهمية عن الأسباب الاولى لأنها هي التي تعطي الاسس النظرية للسلوك، وبالتالي تكون هي المحرك الاول لهذه الجماعات والدافع لها على الحركة والنشاط والتي تمدها بقيمها وأهدافها ووسائل تحقيقها وتنفيذها.
ومفكر الدولة الاسلامية الاول هو الامام أبو الاعلى المودودي الذي أنشأ حركته "الجماعة الاسلامية" بعد الاخوان المسلمين في مصر بثلاثة عشر عام تقريباً.
ويتسم الفكر الديني عند المودودي بطابع خاص تجعله ذا بناء محدد، يظهر في سلوك هذه الجماعات الدينية المعاصرة. ويمكن وصف هذا البناء على النحو الآتي:
1_ الحاكمية لله:
تعطى الحاكمية لله تصورا مركزيا للعالم. فالله قمة الكون خلقه ويحكمه ويسيطر عليه فالانبياء هم المعلنون عن هذه الحاكمية، ومعهم القادرون على السير على هداهم. وتنبع السيطرة على الكون بكل ما فيه حدا لا يستطيع معه أحد الخروج عنه، فلا تكن الا عبد الله ولا تأتمر الا بأمره ولا تسجد لاحد من دونه فانه ليس هناك من صاحب جلالة فالجلالة كلها مختصة بذاته جل وعلا، ولا شارع من دونه، فالقانون قانونه، ولا يليق التشريع الا بشأنه، ولا يستحقه الا هو، ولا ملك ولا رازق ولا ولي الا هو، وليس من دونه من يسمع دعاء الناس ويستجيب لهم، وليست مفاتيح الكبرياء والجبروت الا بيده، ولا علو لاحد ولا سمو في هذه الدنيا فكل من في السماوات والارض عباد أمثالك والرب هو الله وحده. فارفض كل أنواع العبودية والطاعة والخضوع لاحد من دونه، وكن عبد الله، قانتا مستسلماً لاوامره".
ولما كانت الحاكمية لله فالاستخلاف لا يكون الا في الحاكمية.
وقد قرر جميع الأنبياء هذه الحاكمية وهذا الاستخلاف مؤكدين حقائق ثلاث: الأولى أن السلطة العليا التي على الإنسان أن يخضع لها وبطبعها ويقر بعبوديته لها والتي يتأسس على طاعتها النظام الكامل للأخلاق والمجتمع والحضارة هي سلطة الله وحده وينبغي التسليم بها وقبولها على هذا الاساس. والثانية حتمية طاعة النبي وحكمه بوصفه ممثلا ونائبا عن السلطان الاعلى والحاكم المطلق. والثالثة أن القانون الحكم الذي يقرر التحليل والتحريم في جميع الميادين هو قانون الله وحده الناسخ لكل القوانين البشرية وليس للعباد حق المساءلة والنقاش في أحكام الله فما حرمه الله يكون حراما وما حلله يكون حلالاً لانه مالك كل شيء ويفعل ما يشاء. وقد بين القرآن طاعة الانسان لله وللرسول ولأولي الامر. كما نص على الحاكمية في "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" .
ويصفهم القرآن مرة أخرى بالظالمين ومرة ثانية بالفاسقين. وليس صحيحا أنها آيات خاصة نزلت في أهل الكتاب في مناسبات خاصة بل هي أحكام عامة تتجاوز أسباب النزول وتنطبق على كل أمة بالنسبة لكتابها في كل زمان ومكان.
الدولة الدينية في الإسلام.. وهم أم حقيقة؟؟ - د. محمود إسماعيل
 كثر الجدل قديما وحديثا حول إشكالية الدين والدولة دون حسم أو قطع، خصوصا فى العالمين العربى والإسلامى. ويرجع ذلك فى المحل الأول - إلى أسباب سوسيو - سياسية، مفادها استمرار الخلل فى البنية الاجتماعية، الذى يرجع بدوره إلى عدم الحسم فى الأساس الاقتصادى بين أنماط الإنتاج، وما ترتب عليه من أبنية علوية عكست بدورها آفة التخليط الفكرى والثقافى، ومن ثم الاختلاف الايديولوجى.
كثر الجدل قديما وحديثا حول إشكالية الدين والدولة دون حسم أو قطع، خصوصا فى العالمين العربى والإسلامى. ويرجع ذلك فى المحل الأول - إلى أسباب سوسيو - سياسية، مفادها استمرار الخلل فى البنية الاجتماعية، الذى يرجع بدوره إلى عدم الحسم فى الأساس الاقتصادى بين أنماط الإنتاج، وما ترتب عليه من أبنية علوية عكست بدورها آفة التخليط الفكرى والثقافى، ومن ثم الاختلاف الايديولوجى.
ففى أوربا - على سبيل المثال - أفضى حسم الصراع بين البورجوازية والإقطاع إلى الفصل القاطع بين الدين والسياسة، فكان ظهور الدولة المدنية المؤسسة على قاعدة العقد الاجتماعى، فما لقيصر ليقصر وما لله لله.
أما العالم الإسلامى، فقد شهد - خلال مسيرته الطويلة تاريخيا - صراعا مائعا بين البورجوازية والإقطاع أفضى عدم حسمه إلى تخليط وتعايش بين أنماط إنتاج متناقضة وهزيلة، بما أسفر عن تكوين أنماط سياسية هشة ذات إيدلوجيات مضببة وهجينة.
بديهى - والأمر كذلك - أن يستمر الجدل حول مفهوم الدولة صاخبا وملتبسا. بديهى أيضا أن يعلو صوت الإيدولوجيا الدينية التى تروم إحياء الدولة الثيوقراطية دونما فهم أولى عقلانى عن العلاقة بين الدين والسياسة. ومن المعلوم المسلم به أن غلبة اللجاج اللاهوتى يعكس حقيقة التطور اللامتكافئ للواقع السوسيو - سياسى الذى لم يشهد - للآن - ثورة رأسمالية تنجز حركة إصلاح دينى تفصل بين الدين والدولة. ويرجع ذلك إلى عجز وشلل البورجوازية فى المجتمعات الإسلامية إلى حد حكم كلود كاهن بأنها مجتمعات بلابورجوازية أصلا.
إن فهما حقيقيا لجوهر الدين يعزله تماما عن السياسة، تستوى فى ذلك الديانات السماوية الثلاث. صحيح أن دولة إسرائيل استثمرت الدوجما اليهودية لخدمة تأسيسها. لكن العقيدة اليهودية بحق تعتبر الحركة الصهيونية منافية لها بل يرى قطاع عريض من أحبار اليهود المعاصرين أن قيام دولة إسرائيل محض كفر بالموسوية.
أما المسيحية، فلا تقيم وزنا للحياة الدنيوية برمتها، باعتبارها مؤسسة على الخطيئة يقول السيد المسيح: مملكتى ليست فى هذا العالم، ويصم القديس أوغسطين مدينة الأرض بأنها مملكة الشر. وإذا استثمرت الكنيسة فى روما وبيزنطة، اللاهوت لخدمة الناسوت، فقد كان ذلك يمثل خروجا على تعاليم المسيحية، مالبث أن جرى تصحيحه بحركة الإصلاح البروتستانتى التى كانت مظهرا من مظاهر انتصار الطبقة البورجوازية فى صراعها المرير مع الفيودالية.
الدولة الاسلامية في خطاب البنّا: مفارقات المفهوم - د.عبدالإله بلقزيز
 ليس الانتقال والتأرجح بين مربع الفكرة الدينية عن الدولة، ومربع الفكرة المدنية الحديثة عنها، خاصية وَسَمَتْ مقالة القرضاوي حصراً، من دون سائر المثقفين الإسلاميين المعاصرين، بل هي من ميراث حسن البنّا الذي أتقن ممارستها على نحوٍ من الكفاءة لم يضارِعهُ فيه أحد. والحق أن القارئ في نصوص مؤسس حركة (الإخوان المسلمين)، لا يجد صعوبة في الوقوف على مفارقة مثيرة تؤسس خطابه حول الدولة: الانفتاح الشديد والانغلاق الشديد! وهي مفارقة تذهب بخطابه إلى أبعد حدود التوتر نتيجة حركة الشد والجذب بين حدي الانفتاح والانغلاق! نعثر عل ذلك ـ بصورة بالغة الوضوح ـ في دفاعه عن الدستور والخيار التمثيلي النيابي، وفي هجومه الحاد على الحزبية والتعددية السياسية!
ليس الانتقال والتأرجح بين مربع الفكرة الدينية عن الدولة، ومربع الفكرة المدنية الحديثة عنها، خاصية وَسَمَتْ مقالة القرضاوي حصراً، من دون سائر المثقفين الإسلاميين المعاصرين، بل هي من ميراث حسن البنّا الذي أتقن ممارستها على نحوٍ من الكفاءة لم يضارِعهُ فيه أحد. والحق أن القارئ في نصوص مؤسس حركة (الإخوان المسلمين)، لا يجد صعوبة في الوقوف على مفارقة مثيرة تؤسس خطابه حول الدولة: الانفتاح الشديد والانغلاق الشديد! وهي مفارقة تذهب بخطابه إلى أبعد حدود التوتر نتيجة حركة الشد والجذب بين حدي الانفتاح والانغلاق! نعثر عل ذلك ـ بصورة بالغة الوضوح ـ في دفاعه عن الدستور والخيار التمثيلي النيابي، وفي هجومه الحاد على الحزبية والتعددية السياسية!
1ـ الدولة والدستور:
يعرف سائر الذين قرأوا نصوصه الفكرية، أو اطلعوا على مواقفه السياسية، أن حسن البنّا كان إيجابياً تجاه مسألة الدستور والخيار السياسي النيابي، وأنه دفع بحركة (الإخوان المسلمين) إلى المشاركة السياسية في الحياة العامة بعيداً عن أفكار وخيارات العنف، وخاصة قبل تأسيس (التنظيم الخاص)، الذي أصبح كتيبة صدام موازية للتنظيم الجماهيري الضخم والواسع. غير أن موقفه الإيجابي ذاك، كان في جملة ما يعتقد أنه من صميم الاسلام، أي أن الدستور والتمثيل النيابي ليسا أفكاراً برّانية عن عقيدة الاسلام وشريعته؛ بل هما من تعاليمه حتى وإن بَدا وكأن المسلمين يستقونهما من الغرب؛ ذلك أن نُظُم الاسلام ـ في ما رأى ـ هي (أكمل وأنفع ما عرف الناس من النظم حديثاً أو قديماً). حتى حينما كان يدافع عن مبدأ المواطنة ـ وهو مبدأ حديث في الفكر السياسي ـ كان يفعل ذلك من داخل مرجعيته الدينية مجادلاً من (يظن .. أن التمسك بالاسلام وجعله أساساً لنظام الحياة ينافي وجود أقليات غير مسلمة في الأمة المسلمة، وينافي الوحدة بين عناصر الأمة) مبيّنا أن (الحق غير ذلك تماماً). ومن المثير ـ هنا ـ أن البنّا لا يستعمل عبارات مثل (أهل الذمة)، في هذا السياق، ولا يحيل على تجربة (نظام الملل) العثماني في معالجة مسألة الأقليات غير المسلمة، بل ينصرف إلى بناء موقفه لصالح وحدة الوطن والمجتمع من خلال الاعتبار بجملة من الآيات القرآنية التي تشدد على أخوة المؤمنين ووحدتهم، منتهياً إلى الاستنتاج أن (هذا الاسلام الذي بني على هذا المزاج المعتدل والإنصاف البالغ لا يمكن أن يكون أتباعه سبباً في تمزيق وحدة متصلة، بل بالعكس أكسب هذه الوحدة صفة القداسة الدينية بعد أن كانت تستمد قوتها من نصّ مدني فقط).
الطاعة في الفكر السياسي الإسلامي - بشرى الشقوري
 قراءة في كتاب "سراج الملوك"
قراءة في كتاب "سراج الملوك"إن كتاب "سراج الملوك" لأبي بكر الطرطوشي[1] لا يقل أهمية وقيمة عن المؤلفات السياسية التي اشتهرت في تاريخ الفكر السياسي الإسلامي والتي توثق لمرحلة تاريخية حاسمة من مراحل تطور ذلك الفكر، ولأنها من ناحية أخرى تعكس وجها أساسيا وواضحا من أوجهه، ثم إنها تقدم أنموذجا فريدا من النماذج التي تكشف عن العلاقة الجدلية القائمة بين الوجود المجتمعي السياسي للمفكر أو الفقيه وبين التنظير السياسي لذلك الوجود.
وإذا كان الهدف من وراء هذه الكتابات هو معرفة الصلة الوطيدة بين الفكر والوجود المجتمعي الذي أفرز ذلك الفكر، فإن المنهج التبريري والدفاعي[2] الذي كتب به التاريخ الإسلامي، وعلى الأخص الجزء السياسي منه يظل، في الأغلب الأعم، عائقا حقيقيا يقف في وجه هذه المعرفة؛ إذ من الصعب الوقوف على المرامي البعيدة والدلالات المضمرة لمثل تلك الأدبيات دون استحضار للبعد التاريخي، وعلى وجه التحديد تاريخ المرحلة التي كانت تؤطر الوعي السياسي لرجل العلم، وتحدد سقف تفكيره وتنظيره.
وللوقوف على طبيعة الكتابة السياسية، وخاصة في القرنيين الرابع والخامس الهجريين، اللذين بلغ فيهما التأليف في السياسة الشرعية ذروته، ينبغي على الباحث أن يتجاوز جانب الاهتمام بتتبع الدقائق الفقهية والتفريعات الجزئية والاختلافات المذهبية، وكل ما لا يساعد على الوقوف الحقيقي على المرامي البعيدة لتلك الكتابات ولمقاصدها الخفية...إلى اعتبار مثل تلك الكتابات مشاريع سياسية ذات دلالات سياسية وأبعاد تنظيرية، وذلك انطلاقا من التفصيلات الفقهية والتشريعات القانونية العملية.
لا بد إذن، من الانتباه إلى دلالة المشروع السياسي الذي كان يتغياه الطرطوشي عند تأليفه لكتابه "سراج الملوك"، وإلى الأهداف التي كان يرمي إصابتها بذلك المشروع، وإن كان هذا العمل لا يتأتى لنا إلا بمحاولة ربط هذا الإنتاج النظري بمجموعة من العناصر الفاعلة، وبالأخص الوجود المجتمعي الذي ساهم في بلورته، والفضاء الفكري الذي كان المفكر المالكي يتقلب فيه.
كيف يمكن لنا أن نقرأ الكتاب قراءة مستنيرة تكشف لنا عن طبيعة العلاقة الكامنة بين الفكر السياسي وبين الواقع المجتمعي الذي أطر ذلك الفكر؟ وبعبارة أدق كيف كان الطرطوشي ينظر إلى الدولة السلطانية؟ وما هي طبيعة الطاعة التي نظر لها؟ وماذا عن محدداتها؟
بين الاصولية والرهان الحضاري - بنسالم حميش
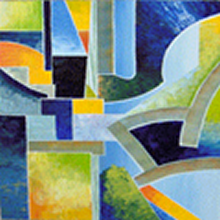 حول انتشار الحركات الأصولية في آسيا والشرق الأوسط والمغرب، تكثر القراءات التفسيرية وتتكامل أو تتنافى. ويسهم في هذه القراءات اختصاصيون، وحتى مؤلفون قليلو العلم والدراية في تاريخ الإسلام وثقافته؛ فعند عدد مهم منهم، وبينهم سياسيون، في بدء تلك الحركات كان التخلف الذي خلق دوامه المتواتر بؤر الفقر المتنامي، وبالتالي ركام الحزازات والتذمرات.
حول انتشار الحركات الأصولية في آسيا والشرق الأوسط والمغرب، تكثر القراءات التفسيرية وتتكامل أو تتنافى. ويسهم في هذه القراءات اختصاصيون، وحتى مؤلفون قليلو العلم والدراية في تاريخ الإسلام وثقافته؛ فعند عدد مهم منهم، وبينهم سياسيون، في بدء تلك الحركات كان التخلف الذي خلق دوامه المتواتر بؤر الفقر المتنامي، وبالتالي ركام الحزازات والتذمرات.«إن البؤس واعظ سيئ»، كما قال فرانسوا ميتران عن المأساة الجزائرية، وهو الميسر لعودة العامل الديني القوية.. إن هذا العامل، في حالة الإسلام، لما يزل صالحا لشرائح المعوزين والمتروكين مصفاةً وصوتا للجهر بضيقهم والتعبير عن حاجياتهم ومطالبهم. وبعد تعيين مكمن الداء، سيتمثل الدواء في تزويد الحكم القائم بما يحتاجه من دعم اقتصادي ومالي لمغالبة المد الأصولي وتحجيمه. وهذا الاختيار، رغم بعض الصعوبات الظرفية، هو الذي ما زالت السلطات الفرنسية تراهن عليه في سياستها العربية، كما هو دأبها مع الجزائر وكذلك في لبنان حتى أثناء حرب اسرائيل عليه ومقاومة حزب الله لها.
تجاوزا للمنظور الاقتصادوي الضيق، هناك صنف آخر من التفسير يقدم ظاهرة الحركات الأصولية على أنها وليدة تلاشي العقيدة الشيوعية والأيديولوجيا المادية، كما دلل عليها بقوة سقوط جدار برلين وتصدع الاتحاد السوفياتي في أواخر القرن الماضي. غير أن مقاربة هنتنغتون، على علاتها، تمثل من وجهة نظرية بعض الفائدة من حيث إنها تبرز البعد الثقافي في الحركات الأصولية مشخصا على وجه التحديد في المطالبة الهويتية ومقاومة الأنموذج الحضاري الغربي الضاغط، وهما العنصران اللذان يأخذهما الباحث بعين الجد في بحثه، ويسعى إلى تشريحهما والاحاطة بهما علما حتى يتسنى له عرض أنجع السبل لاحتوائهما وتحييدهما. وهذا التوجه نفسه هو ما نجده مضمرا عند باحثين أوروبيين، وفرنسيين بالتخصيص، يمكن أن نذكر منهم الخبير جيل كيبل، الذي يفصح عن تصوره قائلا: «إن فرضيتي العملية هي أن خطاب تلك الحركات وممارستها تحملان معنى ودلالة ليسا نتاج اختلال للعقل أو تسخير لقوى مظلمة، بل الشهادة التي لا تعوض على أزمة عميقة لم تعد مقولاتنا الفكرية التقليدية تسمح بحل شفرتها». («ثأر الله»، باريس، 1991، ص26).
في جذور العطالة السياسية في المجتمعات العربية - د. برهان غليون
 هناك استحقاقات تاريخية تفرض نفسها على البشر والمجتمعات. ومهما حاول المرء تجاهلها لابد أن تعود مرارا وتكرارا لتذكر بنفسها. ولا يمكن أن يؤدي تجاهلها إلا إلى المزيد من إلحاحها وتفاقم سوء العواقب التي يصعب في ما بعد التحكم بها أو مواجهتها.
هناك استحقاقات تاريخية تفرض نفسها على البشر والمجتمعات. ومهما حاول المرء تجاهلها لابد أن تعود مرارا وتكرارا لتذكر بنفسها. ولا يمكن أن يؤدي تجاهلها إلا إلى المزيد من إلحاحها وتفاقم سوء العواقب التي يصعب في ما بعد التحكم بها أو مواجهتها.والواقع أن النظم العقائدية التي كانت تعتمد على الحزب الواحد، وعلى التعبئة الحماسية، الحقيقية والمصطنعة معا، تفقد كل مقومات وجودها ومؤهلاتها الإنسانية منذ اللحظة التي تتفتت فيها عقيدتها أو تذبل وتموت. فهي تتحول عندئذ إلى نظم تسلطية من دون أي غلالة سحرية. ويتخذ الحكم فيها أكثر فأكثر طابع السطو المسلح على حياة الناس وأرزاقهم ومصائرهم. وكانت عقيدة النظام الشمولي الفعلية، في كل مكان وبصرف النظر عن اختلاف الثقافات والأديان، وجود الرئيس -الرب نفسه وتجليه في الحياة العمومية والخصوصية. فلم يكن هو مؤسس النظام ومحركه فحسب ولكنه كان روحه وإلهامه في الوقت ذاته. وفي جميع هذه النظم، العربية وغير العربية، كانت وفاة الزعيم الرب بمثابة خروج الروح من الجسد.
وليس المقصود بالنظام السلطة القائمة أو القائمين عليها، ولا تلك الذئاب الكاسرة التي تغرس أنيابها وكانت تغرسها من قبل في قلب الحي لتنتزع منه الحياة وتستملكها، ولكن جميع أولئك الذين كيفوا أنفسهم مع الموت وأتقنوا تجارته. وهم غالبية كبرى من الناس الذين قطعوا الأمل بحياة مدنية طبيعية وقبلوا، كلاً حسب ظروفه وإمكانياته، بالعمل والحياة خارج أي أطر قانونية وتأقلموا مع مبدأ اقتناص الفرص والمكاسب الخاصة والاستثنائية والاكتفاء بما يتوفر لهم من المصالح والمنافع الصغيرة اليومية.
فالفرد الذي لا يتردد في استخدام الرشوة أو التملق والانتهازية في سبيل الحصول على منافع وامتيازات خاصة وتجنب المنافسة الطبيعية، مثله مثل غيره كثيرين ممن يعتقدون، بطريقة أو بأخرى، أنهم مستفيدون استفادة غير قانونية وليس عليهم أن يغامروا بشيء من أجل تعديل النظام، بل إن تعديل النظام يقلل من مكاسبهم المكرسة المعنوية أو المادية. وكلهم يشكلون قوة عطالة حقيقية تسمح للنظام الجثة بأن يستمر بالرغم من الرائحة الكريهة التي تزكم الأنوف. فكل واحد من هؤلاء يجعل من منفعته الخاصة الاستثنائية كمامته الحقيقية التي تمنعه من شم رائحة الجثة المتعفنة وتمكنه من التعايش معها.










