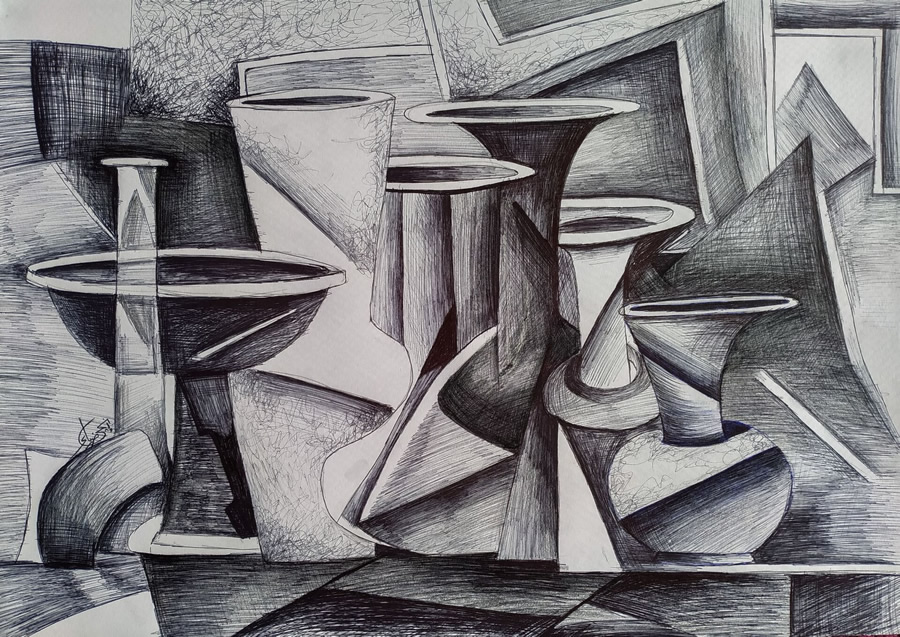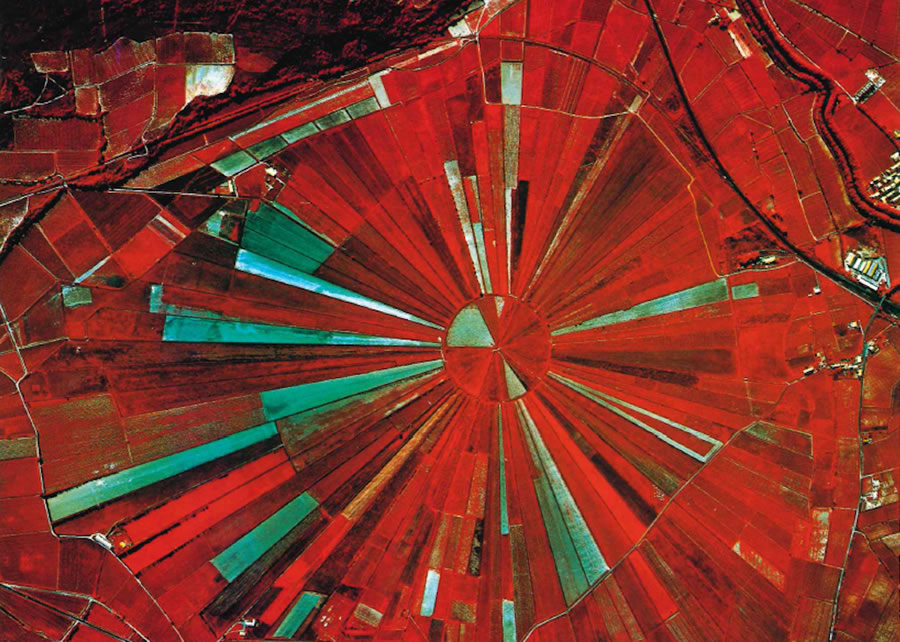وقف متشامخا يحدق من علٍ في هذه الوجوه الكالحة المنثورة أمامه على الرصيف. وجوه هدّها الإعياء والسهر وأحرقتها ملوحة مياه البحر بعد ليلة عاصفة ظلت الرياح خلالها تدمدم والموج يحمحم مثل فرس مهزوم في سباق. ليلة رهيبة ارتفعت فيها الأمواج عاليا في صخب وعنف كاشفة عن وجه قبيح للطبيعة الثائرة التي لا ترحم. كانت ليلة مخيفة مظلمة لم يضئها سوى وميض البرق بين الفينة والأخرى فتكاد الأبصار تعشى ثم سرعان ما تعقب ذلك الوميض زمجرة الرعود الحادة العنيفة. هو البحر في أشد حالات غضبه وعنفه، يثور بلا إنذار ويهدأ بلا إنذار، وبين ثورانه وهدوئه تحدث أشياء لا يعيشها سوى البحارة الذين نذروا حياتهم لواجهة صخبه وغضبه وجبروته. في تلك الليلة رأى البحارة الموج يتلاعب بالمواعين كما تتلاعب الرياح بأوراق الأشجار أثناء فصل الخريف. رأوا المجاديف تتطاير والشباك تتناثر على الرصيف، شاهدوا المياه تصفع خدود المراكب فتبكيها.
عندما أزاحت أنوار الصباح غشاوة الظلام من أمام أعين البحارة أدركوا حجم خسارتهم، وأدركوا أنهم وحدهم سيعانون لأيام وربما لأسابيع محاولين رتق جراحاتهم. خرجوا من مآويهم وأوكارهم وأوجارهم وتوافدوا على الرصيف، جاؤوا فرادى، وظلوا يبحلقون في معداتهم المكسرة وشباكهم الممزقة ومراكبهم المحطمة. لم يستنجدوا بأحد بل رفعوا أعينهم إلى السماء يستغيثون. لا ملجأ للضعفاء سوى الله.
كان قدومه دراماتيكيا، وكان وصوله فانتاستيكيا، فُتِح له باب السيارة فنزل ومشى محاطا برجال أقوياء أشداء. كان يرتدي بذلة سوداء بخطوط بيضاء دقيقة. لمعت ساعة يده الذهبية فكاد لمعانها يخطف الأبصار. خاتمه الماسي بفصه الكبير يبهر الأنظار. تقدم ويده تحاول كل مرة إعادة ربطة عنقه التي تلاعبت بها الرياح إلى موضعها فوق بطنه المكور الكبير. لا أحد يعلم أجاء معزيا مواسيا أم شامتا هازئا.
سرت بين الواقفين همهمات سرعان ما تحولت إلى عبارات اشمئزاز وتقزز من هذا الزائر الغريب الذي حل بينهم في لحظةٍ مجنونة. كانت الكلمات في البداية مبهمة غامضة بأصوات خفيضة ثم انكشفت الحروف وعلت الحناجر بألفاظ السب والشتم. ارتفعت الأصوات وتداخلت فبدت لأول وهلة مثل نداءات الباعة في الأسواق الشعبية. لكن صوتا واحدا علا فوق كل الأصوات صارخا dégage. في تلك اللحظة توحدت كل الحناجر مرددة هذا العبارة التي أنجبتها التحركات الاجتماعية التي أدت إلى سقوط النظام السابق ورحيل رموزه. كانت تلك العبارة كلمة عبور من عهد إلى عهد جديد خطه جيل جديد بلغة جديدة فأحدث فوضى جديدة غير مألوفة عمّت الشوارع والأسواق والساحات والمقاهي والمواخير والحانات والمعاهد والمدارس ووسائل النقل والمحطات وأروقة المحاكم ومدارج الملاعب ومدرّجات الجامعات. وبلغت تلك الفوضى أشدها عندما تحولت إلى مواقع النفوذ وأروقة اتخاذ القرارات المصيرية. لحظات مجنونة، لم يدرك أحد ما حدث إلا عندما شقَّ صوتٌ الليلَ "افرحوا يا توانسة الدكتاتور هرب". لكن التوانسة لم يفرحوا منذ تلك اللحظة. ظلت وجوههم واجمة وعيونهم جاحظة تتطلع إلى هذا الفرح الذي كلما حاولوا الإمساك به تفلّت من بين أيديهم كالماء. ظلوا يخوضون في بحار ناضبة وهم يخالون أن أجسادهم محمولة فوق الماء متناسين أن أقدامهم مغروسة في الوحل لا يستطيعون منه فكاكا.