من أجمل قصص الحب والعشق في زماننا ما نسجتهُ عفوية الأقدار بخيوط من ذهب بين كاتبين مرموقين ألّفهما حبُّ القلم وعشقُ الكلمة، يتعلق الأمر بالكاتب اللبناني جبران خليل جبران والكاتبة مي زيادة ذات الأصول الفلسطينية، فما كان يجمع بينهما هو حبٌّ عذري أفلاطوني لا ريب فيه، خالص من كل الشوائب، زاخر بكل آيات الجمال والجلال، وصفه العارفون به بالحب السماوي الذي عجزت الأرض على احتوائه فرفرف بجناحيه إلى السماء، ولعل ما أصبغ هذا الحب العذري السماوي بصبغة الانبهار ما كان لطرفيه من سلطة هادئة على جمالية الكلمة وتصويرية الأحاسيس الجارفة والعواطف الصادقة المُنزّهة عن دونية المادة، فلم تلبث هذه السلطة أن حلّقت بمن ينبشُ في خبايا هذا العشق المجنون نحو عوالم مثالية منفصلة عن كل ما لا يُرغبُ فيه، لا يُفتحُ مجالها الرحب سوى للمشاعر الطاهرة والأحاسيس النبيلة لتُقيم على أرضها صرح الحضارة، وإذا كانت العلاقة بين مي وجبران قد اتصفت بالغرابة والندرة في غايتها، فهي أولى بأن توصف بذلك، وأجدر بأن تصير نبراسا للسابحين في أغوار الحب والعشق دونما عبرة ولا دراية. وإذا كان جبران ممن يؤيدون فكرة الكلمة في قدرتها ومقدرتها على أن تُحدث ما تُحدثه القذائفُ والبراكينُ، فإن قوة هذه اللغة تلين وتذوب أمامه بقدرة قادر بمجرد أن تبدأ أناملُه بمداعبة كلماته العابرة للقارات من أمريكا إلى القاهرة، في رسائل حب لم تتوقف لعشرين ربيعاً.
فن الرسم الرقمي لدى الفنان البلجيكي "كرستيان بافيت" ـ أبو إسماعيل أعبو
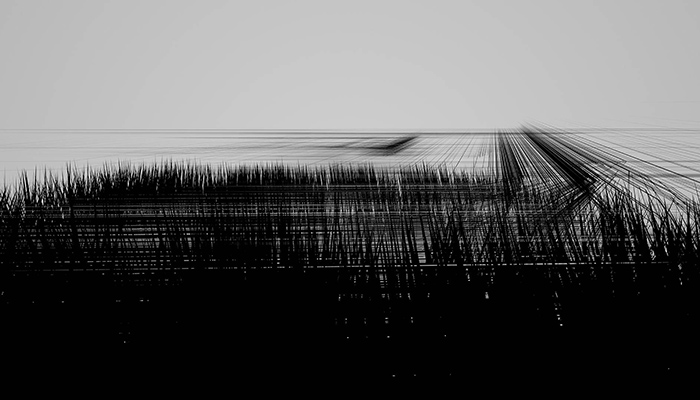 في سياق استرسال الثورة التكنولوجية، ونشوء مجتمعات المعرفة، انبثقت في المنتصف الثاني من القرن العشرين الثورة المعلوماتية، التي لم تلبث بوسائطها التواصلية السمعية والبصرية والمكتوبة، أن أمست حدثا كونيا مثيرا، أفضى نتيجة تأثيراته الحضارية السريعة بالإنسان، إلى ارتياد عوالم رقمية، لم يكن له عهد من قبل بمجالاتها المعرفية والخدمية والترفيهية، وإلى معايشة بموازاة حياته الواقعية حياة افتراضية، تتزامن فيها الأزمنة، وتتوحد الأمكنة، وتلغى المسافات والحدود بين المحلي والكوني، ويتآلف الآني والتاريخي، ويتجانس الحقيقي والخيالي، ويتحقق التعارف مع الغير النائي، وتبادل الآراء والمشاعر معه، والترفيه عن النفس بعفوية وحرية...
في سياق استرسال الثورة التكنولوجية، ونشوء مجتمعات المعرفة، انبثقت في المنتصف الثاني من القرن العشرين الثورة المعلوماتية، التي لم تلبث بوسائطها التواصلية السمعية والبصرية والمكتوبة، أن أمست حدثا كونيا مثيرا، أفضى نتيجة تأثيراته الحضارية السريعة بالإنسان، إلى ارتياد عوالم رقمية، لم يكن له عهد من قبل بمجالاتها المعرفية والخدمية والترفيهية، وإلى معايشة بموازاة حياته الواقعية حياة افتراضية، تتزامن فيها الأزمنة، وتتوحد الأمكنة، وتلغى المسافات والحدود بين المحلي والكوني، ويتآلف الآني والتاريخي، ويتجانس الحقيقي والخيالي، ويتحقق التعارف مع الغير النائي، وتبادل الآراء والمشاعر معه، والترفيه عن النفس بعفوية وحرية...
إن هاته الحياة المستحدثة نتيجة الرقمنة، بعثت الإنسان على فك جل الأطواق التعبيرية، التي كانت تحول دون تواصله مع بني الإنسان ومع محيطه، إذ أمكنه ابتداع معدات إلكترونية رقمية ذكية، أسعفته على التواصل السريع المتعدد القنوات والأغراض، وتدبير شأنه الذاتي، وشؤونه الموضوعية، و استشراف بتلقائية و خبرة علمية عالية آفاق حياتية رحبة، وابتداع عوالم ابداعية تفاعلية ذات تناسقات جمالية حركية، ترتهن بسيرورة التلقيات واحتمالاتها.
مفهوم المحاكاة بين أرسطو وفلاسفة الإسلام : مراجعة نقدية ـ محمد المعطي القرقوري
معلوم أن النظرية الارسطية في الشعر والفن عموما ، وما يتعلق بأسسها الجمالية، تقوم بكاملها على مفهوم المحاكاة ، وهو مفهوم مركزي في كتاب الشعر لأرسطو. وقد أثيرت حول المفهوم نقاشات و جدالات واسعة بين مختلف أصناف الباحثين في قضايا الشعر و الفن، و فلسفة الجمال بكيفية خاصة، وذلك منذ أن ظهر الاهتمام بكتاب الشعر لأرسطو لدى مفكري عصر النهضة الأوروبية مع بداية العصر الحديث ، ولازال النقاش مستمرا الى لحظتنا الراهنة، خاصة في حقول علوم البلاغة والنقد الحديث.
ولعل السر في اتساع دائرة الاهتمام بـهذا المفهوم من طرف المهتمين بقضايا النقد والشعرية العامة، يعود بالكلية إلى طابع الإرباك الذي صاحب المفهوم ، خاصة لدى الباحثين الاروبيين، منذ أوائل القرن 16 والى الآن ، وهو إرباك غذى ، بشكل ظاهر، جميع الآراء التي أثيرت حول المفهوم، ولقد أرجع بعض الباحثين هذا الإرباك إلى طبيعة المفهوم ذاته، من حيث هي طبيعة تكونـها الحمولة الأفلاطونية، التي لم يستطع أرسطو، حسب رأي هذا البعض من الباحثين، استبعادها بكيفية واضحة وصريحة في خطابه حول الشعر . وهذا ما جعل، حسب هذا الرأي ، القضايا التي طرحها أرسطو في كتابه عن الشعر (هدفا لألوان لا حصر لها من التأويل والفهم المتباين)([i]) وعلى رأس كل هذه القضايا قضية المحاكاة نفسها، والتي هي حجر الأساس في الخطاب الأرسطي حول الشعر والفن كما أسلفنا.
أَثِيــرُ الْفَرَاشَــــات.. : صدى روح المبدع وصوته المُتَمَوِّجِ تموجات الذاكرة والحياة ـ سعيدة الرغيوي
ومضات " أثير الفراشات" للمبدع " محمد حماس" نغمٌ مُعَطَّرٌ بانفلاتات الروح والذات ..تنطلق من الوجدان لتتسربل بقشيب الرًّبيع وبهائه ودروب وألوان الحياة بكل تفاصيلها وتمفصلاتها وتنقاضاتها وزخمها وبالعشق وطقوسه وتقلباتــه ..
تُراوِدُ السُّكون عن سكونه وصمته، تُحاكي صور الذَّات الكاتِبة/الْمُبْدِعَةِ لتجعلها تحكي وتسرد وتحتفي وتنسج صوراً متعددة من محطات حياتية للذات المبدعة.
هي لوحات لفراشات تطير من أقحوان إلى آخر، تتجسَّد ُ حيناً قبسا من نُورٍ،وحيناً آخر نبرة غضب وآحايين أخرى تستدعي الذكريات وتقتحمُ الصَّمت وتَرْكبُ يمَّ اللُّغة لتَتَدَفَّقَ أغْنياتٍ وألحان،تارة بعين الحنين والشَّوق وتارة بعبق حروف الأمل المُسْتَنْبَتَةِ في زخم الألــم والوجع.
" أثير الفراشات" يُبَدِّدُ صمت الذَّات المبدعة، يستنطقها لتبوح بمكنوناتها، فتقتحم صمت المبدع وتتوغَّل فيه لِتكْشِف عن خبايا هذه الذات بِلُغَةٍ أَنِيقَةٍ.
القارئ الأمازيغي والأنثروبولوجيا الثقافية المحلية ـ د. عبد الجليل غزالة
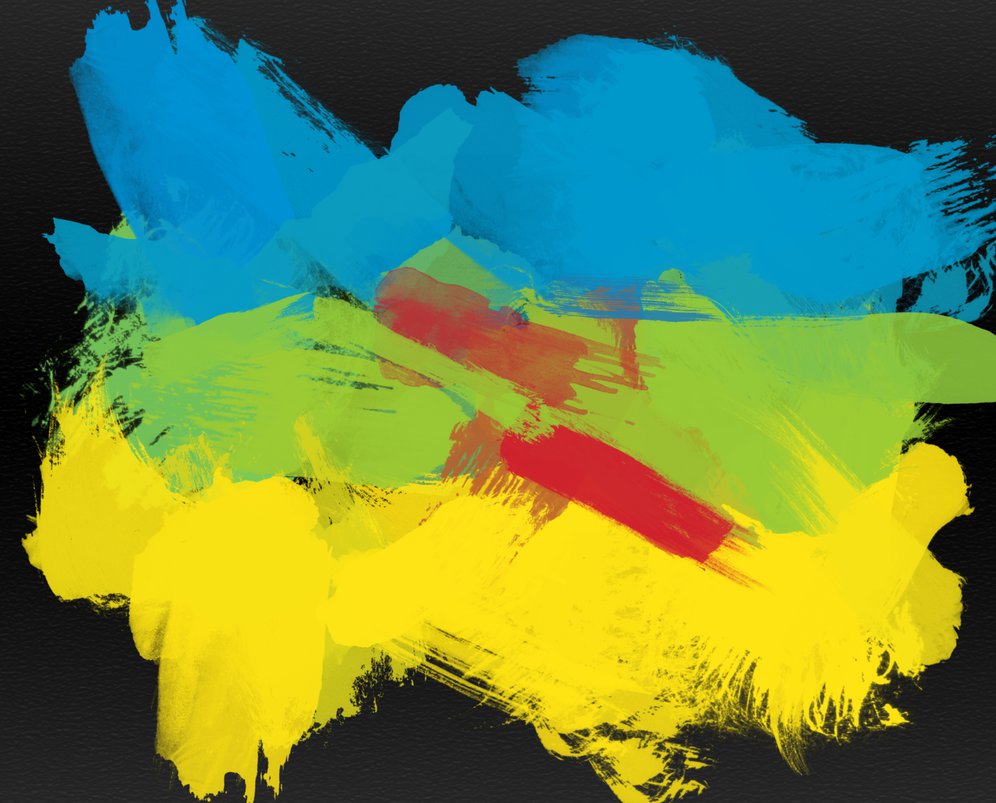 أوليات
أوليات
تتعدد نظريات ومنهجيات التلقي والتأويل ( المستوردة ) التي تتصارع وتزداد تفاقما في ذهن القارئ الأمازيغي ( العليم ) ، حيث نجد أن سوادها الأعظم يرتكز على منجزات الأدب العربي والغربي المعاصرين بسماتهما وخصائصهما الجمالية ، والفكرية ، والمقامية ، والأنثروبولوجية الثقافية المتميزة . لذلك ، فإنه قد يتابع و يتشيع وربما يذعن أحيانا لبعض نزالاتهما وتحدياتهما وأطارحهما النقدية والتأويلية النصية التي تطمس شخصيته وملكيته الفكرية الخاصة ، وأحيانا أخرى يشق عليهما عصا الطاعة ويناصبهما العداء دون هوادة لإثبات وترسيخ هويته الأنثروبولوجية الثقافية المحلية .
تتداخل المصطلحات والمفاهيم الإجرائية بين طيات نظريات ومنهجيات التلقي أو القراءة المعاصرة ، حيث نعانق جمهرة من المعارف والأفكار والرؤى والتيارات والاتجاهات والثنائيات المنطقية الوضعية والعبثية الوهمية المترفة :
أ _ القارئ / النص.
ب _ الاتصال / التأثير .
ج _ التبادل الفني / الجمالي .
د _ الإنجاز / التأويل .
ه _ أسطورة القارئ الضمني / الورقي / العبثي ...
و _ أفق الانتظار والتوقع .
بعض آليات تحويل النص الروائي إلى شريط سينمائي ـ عبد اللطيف محفوظ
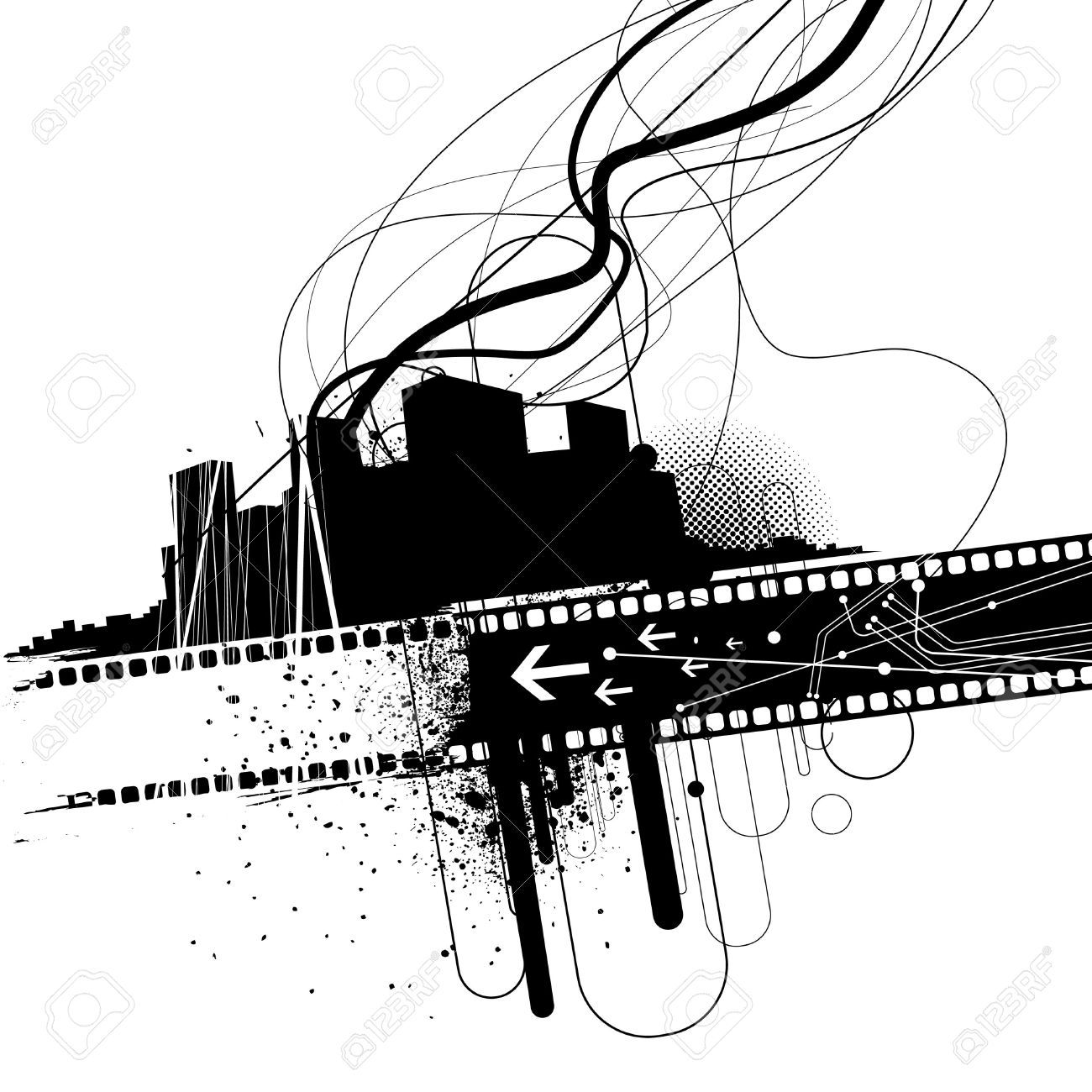 مقدمة:
مقدمة:
تندرج القضية التي يود هذا المقال مناقشتها ضمن قضية أعم وأرقى، إنها قضية تحويل العمل الفني المنتج وفق قيود فن بعينه إلى عمل فني آخر خاضع لقيود فن مغاير. وهي قضية عامة تهم المتعاليات المتحكمة في كل أشكال التحويل، سواء تعلق الأمر بالتحويل الذي ينجز انطلاقا من نصوص شفوية أو مكتوبة ويتحقق في نصوص محكومة بقيود أجناسية مغايرة لقيود أجناس النصوص الأصلية مثل تحويل الأسطورة إلى نص مسرحي أو ملحمي أو تحويل رواية أو قصيدة إلى نص مسرحي؛ أو تعلق الأمر بالتحويل الذي ينجز انطلاقا من نصوص أدبية ويتحقق في أعمال فنية لا تشكل النصوص الأدبية إلا مواد دلالية أولية لها (وذلك نتيجة كون تلك الأعمال تستخدم، في تحقيقها للتواصل مع متلقيها، إضافة إلى اللغة آليات غير لغوية)، كما هو حال تحويل الأسطورة أو الحكاية أو الرواية أو النص المسرحي نفسه إلى عروض مسرحية أو فيلمية.
وبما أن هذه القضية العامة تهم المستويات الأنطولوجية والإبيستمولوجية والإيديولوجية، فإنها تقتضي –من أجل وصف أشكال تحقيقها الذهني والفعلي- معالجة مختلفة مكونات السيرورة العامة المتحكمة في ذلك التحقق. ولما كان هذا التحقق يتمثل في شرط أولي أساسي وهو شرط المواءمة، وفي إجرائين أساسيين موسطين لكل فعل تحويل وهما الاختزال والترجمة؛ فإن هذا المقال لن يتطرق لهما بتفصيل، بل سيكتفي بالإشارة إلى معناهما العام من خلال الإشارة الموجزة اللاحقة للاستعمال المخصوص لمفهوم التحول، وبذلك سيقتصر المقال على الآليات الثانوية الخاصة بما يلائم تحويل النص الروائي إلى عمل سينمائي.
جيل الظمإ مرافعة الحبابي من أجل التغيير ـ ياسين اغلالو
 تجسد رواية "جيل الظمإ" للفيلسوف المغربي محمد عزيز لحبابي (1922 – 1993)، مرافعة من أجل أجيال العالم الثالث الظامئة، في نضالها من أجل الحرية ومكان لها تحت الشمس. كتبت الرواية سنة 1958، وتعبر عن القلق الذي عاشه ولازال يعيشه مغرب ما بعد الاستقلال: بين جيل غارق في الدفاع عن مصالحه، ويتواطأ ضد نفسه وضد مصلحة الوطن، وجيل آخر يناضل للتحرر من التقاليد البالية والقيم الارتكاسية التي تؤسسها المصالح المتبادلة والمال والخنوع والخوف، إنه جيل الظمأ المتعطش إلى التغيير، جيل يعيش على أمل مغرب آخر ممكن...
تجسد رواية "جيل الظمإ" للفيلسوف المغربي محمد عزيز لحبابي (1922 – 1993)، مرافعة من أجل أجيال العالم الثالث الظامئة، في نضالها من أجل الحرية ومكان لها تحت الشمس. كتبت الرواية سنة 1958، وتعبر عن القلق الذي عاشه ولازال يعيشه مغرب ما بعد الاستقلال: بين جيل غارق في الدفاع عن مصالحه، ويتواطأ ضد نفسه وضد مصلحة الوطن، وجيل آخر يناضل للتحرر من التقاليد البالية والقيم الارتكاسية التي تؤسسها المصالح المتبادلة والمال والخنوع والخوف، إنه جيل الظمأ المتعطش إلى التغيير، جيل يعيش على أمل مغرب آخر ممكن...
بعابرة أخرى إنه قلق جيل الغد في مشروع الحبابي الفلسفي، يحضر هذه المرة في قالب روائي يعالج المداخل التي يجب التركيز عليها ليجد شعب ما مكانة له تحت الشمس. خصوصا في واقع مغربي دفع بالحبابي على لسان إدريس الكاتب والأديب الشخصية المركزية في الرواية إلى طرح أسئلة تتعلق: بهوية الذين يبررون الجرائم الجماعية؟ الذين يحتقرون السذج البسطاء وحياة الطبقة الكادحة؟ والذين يدعمون نظام الاستغلال؟
مفهوم الغرض عند العرب : مقوم جمالي لدراسة القصيدة التقليدية ـ فاطمة الميموني
 هل يمكن الحديث عن نظرية أجناسية في التراث العربي؟
هل يمكن الحديث عن نظرية أجناسية في التراث العربي؟
بإمكاننا أن نجد بعض الآراء النظرية المتناثرة في كتب اللغويين، والبلاغيين، والفقهاء، والأدباء، والنقاد، والفلاسفة التي يمكن أن تدور حول التفريق بين الشعر والخطابة أو بين النظم، والنثر، وأسس كل منهما، أو تتعلق بالحالات النفسية، والاستعداد الفطري لقول الشعر، وتحديد العلاقة بين الشعر، والدين، والفلسفة، وأثر البيئة في الشعر، حيث ميز هؤلاء وأولئك بين شعر البداوة، والشعر الذي يكون في الحضر، ويمكن القول إن الدراسات النقدية العربية التراثية قد دارت حول قضايا ثنائية كقضية اللفظ والمعنى، وقضية الطبع والصنعة، وقضية الصدق والكذب…إلخ.
وقد كان العرب ينظرون إلى الشعر نظرة تقديس وتقدير فيفضلونه على سواه، فـ"كلام العرب نوعان منظوم ومنثور، لكل نوع منهما ثلاث طبقات: جيدة، ومتوسطة، ورديئة، فإن اتفق الطبقتان في القدر وتساوتا في القيمة، ولم يكن لإحداهما فضل على الأخرى، كان الحكم للشعر ظاهرا في التسمية، لأن كل منظوم أحسن من كل منثور من جنسه في معترف العادة"[1].
وقد أثارت هذه المفاضلة التي جرت بين الشعر، والنثر، قضية أخرى تتعلق بكون القرآن أعجز من غيره على أنه لم يكتب شعرا، فأدى ذلك إلى تفضيل النثر على الشعر، حيث صار بعض المنتصرين للنثر "يحتج بأن القرآن كلام الله منثور وأن النبي غير شاعر"[2]. إلا أن صاحب العمدة يرى أن العرب "نسبوا النبي إلى الشعر لما غلبوا، وتبين عجزهم فقالوا: هو شاعر لما في قلوبهم من هيبة الشعر وفخامته وأنه يقع منه ما لا يلحق"[3].















