 أولا: الهامش
أولا: الهامش
توطئة
منذ النقلات التي حققها العملاق نجيب محفوظ في الفن الروائي، تبوأت الرواية مكانها وتربعت على عرش الفنون والآداب، وظهر جيلٌ جديدٌ من الرواد، ساهموا في دفع حركة الإبداع في الرواية العربية، وبشكل خاص إبان الحقبة الناصرية، التي شهدت ميلاد العديد من الروائيين المهمين، والذين تركوا آثارًا لا تندرس في أدب الرواية بشكل خاص، والأدب بشكلٍ عام، وهي فترة كانت الظروف الموضوعية مهيأة، وهي تغيرات كيفية، قامت على تراكمات كمية، منذ فجر الرواية الذي أَذنَّ له << محمد حسين هيكل بروايته زينب>> وواصل الإمامة يحيي حقي، ثم نجيب محفوظ و..هلمجرا ، وذلك بالطبع جزء من ديناميكية وحيوية المجتمع المصري، ووجود القوى الثورية والمناضلة، التي تقاوم الاحتلال ( إبان الملك وأعوانه) والاستعمار و الهيمنة الجديدة فيما بعد، مربوطةٌ بالبعد الاجتماعي والطبقي( شعارات الاشتراكية).
ومن الذين برزوا في هذا الزمن، وأصبح لهم باعٌ طويل أديب مقالنا << جمال الغيطاني، وقبل أنْ نبدأ موضوعنا نلقي الضوء على حياته و مسيرته الإبداعية، من خلال بانوراما سريعة، ستفيدنا عندما نتعامل مع الرواية التي سنتحدث عنها بعد قليل.
رباعيـــات الـخيام : روعة الانتشاء ولوعة الفناء ـ إبراهيم مشارة
 غدونا لذي الأفلاك لعبة لاعـــب
غدونا لذي الأفلاك لعبة لاعـــب
أقول مقالا لست فيه بكــــــــاذب
على نطع هذا الكون قد لعبت بنا
وعدنا لصندوق الفنا بالتعاقــــب
عمر بن إبراهيم الخيام
إذا كان المعري في الشعر العربي هو " شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء" ذلك أنه ضمن شعره آراءه الفلسفية في الحياة وخلاصة تأملاته وقراءاته في الفكر الفلسفي وقد جمع ذلك كله في "اللزوميات"، فحق لشاعر نيسابور وعالمها عمر الخيام أن يدعى شاعر العلماء وعالم الشعراء، فقد جمع بين العلم الدقيق والفن الأصيل وزاوج بين التأمل في العدد والتأمل في الوجود، فجاء في شعره كما جاء في علمه فرادة إبداع وأصالة فكر وصدق فراسة وحرارة وجدان، وحق لزبدة إبداعه الشعري المعروفة بـ "الرباعيات" أن تنال مرتبة الخلود ومرتبة العالمية ، ذلك أنها خير ما أبدعته فارس من الشعر الجامع بين عمق الفكرة وجمال العبارة وصدق الشعور وحق لعمر الخيام أن يستوي بين شعراء فارس شاعرا فذا من كبار شعراء الإنسانية وأن تكون رباعياته زادا فكريا وجماليا وإنسانيا خير ما تهديه فارس إلى العالم .
وحياة الخيام غامضة لا نعرف عنها الكثير وأول شك ينتاب الباحث هو تحديد تاريخ ميلاده وقد تضاربت الروايات في ذلك ومن المرجح أنه ولد في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري وقد عاش في زمن السلاجقة
استطيقا الشعر في الأسس الفلسفية لعلم جمال الشعر ـ عبد العزيز بومسهولي
 "الشعر هو الفن المطلق للعقل، الذي أصبح حرا في طبيعته، والذي لا يكون مقيدا في أن يجد تحققه في المادة الحسية الخارجية، ولكنه يتغرب بشكل تام في المكان الباطني، والزمان الباطني للأفكار والمشاعر". (هيجل)
"الشعر هو الفن المطلق للعقل، الذي أصبح حرا في طبيعته، والذي لا يكون مقيدا في أن يجد تحققه في المادة الحسية الخارجية، ولكنه يتغرب بشكل تام في المكان الباطني، والزمان الباطني للأفكار والمشاعر". (هيجل)
"إن الصور الجمالية… لا علاقة لها إطلاقا بالبلاغة، فتلك هي إحساسات: مؤثرات إدراكية وانفعالية، مشاهد ووجوه، ورؤى وصيرورات… ولعل خاصية الفن هي المرور عبر المتناهي، لاستعادة اللامتناهي وإعطائه ثانية" (دولوز)
1 ـ تقديم:
هناك واقعة تحمل أكثر من دلالة، وهي أن ظهور علم الجمال، تزامن مع موت البلاغة الكلاسيكية. وهي واقعة مؤشرة على القطيعة الإبستمولوجية التي ميزت عصر الحداثة، بما هو انفتاح الكينونة على الفردانية، وما يعنيه هذا الانفتاح من إطلاق سراح "الأنا-موجود" من سجن التطابق، والميتافيزيقا هذه التي تحيل كل شيء إلى أصل ظاهر للوجود، كما أنها تخضع الكائن للطبيعة.
وموت البلاغة من جهة أخرى، تعبير عن انهيار العقلانية الدوغمائية التي تقوم نظرية المعرفة فيها على فكرة التماهي بين الذات والموضوع، والتماثل بين نسق الأفكار ونسق الأشياء. وهذا التماهي كان له وجهان: "فهو يستتبع في ذاته غائية، كما أنه يشترط مبدأ لاهوتيا كمصدر وضمانة لهذا الانسجام، ولهذه الغائية"(1).
النموذج الانساني في الأدب المقارن. البخيل نموذجا ـ الكرويطي عبد الخالق
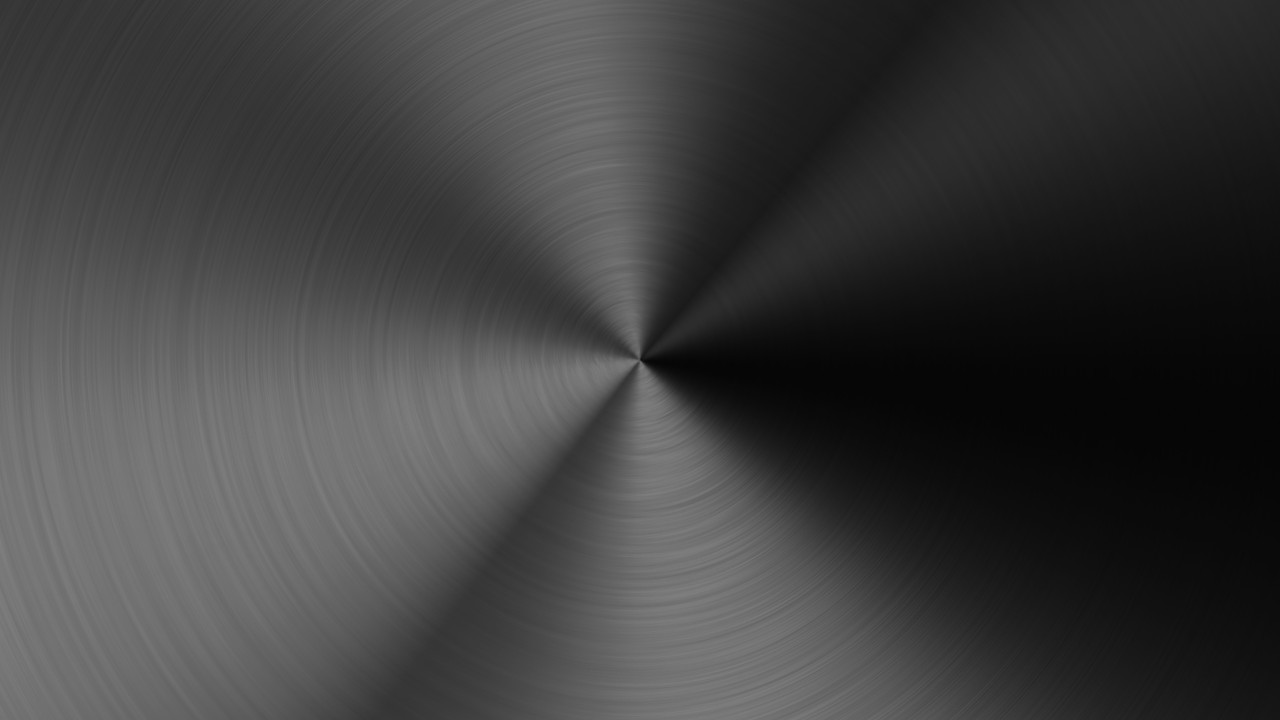 لقد تضمنت الأجناس الأدبية عامة، والأعمال الأدبية التي تدور في فلكها، شخوصا تعد انماطا مساعدة لإتمام العمل الفني، ليغدو متكاملا، لكن هذه الشخوص تتمثل مواقف تعبر عن رؤية الأديب لواقع، وتعلو هذه الشخصيات نماذج تعبر عن الفكرة المرادة، والرسالة المتوخاة، تسمى هذه الشخصيات التي تحمل الرؤى والمواقف، بالنماذج الأدبية.
لقد تضمنت الأجناس الأدبية عامة، والأعمال الأدبية التي تدور في فلكها، شخوصا تعد انماطا مساعدة لإتمام العمل الفني، ليغدو متكاملا، لكن هذه الشخوص تتمثل مواقف تعبر عن رؤية الأديب لواقع، وتعلو هذه الشخصيات نماذج تعبر عن الفكرة المرادة، والرسالة المتوخاة، تسمى هذه الشخصيات التي تحمل الرؤى والمواقف، بالنماذج الأدبية.
إن النموذج الانساني في الأدب، نتاج تصوير يقوم به الكاتب، فيتمثل فيه صفات وعواطف "كانت من قبل في عالم التجريد، أو متفرقة في مختلف الأشخاص." فهو إذن كما يقول كليب KLLEP: "مفهوم جماعي للشخص أو السلوك(...) نجده كثيرا في الفن الشعبي والأدب والمسرح. وأنه مركب "من سمات نفسية أو شخصية أو طباع أو عقلية خاصة."وهذه السمات "البارزة للأفـراد الذين لهم مكانة متميزة في المجتمع وهذا ما يحفزهم لتبني نوع خـاص مـن سـلوك الدور."
الكتابة النسويّة و سلطة الجسد ـ جمال قصودة
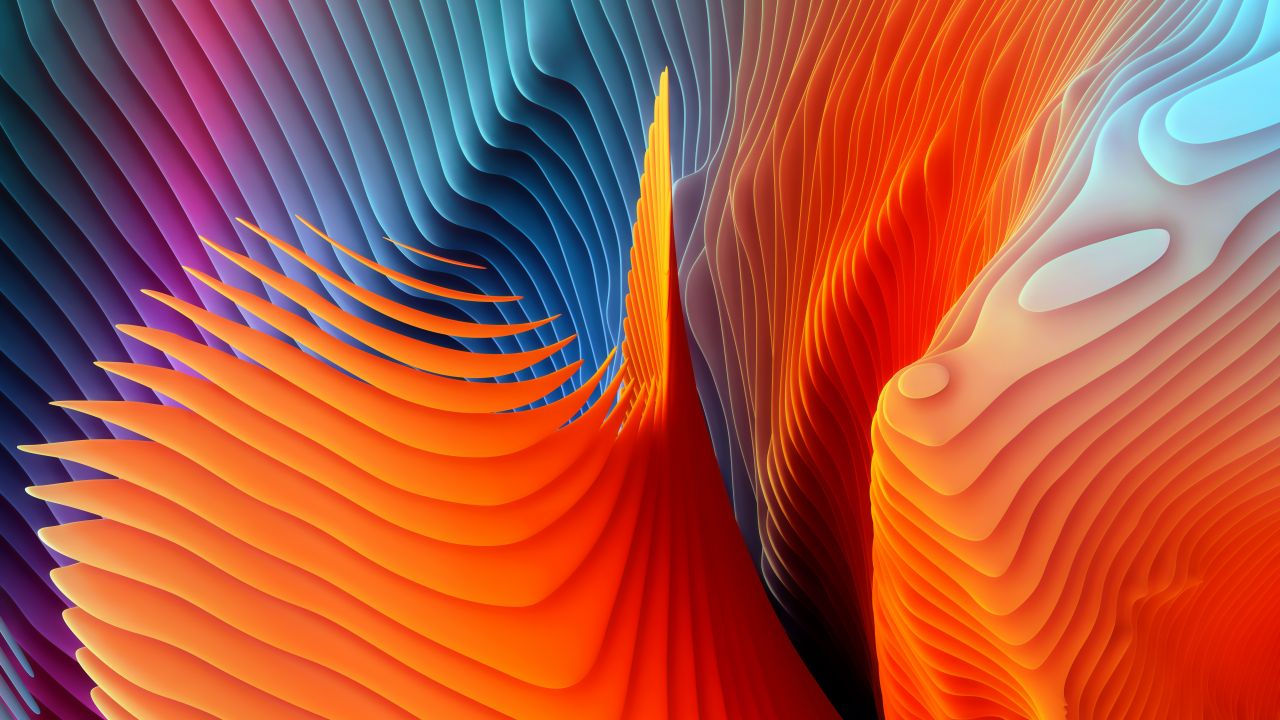 مدخل :
مدخل :
بداية علينا التنويه بكون مفهوم الكتابة النسويّة مفهوما مغلوطا ابتدعته الثقافة الذكوريّة المتسلطة بمجتمعاتنا العربيّة للتاكيد على دونية ابداع المرأة العربية ، الحقيقة مفاهيم كثيرة وجبت مراجعتها كمفهوم المبدع الشّاب او المبدع العصامي : الكتابة لايعنينا جنس صاحبها، ولا عمره و لا علاقة لها ايضا بكرّاس المعلم ،الكتابة هي الكتابة و النصّ هو النصّ المحكّ الحقيقي للحكم عليه محكٌّ جماليّ لا يخضع البتّة الى تقسيمات جنسيّة/فئوية –جنس كاتبه - و لا يتأثر بالعمر او المستوى التعليمي و محمد شكري و جمال الصليعي خير دليل كم من اكاديمي فشل في ان يكون شاعرا و كم ناقد ارعب الكتاب بنصوصه النقديّة تعذّر عليه ان ياتي بربع ما ابدعه الشاعر أو الروائي رغم ما يحمله من تنظيرات و علم بالمباني و المعاني والمدارس و اللغة .
نبوغ نازك الملائكة ، تجديدها و فعلها الطلائعي باعتبارها من روّاد الشعر الحديث و المجددين فيه لا علاقة له قطعا بأنوثتها بل احدثت بنصّها " الكوليرا" شرخا في الثقافة العربية زلزل مسلّماتها ، كل هذه الزلزلة تعود الى المنجز الابداعي في جماليته و طرافته بعيدا عن جنس صاحبه ،لذلك فهذا التقسيم بين كتابة نسوية و اخرى ذكورية –حسب اعتقادي – هو تقسيم ملغوم و خاطئ .
"الشيخ والبحر" لأرنست همنجواي : اختبار الإرادة وقوة العزيمة.. رغم الثناء على الأعداء ! ـ رحال لحسيني
 "الشيخ والبحر"، الرواية (أو القصة) الشهيرة للكاتب الأمريكي "أرنست همنجواي" (1) والتي كانت وراء فوزه بجائزة نوبل للآداب وبجوائز أخرى قبلها وبعدها، وتم تحويلها إلى عدة أفلام سينمائية (2) وتلفزيونية فضلا عن ترجمتها لعدد من اللغات منها العربية في أكثر من ترجمة... (3)؛
"الشيخ والبحر"، الرواية (أو القصة) الشهيرة للكاتب الأمريكي "أرنست همنجواي" (1) والتي كانت وراء فوزه بجائزة نوبل للآداب وبجوائز أخرى قبلها وبعدها، وتم تحويلها إلى عدة أفلام سينمائية (2) وتلفزيونية فضلا عن ترجمتها لعدد من اللغات منها العربية في أكثر من ترجمة... (3)؛
فرغم عدم استقرار الرأي حول ما إذا كان هذا العمل السردي الخالد رواية (قصيرة) أم قصة (طويلة) فقد ظلت "الشيخ والبحر" نصا إبداعيا عظيما يغوص في أعماق النفس البشرية مدا وجزرا ويسبر أغوارها انطلاقا من موضوعة صراع الإرادة والمواجهة المفتوحة ضد الاستسلام مهما تعددت العوائق والمثبطات وتوالت مكائد الزمن وطال أمد تحقيق المبتغى.
يقوم "أرنست همنجواي" في هذا العمل الإبداعي الخالد بنحت قيمة العزيمة في حياة الأفراد بتسليط الضوء على الصراع التاريخي للإنسان مع الطبيعة لتطويعها لفائدته.. وغير ذلك من القيم والمعاني والرسائل العميقة التي تبقى طازجة عند تتبع مسار وسيرة وأجواء وظروف عيش الشيخ، هذا البحار النحيف الذي لم يسعفه الحظ على صيد أية سمكة طيلة 84 يوما من نزوله المسترسل للصيد، حتى إنه أصبح عرضة للسخرية من طرف البعض، لكنه لم يفقد الأمل في تجاوز "حظه العاثر" إلى أن تحقق له ذلك حيث علقت "سمكة كبيرة وفاخرة" في صنارته..
ولأنها كانت ضخمة جدا استحقت منه المغامرة للفوز بها، فلم يتوان عن مجاراتها في عرض البحر يومين متتالين، بليلهما ونهارهما، حتى تغلب عليها وأحكم ربطها إلى مركبه الشراعي الصغير..
العنوان: التعدد القرائي في رواية "جيرترود" (شهادات وقراءات) ـ فاطمة الزهراء بن اعميرة نيازك
 لنوضح فكرة التعدد القرائي، ينبغي أن نسلم أولا بأن القراءة شرط ضروري لكل عملية تأويلية، لأن النص "لا يقدم إلا مظاهر خطاطية، يمكن من خلالها أن ينتج الموضوع الجمالي للنص، بينما يحدث الإنتاج الفعلي من خلال فعل التحقق"[1]. وكل محاولة لفهم وتأويل النص تصطدم بصعوبات تخص نوعا محددا من القراء. فهناك القارئ الحقيقي والقارئ الافتراضي، القارئ المتمرس والقارئ العادي، القارئ الناضج والقارئ الساذج. ولكل واحد منهم طقوسه القرائية، التي ترجع إلى مؤهلاته ومعارفه وطرقه التي تمكنه من اقتحام جسد النص الروائي وتفكيكه. ثم إن القول بالتعدد القرائي، يتجسد في الممارسة الممنهجة القائمة على قواعد وخطوات لمساءلة النص الروائي والتعاطي معه.
لنوضح فكرة التعدد القرائي، ينبغي أن نسلم أولا بأن القراءة شرط ضروري لكل عملية تأويلية، لأن النص "لا يقدم إلا مظاهر خطاطية، يمكن من خلالها أن ينتج الموضوع الجمالي للنص، بينما يحدث الإنتاج الفعلي من خلال فعل التحقق"[1]. وكل محاولة لفهم وتأويل النص تصطدم بصعوبات تخص نوعا محددا من القراء. فهناك القارئ الحقيقي والقارئ الافتراضي، القارئ المتمرس والقارئ العادي، القارئ الناضج والقارئ الساذج. ولكل واحد منهم طقوسه القرائية، التي ترجع إلى مؤهلاته ومعارفه وطرقه التي تمكنه من اقتحام جسد النص الروائي وتفكيكه. ثم إن القول بالتعدد القرائي، يتجسد في الممارسة الممنهجة القائمة على قواعد وخطوات لمساءلة النص الروائي والتعاطي معه.
"جيرترود": بين القارئ العادي والقارئ المتمرس:
من الطبيعي ألا نخفي إعجابنا بقارئ متمرس، يبحث عن النوع الجيد من الرواية. لا يفقد الصبر في التنقيب، وله مهارة التمييز من الصفحات الأولى بين رواية جيدة، متوسطة وأخرى شبه رديئة*[2]، و "يتلذذ بإنتاج خطاب مواز للنص"[3]. ناقد لغوي وسميائي، يقرأ ليظهر فشل القارئ العادي الذي لا تتجاوز قراءته نطاق النص. وبه يكون ساذجا "سريع السقوط في فخاخ السارد"[4] بسبب خموله و جفاف فكره. عكس القارئ المتمرس الذي يقدم افتراضات ويشارك في تأويل الأحداث، متتبعا تفاصيل الرواية بعين قارئ مدقق ومحقق. واختيارنا لمحمد الأشعري و محمد أسليم باعتبارهما قارئين متمرسين جاء مقصودا لنبين من خلاله قصور القارئ الساذج.
التلقي والأثر الجمالي في رواية "جيرترود" ـ فاطمة الزهراء بن اعميرة نيازك
 في هذه الدراسة، سنحاول التطرق إلى مفهوم التلقي و علاقته بالأثر الجمالي في رواية "جيرترود"، وذاك من خلال ثلاثة أبعاد لأثر التلقي في رواية جيرترود، والآتية على الترتيب التالي: التلقي والأثر التشكيلي، التلقي والأثر البيوغرافي، التلقي والأثر المعرفي. وتبقى مسألة أساسية لا بد من الإشارة إليها، وهي أن إشكالية هذا الأثر سندرسه هنا انطلاقا من ثلاث قراءات لنقاد مغاربة: (بنيونس عميروش، حسن المودن، عبد الرحمن التمارة).
في هذه الدراسة، سنحاول التطرق إلى مفهوم التلقي و علاقته بالأثر الجمالي في رواية "جيرترود"، وذاك من خلال ثلاثة أبعاد لأثر التلقي في رواية جيرترود، والآتية على الترتيب التالي: التلقي والأثر التشكيلي، التلقي والأثر البيوغرافي، التلقي والأثر المعرفي. وتبقى مسألة أساسية لا بد من الإشارة إليها، وهي أن إشكالية هذا الأثر سندرسه هنا انطلاقا من ثلاث قراءات لنقاد مغاربة: (بنيونس عميروش، حسن المودن، عبد الرحمن التمارة).
أ) التلقي والأثر التشكيلي في رواية "جيرترود" :
- التشكيل والمعرفة البصرية "بنيونس عميروش"
في دراسة نقدية جديدة، كان الفنان التشكيلي والناقد الفني المغربي بنيونس عميروش(*)[1]، سباقا إلى تحسس الأثر التشكيلي في رواية "جيرترود"، وهذا ما تفسره دراسته النقدية المعنونة بـ "التشكيل والمعرفة البصرية في جيرترود" إذ تفضي هذه الدراسة إلى قراءة جديدة تفرض علينا مواكبة المقالة سطرا بعد سطر لنبين الأثر التشكيلي في رواية "جيرترود".
وعلى الرغم من تساؤلنا المستمر، عن الدافع الذي جعل الناقد المغربي بنيونس عميروش ينحاز إلى تقديم دراسة نقدية لرواية مغربية، بعد أن ألفناه في شكل نقدي متعلق بالجانب التشكيلي؛ سنجد أنه وقبل كل شيء فنان جمالي يضع الإبداع كله موضع مساءلة نقدية، بما في ذلك النصوص الروائية. لهذا من الطبيعي أن يكتب عن تجربة حسن نجمي، خاصة وأنه في عمله هذا كما يقول: "يقدم مادة روائية بقدر ما يقدم مادة تُعنى بالثقافة الفنية"[2].












