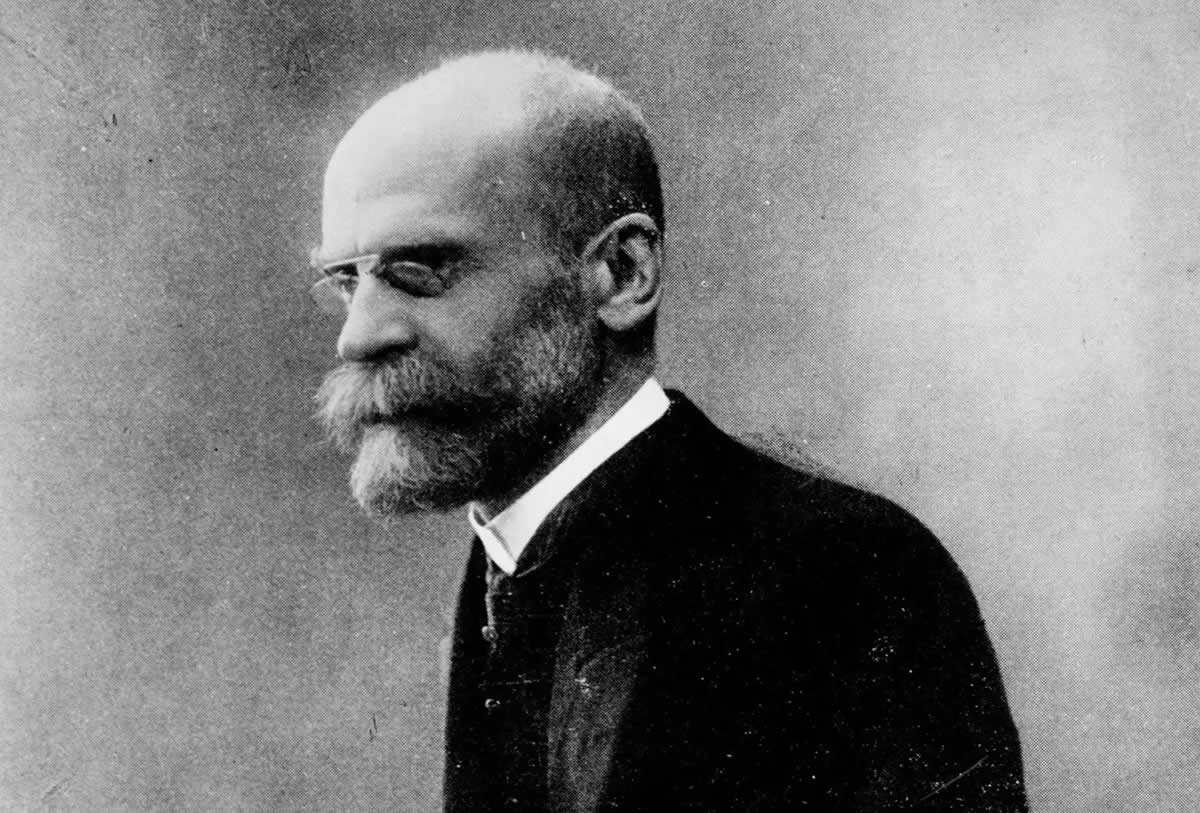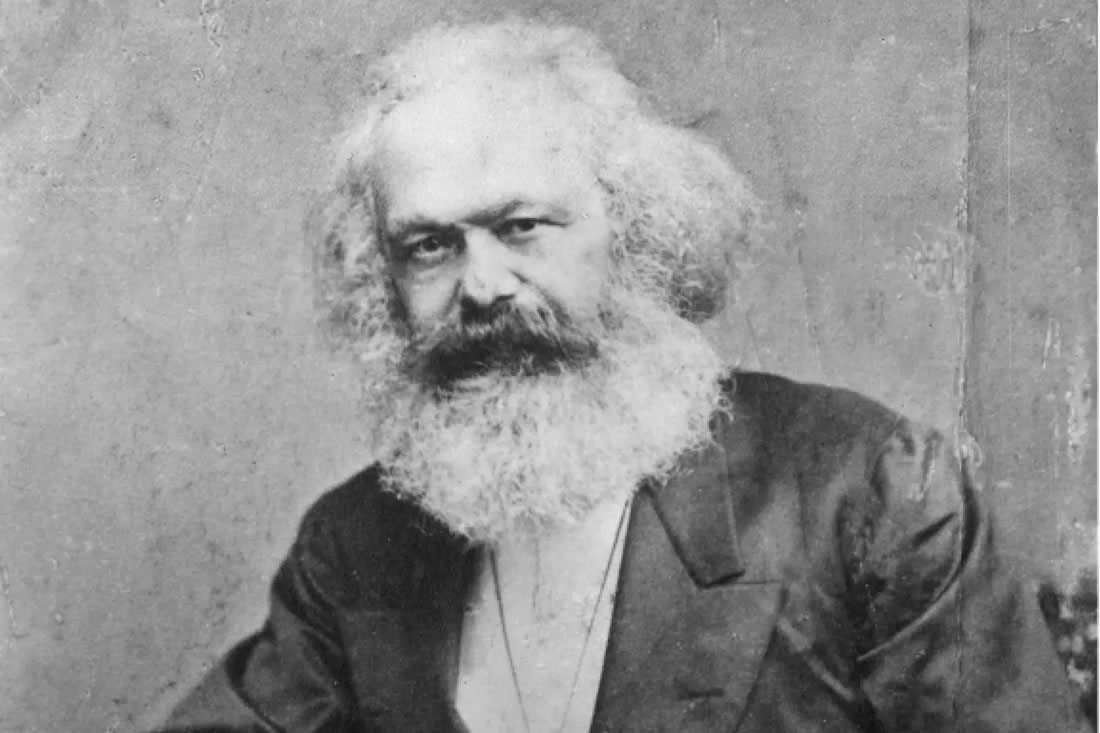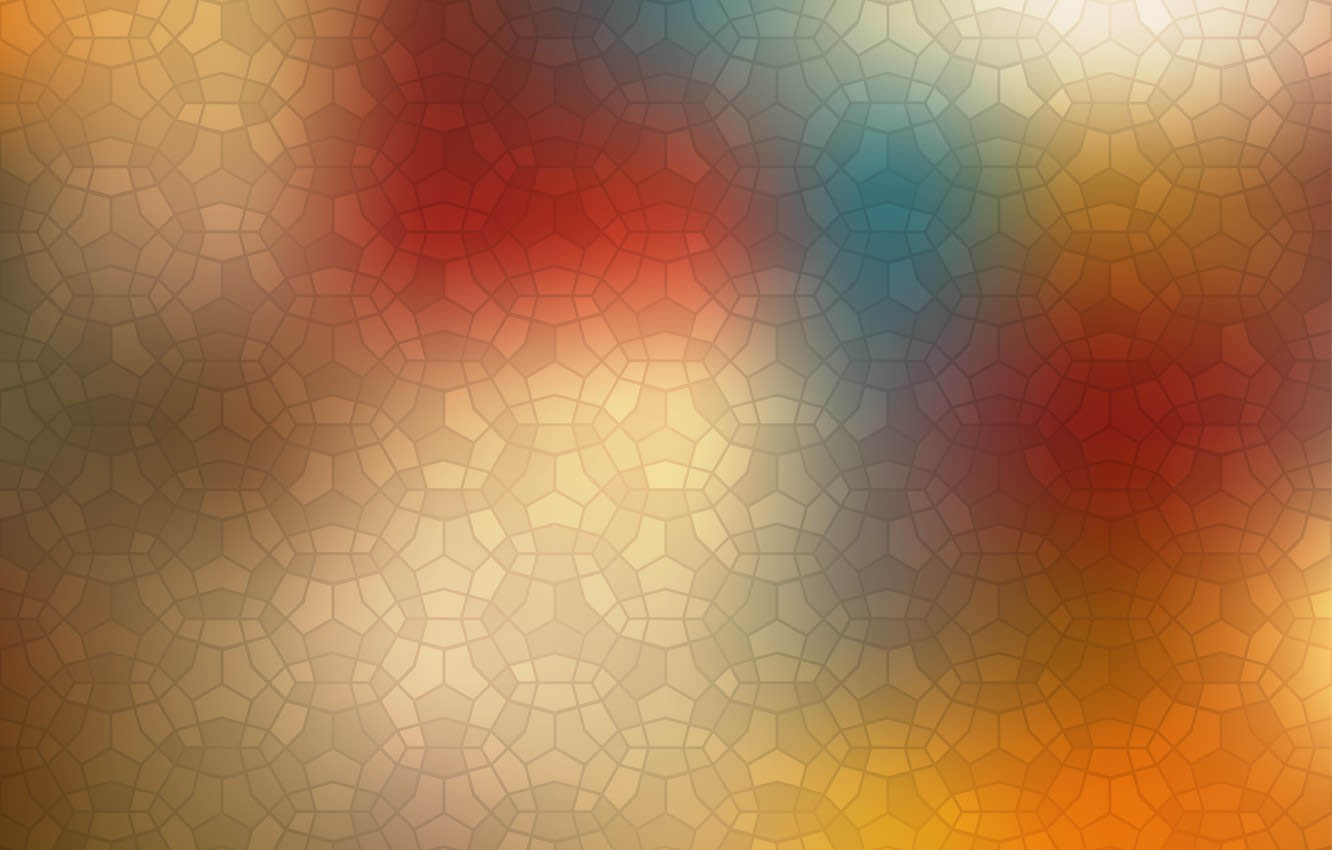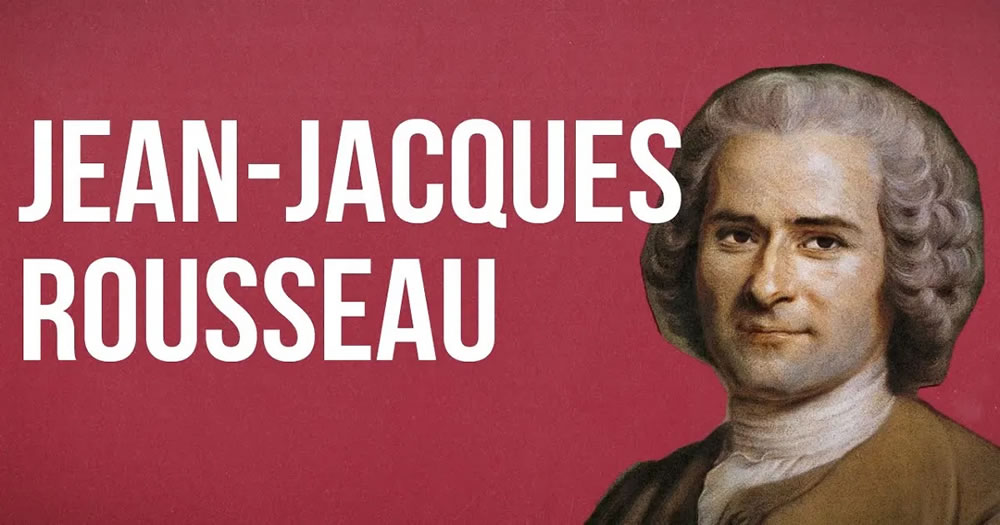"لشرح الأحكام القيمية، ليس من الضروري إما اختزالها إلى أحكام الواقع من خلال جعل فكرة القيمة تتلاشى، ولا ربطها بأنه لا أعرف أي قوة يمكن للإنسان من خلالها الدخول في علاقة مع متعال كوني."
الترجمة
"عند تقديم هذا الموضوع للمناقشة إلى المؤتمر، حددت لنفسي هدفًا مزدوجًا: أولاً، إظهار مثال معين كيف يمكن لعلم الاجتماع أن يساعد في حل مشكلة فلسفية؛ إذن، لتبديد بعض الأحكام المسبقة التي غالبًا ما يكون موضوعها ما يسمى بعلم الاجتماع الوضعي. عندما نقول إن الأجسام ثقيلة، وأن حجم الغازات يختلف عكسًا إلى الضغط الذي تتعرض له، فإننا نصوغ أحكامًا تقتصر على التعبير عن حقائق معينة. إنها تذكر ما هو، ولهذا السبب يطلق عليها أحكام الوجود أو أحكام الواقع. الأحكام الأخرى ليس هدفها قول ماهية الأشياء، ولكن ما هي قيمتها بالنسبة لذات واعية، القيمة التي تعلقها هذه الأخيرة عليها: نعطيها اسم الأحكام القيمية. تمتد هذه التسمية أحيانًا إلى أي حكم ينص على التقدير، مهما كان. لكن هذا الامتداد يمكن أن يؤدي إلى الارتباك الذي من المهم منعه. عندما أقول: أحب الصيد، أفضل النبيذ على الخمر، الحياة النشطة على الراحة، إلخ، فإنني أقوم بإصدار أحكام قد تبدو وكأنها تعبر عن تقديرات، لكنها في الأساس أحكام بسيطة على الواقع.
التحليل الفلسفي للروابط الإنسانية في المجتمع - إبراهيم أبو عواد
1
التحليلُ الفلسفي للروابط الإنسانية في المجتمع يُمثِّل اختبارًا وجوديًّا للعلاقات الاجتماعية ، وتفكيكًا لعناصر الموضوعات الفكرية التي تُسيطر على ماهيَّة الوَعْي الإنساني، وتشريحًا لِجُزَيئات العقل الجَمْعي الذي يُسيطر على المفاهيم السائدة في حياة الفرد ومسار الجماعة . وإذا كانَ التحليلُ الفلسفي صِفَةً مُمَيِّزَةً للمجتمعات الحَيَّة والحُرَّة ، فإنَّ الوَعْي الإنساني صِفَة مُمَيِّزَة للوجود الفردي والجماعي ضِمن الظواهر اللغوية والأنماط الثقافية. وثنائيةُ ( التحليل الفلسفي / الوَعْي الإنساني ) لَيست كُتلةً معنويةً جامدةً أوْ نَسَقًا نظريًّا بعيدًا عن التطبيقات الواقعية ، إنَّ هذه الثنائية تيَّار فكري قائم على تحقيقِ التوازن الاجتماعي بين المعايير الأخلاقية ومصادر المعرفة ، وتحقيقِ المُوازنة الثقافية بين الظواهر اللغوية والظواهر النَّفْسِيَّة . وهذا يُؤَدِّي إلى كشفِ دَور البُنية اللغوية في تكوين الجانب النَّفْسِيِّ للفرد ، وكشفِ دَور البناء النَّفْسِيِّ في تشكيل دَلالات اللغة وطاقتها الرمزية . ويقوم التحليلُ الفلسفي على فَحْص الماهيَّات الاجتماعية التي تتحكَّم بالسلوك ، وتُؤَوِّل الأحداثَ اليومية ، مِمَّا يَقُود إلى تجزئة المفاهيم اللغوية والبُنى الوظيفية ، وُصولًا إلى أنويتها الداخلية وعناصرها الأوَّلية ، بهدف تكوين فهم دقيق لحرية الإرادة ، وإيجاد تفسير عقلاني للمسؤولية الأخلاقية . والغايةُ من التحليل الفلسفي هي الوصول إلى كَينونة الوَعْي الإنساني ، وتحقيقه واقعًا ملموسًا ، وتفعيله معنويًّا في صَيرورةِ التاريخ ، وحتميةِ انبثاق المعنى الوجودي من الظواهر الثقافية ، مِن أجل تكوين رؤية حاضنة لأحلام الفرد وطُموحات الجماعة ، وقادرة على تكوين تقنيات إبداعية للنهوض بالمجتمع ، وحمايته مِن الأوهام اللذيذة التي تصير مُسلَّمات افتراضية بِحُكْم سياسة الأمر الواقع ، وحمايته أيضًا من العلاقاتِ الاجتماعية الاصطناعيَّة التي تَقُوم على المصلحة الآنِيَّة والمنفعة الزائلة ، بعيدًا عن الوَعْي بالماضي والشُّعور بالحاضر وإدراك المُستقبل .
جان بودريار ومجتمع الاستهلاك - د. زهير الخويلدي
"إذا لم يعد المجتمع الاستهلاكي ينتج الأسطورة، فذلك لأنه هو نفسه أسطورته الخاصة."
يُعد المجتمع الاستهلاكي لجان بودريار مساهمة أساسية في علم الاجتماع والفلسفة المعاصرين، على قدم المساواة مع تقسيم العمل من طرف دوركايم أو الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية عند ماكس فيبر.
"المجتمع الاستهلاكي" هو نوع المجتمع الذي يقوم فيه النظام الاقتصادي على الاستهلاك الشامل، وهو نوع المجتمع الذي تؤدي فيه الزيادة في الإنتاج إلى تكاثر المنتجات التي سيتم استهلاكها وبالتالي خلق احتياجات ورغبات جديدة. يستخدم مصطلح "المجتمع الاستهلاكي" للإشارة إلى مجتمع يتم فيه تشجيع المستهلكين على استهلاك السلع والخدمات بكثرة. ظهر في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي في أعمال الاقتصادي الأمريكي جون كينيث جالبريث (1908-2006) للإبلاغ عن ظهور انتقادات لطريقة الحياة الغربية. وفي كتابه "مجتمع الاستهلاكي" (1970)، يعتبر عالم الاجتماع الفرنسي جان بودريار أن الاستهلاك في المجتمعات الغربية هو عنصر هيكلي للعلاقات الاجتماعية. على مستوى الفرد، لم تعد وسيلة لتلبية الاحتياجات بل وسيلة للتمييز، والمجتمع الاستهلاكي ناتج عن الحاجة إلى النمو الاقتصادي الذي تولده الرأسمالية ونتيجتها الطبيعية، وهي تراكم رأس المال. يتطلب البحث عن إنتاج أكبر ومتنوع ومبتكر بسبب المنافسة، من أجل زيادة الأرباح، استهلاكًا أوسع وأسرع من أي وقت مضى.
مراجعات في فكر كارل ماركس - مصعب قاسم عزاوي
يتفق معظم البشر على أننا بحاجة إلى تحسين نظامنا الاقتصادي بطريقة أو بأخرى. إنه يهدد كوكبنا من خلال جائحة الاستهلاك المفرط، ويصرف انتباهنا بالإعلان غير ذي الصلة بحاجتنا الحقيقية، ويترك الكثير منا جائعين وبدون رعاية صحية، ويغذي الحروب العدمية التي لا جدوى منها. ومع ذلك، فإننا حريصون أيضاً في كثير من الأحيان على تجاهل أفكار الناقد الأكثر طموحاً وشهرة للنظم الاقتصادية الرأسمالية المؤوفة، وأعني هنا كارل ماركس، وهو الذي يتعين علينا أن نراه كدليل في تشخيصه لعلل الرأسمالية، والسعي في الانتقال إلى مستقبل أكثر عدالة بحق الفئات الضعيفة في المجتمع.
ولد كارل ماركس في عام 1818 في ترير، ألمانيا. كان ينحدر من سلسلة طويلة من الحاخامات اليهود، ولكن عائلته اعتنقت المسيحية عندما كان عمره 6 سنوات من أجل الاندماج مع المجتمع الألماني. درس في جامعة بون الفخمة والعريقة، و راكم ديوناً ضخمة خلال دراسته، وسُجن بسبب السُكْر وتعكير صفو السلام، ودخل في مبارزة بالسيوف كادت أن تودي بحياته. كما أراد أن يصبح ناقداً درامياً. وقد أرسل والد ماركس ابنه - الذي شعر بالإحباط من سيرته في جامعة بون - إلى جامعة برلين الأكثر جدية، حيث انضم إلى مجموعة من الفلاسفة المعروفين باسم شباب الهيجيليين، الذين كانوا متشككين للغاية في الاقتصاد والسياسة الحديثة.
تاريخ وفلسفة الطب بين العلاج والرعاية - ترجمة: د.زهير الخويلدي
الترجمة
" الحد الأدنى الذي يمكن للمرء أن يطلبه من الفلسفة هو ترك الطب في سلام، وبهذا المعنى... ليس على الفلسفة أن تفرض على الطب ميتافيزيقيا ولا أخلاقًا".
«يوجد اليوم اهتمام متجدد لا يمكن إنكاره بين الفلاسفة بالطب، وتتضاعف الكتب والمؤتمرات والمشاريع البحثية حول مسألة العلاقة بين الطب والفلسفة. قد يبدو أن هذا يبشر بالخير بقدر ما ألهم الطب ذات مرة تفكير فلاسفة مثل كانغيلام أو فوكو أو داجوجنيت. لكن يُخشى أن يكون الدافع وراء هذا الاهتمام في بعض الأحيان اليوم لأسباب سيئة، تلك التي ندد بها كانغيلام ، منذ أكثر من ستين عامًا ، في الطبيعي والمرضي ، عندما وضع قائمة الأسباب التي تجعل الفلاسفة مهتمين بالطب ، وكان الموقف الأول الذي يجب انتقاده ، وفقًا لكانغيلام ، هو موقف هؤلاء الفلاسفة الذين يدعون "تجديد الطب من خلال دمج الميتافيزيقيا فيه". يمكن للمرء أن يتساءل من وجهة النظر هذه عن المحاولات الأخيرة للترويج لـ "فلسفة الرعاية"، والتي يعارضها المرء لطب يعتبر تقنيًا للغاية، والذي تحول بعناد إلى "علاج" على حساب "الرعاية". إذا كانت الرعاية تستحق بالتأكيد أن تكون موضوعًا للتفكير، فليس من المؤكد أنه يجب بالتالي أن تتعارض مع "الطب العلمي"، الذي يعتبر غير إنساني للغاية. بالنسبة لنا، لا يستحضر الطب "ضعف" الإنسان الذي لا يمكن إنكاره فحسب، بل إنه أيضًا مثال، كما قال فوكو، لتقنية هي "الشكل المسلح، الإيجابي والمليء بمحدوديتها".
نحو مشروع كوسموبوليتي:محادثة بين النظرية والتطبيق حول الكوسموبوليتية بين شيلا بن حبيب ودانييل أرشيبوجي - ترجمة: د. زهير الخويلدي
"ساهمت شيلا بن حبيب ودانييلي أرشيبوجي في إحياء الروح الكونية في السنوات الأخيرة. شيلا بن حبيب أستاذة العلوم السياسية والفلسفة بجامعة ييل. مؤلفاته الأخيرة - حقوق الآخرين. الأجانب والمقيمون والمواطنون (مطبعة جامعة كامبريدج، 2004) وحركة كوسموبوليتية أخرى (مطبعة جامعة أكسفورد، 2006) – تقدم الحجج الفكرية لحماية الفئات الاجتماعية الأضعف (الأجانب والمهاجرين واللاجئين). من خلال تطوير وجهات النظر التي فتحتها حنة أرندت حول "الحق في التمتع بالحقوق"، تجادل بقوة بأنه لا يوجد رجل غير قانوني. أما دانييل أرشيبوجي فهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة لندن (كلية بيربيك) ومدير الأبحاث في المجلس القومي للبحوث في روما. تحت شعار "الديموقراطية الكوسموبوليتية"، دعا إلى إصلاح جذري للنظام الدولي. يتم عرض مشروعه الآن بالتفصيل في كتابه الكومنولث العالمي للمواطنين. نحو ديمقراطية عالمية (مطبعة جامعة برينستون، 2008) وفي مقال موجز بعنوان الديمقراطية العالمية. في الطريق إلى ديمقراطية كوسموبوليتية (لو سيرف، 2009). هكذا تقوم شيلا بن حبيب بشكل أساسي بتعبئة أدوات الفلسفة السياسية، بينما تقوم دانييل أرشيبوجي بتعبئة أدوات العلاقات الدولية. في هذا الحوار الذي أداره ماريانو كروس (أستاذ فلسفة القانون في جامعة روما)، نحاول استكشاف إلى أي مدى يمكن التفكير في إطار كوسموبوليتي مشترك.
الحوار الفلسفي والتفكير الإيجابي - د.زهير الخويلدي
مقدمة
الحوار (المكتوب أحيانًا) هو محادثة متبادلة بين كيانين أو أكثر. الأصول الاشتقاقية للكلمة (لوغوس ، كلمة ، كلام) هي مفاهيم مثل المعنى المتدفق ولا تنقل بالضرورة الطريقة التي جاء بها الناس لاستخدام الكلمة ، مما يؤدي إلى افتراض أن الحوار يكون بالضرورة بين طرفين فقط. الحوار كشكل من أشكال الاتصال له دلالة لفظية. بينما يمكن أن يكون التواصل تبادلًا للأفكار والمعلومات عن طريق الإشارات والسلوكيات غير اللفظية ، كما يشير أصل الكلمة ، فإن الحوار يعني استخدام اللغة. يتميز الحوار عن طرق الاتصال الأخرى مثل المناقشات والمناقشات. بينما تعتبر المناظرات تصادمية ، تؤكد الحوارات على الاستماع والفهم. طور مارتن بوبر فلسفته حول الطبيعة الحوارية للوجود البشري وطور آثارها في مجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك الوعي الديني ، والحداثة ، ومفهوم الشر ، والأخلاق ، والتعليم ، والروحانية ، والتفسير الكتابي. لأن الحوار بالنسبة للإنسان هو الشكل الأساسي للتواصل والتفاعل ، فقد استخدمت نصوص عديدة من العصور القديمة بنية الحوار كشكل أدبي. استخدمت النصوص الدينية مثل الكتاب المقدس ، والسوترا البوذية ، والنصوص الكونفوشيوسية والأدب المعاصر شكل الحوار. في الفلسفة ، غالبًا ما يكون استخدام أفلاطون للحوار في كتاباته هو الأكثر شهرة.
مراجعات في فكر جان جاك روسو - مصعب قاسم عزاوي
تتمحور الحياة المعاصرة حول فكرة التقدم، والتي تعني أننا كلما كنا نعرف أكثر، ولا سيما حول العلوم والتكنولوجيا، وبينما تنمو الاقتصادات بشكل أكبر، فنحن سائرون في درب سوف يقود في نهاية المطاف لأن نصبح أكثر سعادة. وفي القرن الثامن عشر على وجه الخصوص، عندما أصبحت المجتمعات الأوروبية واقتصاداتها معقدة بشكل متزايد، كانت وجهة النظر التقليدية هي أن الجنس البشري وُضع بحزم على مسار إيجابي، مبتعداً عن الوحشية والجهل نحو الازدهار والكياسة والتحضر. ولكن كان هناك فيلسوف واحد على الأقل من القرن الثامن عشر على استعداد للتشكيك بقوة في "فكرة التقدم"، كان لديه أفكار جوهرية للغاية ليقولها لأبناء عصره وعصرنا الراهن.
ولد جان جاك روسو - ابن إسحاق روسو - وهو صانع ساعات متعلم، في جنيف في عام 1712. وتقريباً على الفور، عانى روسو من أول ما أطلق عليه لاحقاً "مصائبه"، إذ بعد تسعة أيام فقط من الولادة، توفيت والدته سوزان برنارد من المضاعفات التي نشأت بسبب مخاض الولادة المؤلم والمعقد. وعندما كان روسو في العاشرة من عمره، دخل والده في نزاع قانوني وأجبرت الأسرة على الفرار إلى مدينة برن حيث تزوج إسحق في وقت لاحق للمرة الثانية. ومنذ ذلك الحين، تميزت حياة روسو بعدم الاستقرار والعزلة. طوال سنوات المراهقة وسن البلوغ، كان قد غيّر المنازل بشكل متكرر، أحياناً بحثاً عن الحب والاستحسان، وفي بعض الأحيان للهروب من الاضطهاد فحسب.
نحو إنسانية مسلعنة - أحمد العكيدي
في كتابه الشهير "أن تملك أو أن تكون ((to have or to be"، خلص إريك فروم في تحليله للمجتمعات الصناعية إلى أن الإنسان بات تحت رحمة قوانين العرض والطلب، وبالتالي أصبح يُمارس حياته ويُخضع قيًمه كإنسان لقوانين السوق كأية سلعة لها قيمة سوقية تقاس بالعملات أو ما يعادلها. رغم أن الكتاب يتناول سلوك الإنسان الأوربي في الدول الصناعية، قبل تاريخ صدوره في النصف الثاني من القرن العشرين، غير أن مخرجاته ما تزال صامدة وربما تعززت أكتر في وقتنا الحاضر، حيت أصبحت قيم السوق أهم المعايير التي تؤطر علاقاتنا الإنسانية.
مفهوم العمل من القيود الى الحرية – د.زهير الخويلدي
"ليس هناك عقاب أخطر من العمل غير المجدي واليائس."
ألبرت كامو،"أسطورة سيزيف"، غاليمار ، 1942
لا شك أن فكرة العمل مرتبطة بالشجاعة. لكي تعمل، عليك أن تكون شجاعًا، والقيود التي يتعين عليك الخضوع لها لا تساوي إلا الجدارة التي تكتسبها في مواجهة التحدي. لكن، عند الفحص الدقيق، أليس من الصعب عدم فعل أي شيء عندما يكون كل شيء محمومًا، لتحمل التقاعس عن العمل في عالم محكوم عليه بالتغير وانعدام الأمن الوظيفي؟ أليس الخوف من فقدان المكانة، وظيفة المرء في المجتمع، يحجبه عار عدم وجوده؟ هل لا يزال بإمكاننا تعريف الإنسان على أنه عامل حيواني عندما تميل البنى الاجتماعية والاقتصادية التي شهدت ولادة هذا "النوع الجديد" إلى الاختفاء؟
فلسفة مبسطة: فلسفة القانون - نبيل عودة
تتخصص فلسفة القانون ببحث ودراسة مضمون القوانين. نجد تعددا في النظريات والآراء والتحاليل والاستنتاجات. من ابرز النظريات نظرية يطلق عليها اسم "القانون الأخلاقي"، ربما هذا التعبير " الأخلاقي" سيثير امتعاضا لدى الكثيرين الذين لم يجدوا أي أخلاق بالقوانين حين تصرفوا لحماية مصالحهم، لكن القانون وجدهم مخالفين لبنوده، من هنا انتشر قول مشهور ان القوانين أحيانا كثيرة تتناقض مع المنطق البسيط للمواطن. البعض يقول ما هو أكثر تطرفا، لا منطق في القانون. القوة إلى جانب القوي ماديا، أو الذي يملك مستندات ما رغم أنها لا تقول الحقيقة. لذلك مفهوم "القانون الأخلاقي" هو مفهوم نسبي أيضا. أي لا توجد صيغة قانونية أخلاقية مطلقة.
إذن كيف نقيم أخلاقية القوانين؟
هذا الموضوع مثل غيره شغل الفلاسفة أيضا، منذ فجر الفلسفة، أي منذ ظهور الفلسفة الإغريقية، وكان الفيلسوف العظيم أرسطو هو أول من طرح مفهوم "القانون الأخلاقي" من فهمه الفلسفي بأن هدف القوانين هو مساعدة الدول الجيدة على التطور. بالطبع التطور يحتاج إلى تنظيم العلاقات بين السلطة والمواطنين من جهة، وبين المواطنين أنفسهم من جهة أخرى.