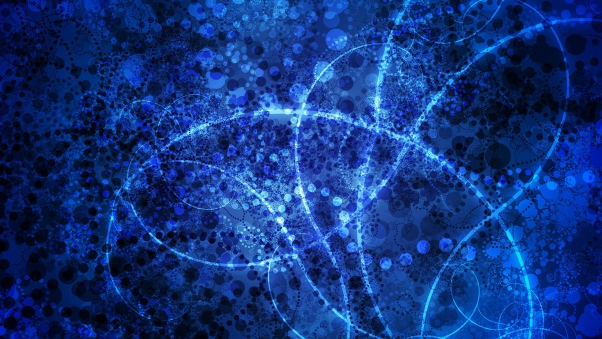 مدخل:
مدخل:
احتلت القضايا الجنائية جزء كبيرا من انشغال العديد من وسائل الإعلام، سواء تلك التي تنشر في التلفاز أو الصحافة أو الإنترنت، باعتبارها أكثر القضايا حساسية والمتمثلة في انعدام الأمن، إذ من شأنها أن تساهم في تنامي بعض الظواهر النفسية ولو بشكل مضطرد، لتثير بالتالي اهتمام الباحثين خاصة علماء النفس، وذلك للخوض في البحث والتفسير تحت لواء علم النفس الإجرامي، هذا الأخير الذي يعتبر حديثا نسبيا مقارنة بباقي العلوم.
وبالتالي فتفسير الظواهر التي يدرسها هذا العلم، تنبع انطلاقا من طبيعة الجريمة بحد ذاتها من حيث أسسها النفسية والاجتماعية والبيولوجية، إذ يصعب أحيانا إعطاء تفسير جنائي لجميع حالات الجنوح، فتكون بالتالي مجحفة في حق الحالات السايكوباتية المرضية، لذا ركز علم النفس الإجرامي على فهم الظواهر العلمية أولا، ثم بمعاملة الأفراد المتورطين في الجرائم ثانيا.فبرزت بالضرورة عدة أسئلة عن أسباب الجريمة وأفضل طرق تحديدها، ومن هم أبرز من ناقشوها وكتبوا في شأنها، وعن الكيف والحالة التي يصبح فيها الشخص جانحا، وهل هم في انخفاض أم في تزايد مستمر، وعن الكيفية التي يتداخل فيها ما هو نفسي وما هو اجتماعي وقضائي في تحليل الظاهرة؟، كل هذه أسئلة كثيرة وفضفاضة تسعى الكاتبة إلى تحليلها ومناقشتها في هذا الكتاب، آملة فيه أن يجد القارئ إجابات شافية لهذه المشكلة القديمة الجديدة.
الثابت والمتغير في الدين والحياة ـ د. مخلص السبتي
 في بحثهم عن الثوابت الراسخة الحامية من الانجراف ، كثيرا ما يلجأ الشباب إلى متغيرات يحسبونها ثوابت ....وما هي عند التحقيق بذلك ، بل كثيرا ما تكون مجرد حلول لمشاكل لم تعد قائمة ، وإجابات عن أسئلة لم تعد مطروحة ، وإجراءات تخص تحديات واقع قد ولى ...يحمل كل ذلك على أنه دين وما هو بالدين ، أو مقدس وما هو بالمقدس ، وآثار ذلك على الثقافة والسياسة والاقتصاد ...وخيمة ، فذلك فضلا عن كونه من أهم كوابح التطور ، هو أيضا من أكبر معيقات التوافق الاجتماعي ، وأنى للناس أن يتوافقوا على شيء يرونه - حقا أو توهما - يمس ثوابتهم .
في بحثهم عن الثوابت الراسخة الحامية من الانجراف ، كثيرا ما يلجأ الشباب إلى متغيرات يحسبونها ثوابت ....وما هي عند التحقيق بذلك ، بل كثيرا ما تكون مجرد حلول لمشاكل لم تعد قائمة ، وإجابات عن أسئلة لم تعد مطروحة ، وإجراءات تخص تحديات واقع قد ولى ...يحمل كل ذلك على أنه دين وما هو بالدين ، أو مقدس وما هو بالمقدس ، وآثار ذلك على الثقافة والسياسة والاقتصاد ...وخيمة ، فذلك فضلا عن كونه من أهم كوابح التطور ، هو أيضا من أكبر معيقات التوافق الاجتماعي ، وأنى للناس أن يتوافقوا على شيء يرونه - حقا أو توهما - يمس ثوابتهم .
في هذا المقال سوف ندخل إلى الجزء الذي يتهيب الكثير دخوله ، هو شديد الصعوبة لأنه يتناول أفهام الناس عن ثوابتهم ، وكثيرا ما أحالت الأفهام على أوهام ، والناس في ذلك معذورون ، فكثيرا ما التبست الأوهام بالحقائق فاستعارت زيها وتغطت بردائها ، ولبست على الناس ، فإذا هم في خوض يلعبون ويحسبون أنهم مهتدون.
من أجل مرصد وطني مـدنـي للعمل الجمعوي بالمغرب ـ إبراهيم منتيس
 '' تتحدث المعارضات عن تغيير السلطة و لا شيء عن تغيير المجتمع '' أدونيس
'' تتحدث المعارضات عن تغيير السلطة و لا شيء عن تغيير المجتمع '' أدونيس
من بين المقاييس التي أضحى يقاس على أساسها مستوى تنمية الدول و المجتمعات في عالم اليوم، قياس مدى اتساع مجال المشاركة المجتمعية الفعالة في مختلف المجالات، الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية... ،التي تسمح لعموم المواطنين و المواطنات بالمشاركة في تشخيص المشاكل و إبداع الحلول و وضع السياسات و الرؤىو التخطيط للتنمية و تفعيل المشاريع التنموية و تتبعها و تقييمها. وفقا لهذا المقياس و من هذا المنظور يمكن القول، بقدر ما تتسع المشاركة الفعالة أمام عموم الفئات الاجتماعية و خاصة الفئات المقصية و المهمشة ، بقدر ما تترسخ و تتعمق قيم التضامن و المواطنة و الديمقراطية و بنفس القدر يتم تسريع وتيرة تحقيق التنمية الشاملة و تقاسم ثمراتها.
على هذا الأساس، أصبحت التنظيمات غير الحكومية عامة و الجمعيات على وجه الخصوص، داخل المجتمعات تمثل أداة متباينة القوة لتفعيل المشاركة المواطنة . كما أصبح مستوى نضج و فعالية النسيج الجمعوي، وفق تعبير فوزي بوخريص ، محدداً أساسياً يقاس به مستوى قدرة المجتمعات على التطور و البناء الديمقراطي ،ذلك أن قدرة أي مجتمع على " النمو و على التطور و على الابتكار تظل مرتبطة بقدرته على بناء أكبر ما يمكن من المجالات المتخصصة و التي تكون قريبة من المواطنين و بعيدة عن تحكم الدولة .. و الفاعلين الحكوميين "[1] ( فوزي بورخيص: سوسيولوجيا العمل الجمعوي بالمغرب : ملاحظات أولية)
المجتمع المتفكك والمجتمع الكلياني : من التكوين الميكانيكي إلى التكوين العضوي ـ دراسة مبسَّطة في خصائص الاجتماع العربي ـ إبراهيم النفره
 مقدمة:
مقدمة:
يبدو الحديث عن دراسة للمجتمع العربي حديثاً تقليدياً من حيث الشكل, لكن في ظل الأحداث التي تمر بها المجتمعات العربية أصبحت عملية تفكيك البنى الاجتماعية ودراسة عناصرها أمراً غاية في الأهمية تستدعيها المعطيات والنتائج التي أفرزتها المرحلة الأخيرة في تاريخ المجتمعات العربية (إن صحَّ الجمع). هذه الدراسة المبسطة ستقدم مدخلاً جديداً لدراسة بنية الاجتماع العربي, إنطلاقاً من تحليل العناصر الأساسية المكوِّنة لهذه المجتمعات وتحديد الأطر النظرية لميكانيزمات الحراك الاجتماعي فيها, مبنيةً على أسس انثروبولوجية.
لدراسة أي مجتمع لابدَّ في البداية من دراسة العنصر الأهم في تكوينه, نقصد هنا "الفرد/ الإنسان العربي". لذا فإننا سننطلق من أسسٍ انثروبولوجية للوصول إلى الغاية المنشودة.
- ميكانيزمات الفعل الإنساني في المجتمع ونقد خطاب الحداثة:
يتحدد حراك الأفراد في المجتمع بناءً على خصائص تسم الطبيعة البشرية. بتعبيرٍ آخر, إنَّ ما يحدِّد حراك الفرد في المجتمع هو "الرغبة". الشكل الأول من أشكال الرغبة هذه هو الرغبة في الوجود الإنساني (الكينونة) كفرد متفرد بذاته ولذاته يتميز عن أقرانه في المجتمع بجملة من الصفات التي ترتبط بالبنية الفيزيولوجية والسيكولوجية للفرد تطبع تحركاته في المحيط الاجتماعي بطابعٍ يميّزهُ عن الآخرين, ويعمل الفرد من خلال تفاعله مع الجماعات الاجتماعية المحيطة به على إثبات وإبراز هذا التفرد. أما الشكل الثاني من أشكال الرغبة فهو الرغبة في الكينونة مع الآخر, أي الوجود من خلال اعتراف الآخر بهذا الفرد ككائن فاعل وذو دور عضوي في المجتمع, هذا النوع الآخر من الرغبة لا يمكن تحقيقه دون عملية إندماج اجتماعي فعَّالة, تعمل على تحقيقها البنى المؤسسية والقانونية والبنى الثقافية في المجتمع, فإما أن تكون عاملاً في إنطلاق أفراده أو عاملاً في تقيد حركتهم والحد منها.
تاريخ الإباحية : السلطة تحتكر الجنس ـ حمودة إسماعيلي
 لم تعترض الحضارات السابقة عن الجنس الإباحي، طالما أنه يدخل ضمن الطقوس الدينية، ويمارَس بالأعياد والإحتفالات السنوية. لكن بنشوء الإمبراطورية الرومانية ستتغير الرؤية للجنس بتغير السياسة التشريعية، يتطرق "باسكال كينيار" لتوضيح هذه النقطة، بقوله : "لم يُكدِّر علاقات الإغريق القدماء الجنسية، أياً كانت طبيعتُها، أو يشُبها أيّ أثرٍ لخطيئة أو حتى إحساس بالذنب، بينما حكمها في روما الذعر الذي تفرضه قواعد المراتب الاجتماعية. لم يكن التزمت الطهراني شيئا يتعلق بالجنسانية قط بل بالفحولة (لم يكن مسموحا للرجل اليوناني بأن يطأه ذكرا، ومسموح له بوطء الغلمان/الولدان). فالقيام بفعل الحب (كان) مُفضّل دوما على الامتناع عنه، لكن قيمته مرتبطة كلياً بمرتبة الموضوع الذي يُشبعه (مكانة الشريك الاجتماعية)". أما بالانتقال للحضارة الرومانية، فإن "الإباحية" حُصِرت ب"النفوذ"، ف"بوسع كل مواطن فعل ما يريد بامرأة غير متزوجة، أو خليلة، أو مُعتَّق، أو عبد" (باسكال كينيار)، وذلك لأن هذه الشخصيات تأتي بأدنى السلم الاجتماعي، مايجعلها خاضعة لنفوذ المواطن؛ ولا يحق للعبد أن يطأ سيده لأن هذا اعتُبر من "المحظور الأكبر"، أما الأعراف فهي "أن يلوط السيد عبده، يمد السيد أصبعه قائلا : te paedico (ألوطك) أو te irrumo (أملأ فمك بقضيبي)"، ولم يكن يحق للعبد الاعتراض لأن هذا يدخل ضمن الواجب نحو سيده. ومنه نرى كيف صارت الإباحية، ممارسة نفوذ مسموحة نحو من يمثلون الخضوع بالمجتمع، وممنوعة (كجريمة) إذا قام الخاضعون بالممارسات التي تشترط "نفوذ"، على "ذوي النفوذ" والمراتب الاجتماعية العليا؛ لأن "النموذج الوحيد للجنسانية الرومانية هو السيادة التي يمارسها السيد dominus على كل أحد آخر، والاغتصاب الذي يمارسه في الأوساط الأدنى مرتبة، هو العُرْف. أن تستمتع دون وضع قوّتك في خدمة الآخر شيء موجب للاحترام"، لأن "كل استمتاع وُضِع في خدمة الآخر منحط، وهو من جانب الرجل دلالة على نقص الفضيلة، نقص الفحولة، أي دلالة على العجز" (باسكال كينيار).
لم تعترض الحضارات السابقة عن الجنس الإباحي، طالما أنه يدخل ضمن الطقوس الدينية، ويمارَس بالأعياد والإحتفالات السنوية. لكن بنشوء الإمبراطورية الرومانية ستتغير الرؤية للجنس بتغير السياسة التشريعية، يتطرق "باسكال كينيار" لتوضيح هذه النقطة، بقوله : "لم يُكدِّر علاقات الإغريق القدماء الجنسية، أياً كانت طبيعتُها، أو يشُبها أيّ أثرٍ لخطيئة أو حتى إحساس بالذنب، بينما حكمها في روما الذعر الذي تفرضه قواعد المراتب الاجتماعية. لم يكن التزمت الطهراني شيئا يتعلق بالجنسانية قط بل بالفحولة (لم يكن مسموحا للرجل اليوناني بأن يطأه ذكرا، ومسموح له بوطء الغلمان/الولدان). فالقيام بفعل الحب (كان) مُفضّل دوما على الامتناع عنه، لكن قيمته مرتبطة كلياً بمرتبة الموضوع الذي يُشبعه (مكانة الشريك الاجتماعية)". أما بالانتقال للحضارة الرومانية، فإن "الإباحية" حُصِرت ب"النفوذ"، ف"بوسع كل مواطن فعل ما يريد بامرأة غير متزوجة، أو خليلة، أو مُعتَّق، أو عبد" (باسكال كينيار)، وذلك لأن هذه الشخصيات تأتي بأدنى السلم الاجتماعي، مايجعلها خاضعة لنفوذ المواطن؛ ولا يحق للعبد أن يطأ سيده لأن هذا اعتُبر من "المحظور الأكبر"، أما الأعراف فهي "أن يلوط السيد عبده، يمد السيد أصبعه قائلا : te paedico (ألوطك) أو te irrumo (أملأ فمك بقضيبي)"، ولم يكن يحق للعبد الاعتراض لأن هذا يدخل ضمن الواجب نحو سيده. ومنه نرى كيف صارت الإباحية، ممارسة نفوذ مسموحة نحو من يمثلون الخضوع بالمجتمع، وممنوعة (كجريمة) إذا قام الخاضعون بالممارسات التي تشترط "نفوذ"، على "ذوي النفوذ" والمراتب الاجتماعية العليا؛ لأن "النموذج الوحيد للجنسانية الرومانية هو السيادة التي يمارسها السيد dominus على كل أحد آخر، والاغتصاب الذي يمارسه في الأوساط الأدنى مرتبة، هو العُرْف. أن تستمتع دون وضع قوّتك في خدمة الآخر شيء موجب للاحترام"، لأن "كل استمتاع وُضِع في خدمة الآخر منحط، وهو من جانب الرجل دلالة على نقص الفضيلة، نقص الفحولة، أي دلالة على العجز" (باسكال كينيار).
رهانات واكراهات العمل الجمعوي بالمغرب ـ حسن اشرواو
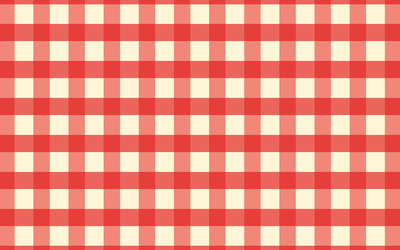 يحظى العمل الجمعوي بالمغرب بأهمية قصوى، خاصة وأنه يؤدي أدوارا ومهاما لا تقل أهمية عن تلك الأدوار الخاصة بالدولة، لدرجة أن الخطاب السياسي المغربي الراهن يجعل من هذا الفاعل، أبرز الفاعلين المشاركين في تحقيق أهداف التنمية التي طالما ينشدها المجتمع المغربي، ويتضح هذا الأمر بشكل كبير في تلك الصلاحيات الدستورية التي أصبح يتمتع المجتمع المدني بشكل عام، والفاعل الجمعوي بشكل خاص، مع مطلع الدستور الجديدة لسنة 2011. ونهدف من خلال هذا المقال إلى الكشف من جهة عن الانتظارات والرهانات الفوقية المعلقة على عاتق الفاعل الجمعوي، ومن جهة ثانية سنعمل على الوقوف أمام إكراهات البنية التحتية للعمل الجمعوي.
يحظى العمل الجمعوي بالمغرب بأهمية قصوى، خاصة وأنه يؤدي أدوارا ومهاما لا تقل أهمية عن تلك الأدوار الخاصة بالدولة، لدرجة أن الخطاب السياسي المغربي الراهن يجعل من هذا الفاعل، أبرز الفاعلين المشاركين في تحقيق أهداف التنمية التي طالما ينشدها المجتمع المغربي، ويتضح هذا الأمر بشكل كبير في تلك الصلاحيات الدستورية التي أصبح يتمتع المجتمع المدني بشكل عام، والفاعل الجمعوي بشكل خاص، مع مطلع الدستور الجديدة لسنة 2011. ونهدف من خلال هذا المقال إلى الكشف من جهة عن الانتظارات والرهانات الفوقية المعلقة على عاتق الفاعل الجمعوي، ومن جهة ثانية سنعمل على الوقوف أمام إكراهات البنية التحتية للعمل الجمعوي.
يقر الدستور الجديد لسنة 2011 في أغلب فصوله بمبدأ الديمقراطية التشاركية، ويكرس هذا المبدأ بشكل واضح ودقيق في تلك الفصول الخاصة بالمجتمع المدني. فقد جاء في الفصل 12 أنه بإمكان الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، أن تساهم في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا تفعيلها وتقييمها، وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة طبق شروط وكيفيات يحددها القانون. أما الفصل 29 فيذهب إلى بالحق في حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي. كما نجد كذلك أن الدستور كرس في الفصول الخاصة بالحريات العامة جملة الحريات والحقوق الموازية والمرافقة والضرورية لاشتغال المجتمع المدني والفاعل الجمعوي، وأبرزها الفصل 25 و27 و29 و33 التي تنص على التوالي على حرية الفكر والرأي والتعبير، وحق الحصول على المعلومة وحرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتكريس مشاركة الشباب.
التقنية المعلوماتية ـ الأنترنيت ـ و آثارها على شخصية المراهق ـ السهلي ابراهيم
 يعد الإنسان المعاصر إنسانا ذا بعد تقني خالص ، فقد شكلت التقنية المعاصرة جوهر حياة الإنسان وطبعت وجوده الخاص وكينونته ، فقد تغلغلت في مختلف جوانب حياته ، فلم تعد هناك مسافة بين الإنسان و التقنية بل أصبح هناك تطابق وتماهي بينهما لدرجة يمكن القول معها إن الذات الإنسانية انصهرت في التقنية ذاتها ، فلم يعد بمقدور الفرد الخروج عن دائرتها و نمط اشتغالها بل أصبح عاجزا، إنه مقيد يطأ تحت رحمتها لدرجة وصف ذاته بمستلب الذات و الهوية .
يعد الإنسان المعاصر إنسانا ذا بعد تقني خالص ، فقد شكلت التقنية المعاصرة جوهر حياة الإنسان وطبعت وجوده الخاص وكينونته ، فقد تغلغلت في مختلف جوانب حياته ، فلم تعد هناك مسافة بين الإنسان و التقنية بل أصبح هناك تطابق وتماهي بينهما لدرجة يمكن القول معها إن الذات الإنسانية انصهرت في التقنية ذاتها ، فلم يعد بمقدور الفرد الخروج عن دائرتها و نمط اشتغالها بل أصبح عاجزا، إنه مقيد يطأ تحت رحمتها لدرجة وصف ذاته بمستلب الذات و الهوية .
إن علاقة الإنسان بالتقنية علاقة تداخل تاريخي طبعت الوجود الإنساني ، فقد ارتبط ظهورها وتطورها تاريخيا بالإنسان حتى أضحت علاقة الإنسان بالتقنية علاقة أنطولوجية ترابطية فيما بينهما ، تحولت في مرحلة تاريخية إلى صراع غير متكافئ بينهما انهزم من خلالها الإنسان في معركة الوجود . فبالعودة تاريخيا إلى الماضي يظهر أن الإنسان لوحده عاجز عن تحقيق متطلباته أضف إلى ذلك الصراع غير المتكافئ مع الطبيعة التي كانت تهدد وجوده و بقاءه مما اضطر إلى ابتكار التقنية و تسخيرها لصالحه ، فبواسطتها انتصر الإنسان على الطبيعة و سخر التقنية كقوة إنسانية لقهر قوة الطبيعة و استغلالها لصالحه ، [ روني ديكارت ، مقالة في الطريق ] غير أن تاريخ التقنية إذا تأملنا فيه يعكس لنا أنه في مرحلة تاريخية معينة فقد الإنسان السيطرة على التقنية ، فانقلبت موازين الصراع بين الإخوة الأعداء من مبدع لتقنية وفاعل في وجودها إلى عبد خاضع لها ، فالتطور الهائل الذي عرفته يرجع إلى فاعلية الإنسان الفكرية ، ورغبته الجامحة في امتلاك والسيطرة على الكون و الطبيعة بل أكثر من ذلك السيطرة على أبناء جنسه البشر ذاته غير أن الإنسان فقد السيطرة على التقنية و قوتها التي أصبحت تفوق قوة الإنسان حتى أصبح ينظر إليها بمثابة التنين الميتافيزيقي الذي يفوقه قوة و قدرة و يستحيل إجباره و إخضاعه و السيطرة عليه .
بعض مظاهر التحول في المجتمع المغربي المعاصر ـ عزالدين الحجاجي
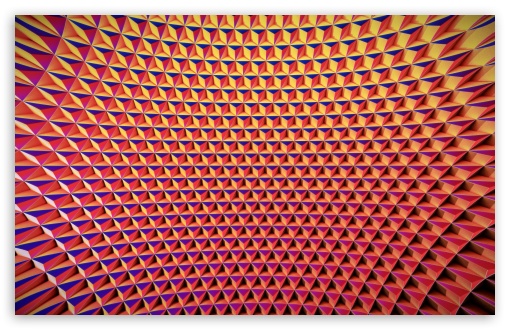 يعرف المجتمع العالمي بشكل عام، و المجتمعات النامية بشكل خاص مجموعة من التغييرات في بنياتها الاقتصادية والاجتماعية، سياسية، ثقافية ، هذا التغيير الذي يمكن رصده و ملاحظته من خلال ما يعرفه مفهوم المؤسسات من تغيير في بنياتها و كذلك من خلال طرق التنظيم والتسيير، الهادفة بالدرجة الاولى الى وضع نماذج ضابطة للمجتمع، وفق ما يسمى بالعقد الاجتماعي حسب روسو، تماشيا وطبيعة المجتمع والعلاقات الاجتماعية السائدة والمسيطرة فيه على مر تاريخه.
يعرف المجتمع العالمي بشكل عام، و المجتمعات النامية بشكل خاص مجموعة من التغييرات في بنياتها الاقتصادية والاجتماعية، سياسية، ثقافية ، هذا التغيير الذي يمكن رصده و ملاحظته من خلال ما يعرفه مفهوم المؤسسات من تغيير في بنياتها و كذلك من خلال طرق التنظيم والتسيير، الهادفة بالدرجة الاولى الى وضع نماذج ضابطة للمجتمع، وفق ما يسمى بالعقد الاجتماعي حسب روسو، تماشيا وطبيعة المجتمع والعلاقات الاجتماعية السائدة والمسيطرة فيه على مر تاريخه.
لا يمكن بأي حال من الأحوال التعرض لإحدى الموضوعات أو الظواهر التي لها علاقة من قريب او بعيد بالعلوم الاجتماعية والإنسانية، دون التركيز على المفاهيم التي لها بعد ابستمولوجي مهم ان لم نقل انه يتعذر وجود هذه العلوم دون انو جاد المفاهيم، لذلك رأنا انه من الاساسي والضروري التعريف ببعض المفاهيم التي سنتناولها بالتحليل في علاقاتها مع التحولات التي مست مؤسسة العائلة في بداية هذا المقال .
1- مفهوم التغيير
مفهوم التغيير مخالف للتغير فالأول يحتاج الى أداة مادية من اجل وقعنته على الواقع الاجتماعي بشكل ملموس على سبيل المثال حزب سياسي ، جمعية ، حركة اجتماعية على شاكلة الانتفاضات العربية سنة 2011 ، اما التغير فهو ناتج عن حركة الطبيعة، حيث إنه قانون يسري داخل الطبيعة و المجتمع خارج عن أي إرادة إنسانية ( فبلوغ الماء درجة معينة يتغير ويتحول الى عنصر أخر، وهذه العملية هي قانون لا يمكن التدخل فيه او تغييره وسيظل كذلك. والتغيرات الكيفية او ما يسمى بقانون نفي النفي يعتمل بأسمى تجلياته في النبتة التي تتحول في سيرورة تطورها من بدرة الى نبتة ناضجة، تخضع لتغير في شكلها وجوهرها نظرا لعوامل الداخلية والخارجية، هذه النبتة التي غالبا ما تكون مختلفة عن التركيب السابق للبدرة السابقة. ونجد ان من بين المقاربات التي أعطت أهمية كبيرة لمفهوم التغير والتغير هي المقاربة الماركسية، حيث اهتمت بمفهوم التغيرات بشكل كبير خاصة من خلال قوانين المنهج المادي الجدلي، فهي تقدمه على اعتبار انه نتاج انتقال من حالة الى حالة مناقضة حيث التغيرات تحدث كنتاج للتناقضات التي توجد في المجتمع[1]












