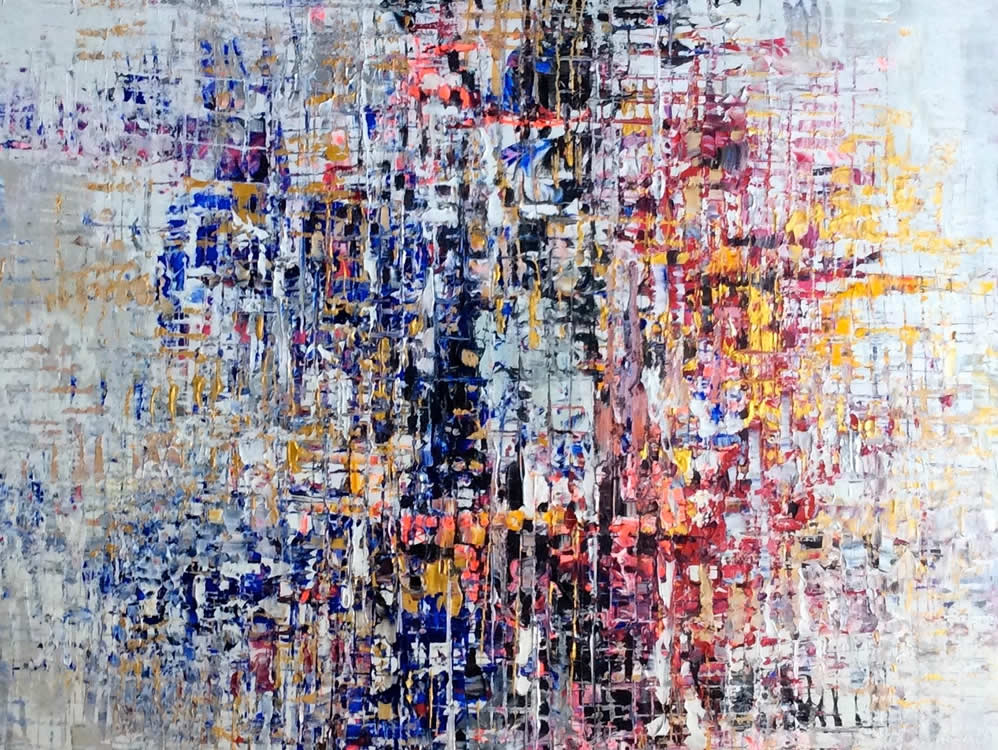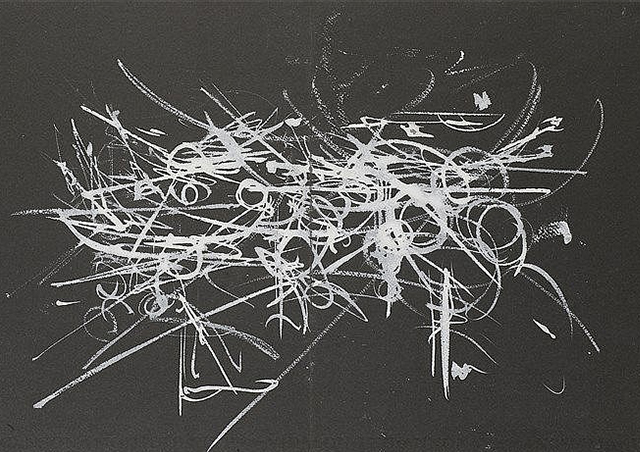الغايةُ مِن تحليل الأنساق الاجتماعية هي تفسير مصادر المعرفة ، التي تكتشف تاريخَ الوَعْي الإنساني ، وتُحِيله إلى علاقات وجودية منطقية قائمة على منظومة التَّأسيس والتَّوليد ، تأسيس قواعد المنهج الاجتماعي ، وتوليد أنساق إبداعية تُوازن بين الشكل والمضمون . والأنساقُ الاجتماعية لَيست كُتلةً جامدةً ، أو وِعاءً فلسفيًّا لتجميع الأحداث التاريخية، وإنما هي حَيَوَات مُتكاثرة ومُكثَّفة في بُؤرة إنسانية مركزية شديدة العُمق . وهذه البُؤرة كَبِئر الماء ، إذا أردنا معرفةَ عُمقها ، ينبغي أن نُلقيَ حجرًا فيها ، وننتظر ارتطامه بالماء ، والوقتُ الذي يستغرقه الحَجَرُ في الوصول إلى القاع ، يُظهِر عُمْقَ البِئر . ومركزيةُ الحَجَر في بِئر الماء ، تُشبِه مركزية المعنى الاجتماعي في البؤرة الإنسانية .
"هوس عربي معاصر".. لماذا يُصدِّق الناس الأبراج النجمية الآن أكثر من أي وقت مضى؟! - شادي عبد الحافظ
بشكل أسبوعي، تنشر جاكلين عقيقي، وهي مقدمة برامج في قناة السومرية العراقية تعرف نفسها بوصفها "عالمة فلك"، تنبؤاتها لكل الأبراج في الجوانب المهنية والعاطفية والصحية على صفحتها الخاصة بمنصة فيسبوك التي تضم نحو 1.47 مليون متابع، عادة ما تحصل منشورات عقيقي العادية على أربعمئة أو خمسمئة إعجاب، لكن منشورها الأسبوعي عن الأبراج تحديدا يتلقى أكثر من أربعة إلى خمسة أضعاف هذا الرقم من الإعجابات.
أما على يوتيوب فإن حلقة توقعات عقيقي لأهم أحداث العام الفائت، التي قدّمتها على مدى أكثر من ساعة وربع، شوهدت أكثر من 2.7 مليون مرة، وهذه ليست حالة خاصة على أية حال، فكل عام تُشاهَد حلقة تنبؤات الأبراج والتاروت، التي يُقدِّمها الإعلامي المصري عمرو أديب، أكثر من مليون مرة، وتعمل برامج في كل القنوات التلفزيونية المصرية تقريبا على استضافة "خبير أبراج" ليحكي لنا عما سنراه من أحداث خلال 12 شهرا قادمة.
الاختراع والاكتشاف في حياة الإنسان الاجتماعية - إبراهيم أبو عواد
1
الأسئلةُ المطروحة على الأنساق الاجتماعية لا تهدف إلى إيجاد تفسير عقلاني لحركة الأفراد من أجل تقييدها لصالح السُّلطات الأبوية ، وإنما تهدف إلى بَلورة وَعْي اجتماعي يُحرِّر العقلَ مِن ثقافة القطيع ، ويُحرِّر طريقةَ التفكير مِن ضَغط المُسلَّمات المصنوعة لتحقيق مصالح شخصية . وهذا يعني أن الغاية مِن عملية العَقلنة هي تحرير العقل مِن سُلطة العناصر الاجتماعية الضاغطة المُحيطة به ، وليس تَدجين العقل وإخضاعه لإفرازات العقل الجمعي . ولَن يَقْدِر العقلُ على الانطلاق نَحْو الإبداع إلا بكسر القيود ، والتخلص مِنها ، وليس تنظيفها وإزالة الصَّدَأ عنها ، فالتَّحَرُّر والحُريةُ يَعْنِيان كَسْرَ القيود على العقل لا تَلْميعها . وإذا تحرَّرَ العقلُ الفردي فإنَّ العقل الجمعي سيتحرَّر تلقائيًّا ، وإذا تحرَّرَ العقلُ الجمعي ، فإنَّ الأنساق الاجتماعية ستُصبح حاضنةً شرعية للإبداع والإنتاجِ المعرفي .
الموضوع الاجتماعي والذات الإنسانية - إبراهيم أبو عواد
1
العلاقة المصيرية بين الموضوع الاجتماعي والذات الإنسانية هي الأساس العقلاني لتفسير أنماط السيطرة الفكرية في المجتمع . والموضوعُ الاجتماعي هو الحَيِّزُ المعرفي الموجود في الواقع ، والخاضعُ للأحاسيس اليومية والتجارب العملية . والذاتُ الإنسانية هي جَوهر الإنسان ، وشخصيته الاعتبارية ، وهُويته الوجودية . وفي ظِل الحركة الاجتماعية المُستمرة أفقيًّا وعموديًّا في التاريخ والجُغرافيا ، يتكرَّس الموضوع كإطار خارجي ، يحتوي على إفرازات العقل الجمعي ، ويُحقِّق الاستقلاليةَ عن الإرادة والوَعْي ، ويُحقِّق التوازنَ بينهما . وفي ظِل الصراع المُستمر الذي يعيشه الإنسانُ داخل نَفْسه وخارجها ، تتكرَّس الذات كَنَوَاة مركزية تُعبِّر عن الشُّعور والتفكير،وتُترجم تعقيداتِ العَالَم الخارجي إلى أنساق اجتماعية يُدركها العقلُ،مِن أجل تفسيرها والاستفادة منها.
التوفيق والتلفيق والهوية الاجتماعية - إبراهيم أبو عواد
1
الهُوية الاجتماعية لَيست تعبيرًا عن الولاء والانتماء فَحَسْب،بَل هي أيضًا تعبير عن السلوك الحياتي اليَومي، ودَوره المركزي في تثبيت شرعية وُجود الإنسان ، وتحقيق الجوهر التاريخي عن طريق توليد أنساق اجتماعية إبداعية ، وتكوين مناهج فكرية تحليلية ، وعدم الاكتفاء بالتلفيق بين الأضداد والعناصر المتعارضة ، ودفن النار تحت الرماد ، فالإنسانُ لن يستعيد جوهرَه الوجودي في بناء التاريخ إلا بالمشاركة في صناعة الأحداث ، وعدم التفرُّج عليها ، ولن يحصل المجتمعُ على شرعيته المركزية في مشروع النهضة الحضارية إلا بتشكيل سُلطة اعتبارية قائمة على قوة المنطق لا منطق القوة، تجمع كُلَّ الأطياف والتيارات ، وتعتمد مبدأ التَّوفيق لا التَّلفيق .
2
أهمية الخيال في التفاعل الاجتماعي - إبراهيم أبو عواد
1
تحليل عناصر التفاعل الاجتماعي لا يعني تمزيق الروابط الإنسانية بين المُكوِّنات الاجتماعية ، وإنَّما يعني وضع الطبيعة الرمزية للفرد والمجتمع تحت مجهر الشعور الإنساني ، لأن الفرد يتحرَّك في المجتمع انطلاقًا مِن شُعوره الداخلي الذي يُحتِّم عليه الانخراط في حركة التاريخ الجماعي ، وأن يكون جُزءًا مِن الكُل ، ولَبِنَةً في صَرْح المجتمع الحَي ، الذي يُدرِك أبعادَ ذاته ، ويُدرِك حُدودَ مجاله الحيوي . وحياةُ المجتمع لا تتكرَّس كواقع محسوس وحقيقة شرعية إلا إذا أدركَ المجتمعُ كِيانَه والكِيانات المُحيطة به . وهذه الإدراك يُمثِّل الخُطوة الأُولَى لتفسير مُكوِّنات الذات ، وعلاقتها بالآخَر، سواءٌ كان الآخَر داخليًّا أَم خارجيًّا. والعاجزُ عن إدراك ذاته ، لن يستطيع تفسيرها ، ومَن لَم يَمتلك الوعي بالذات والآخَر ، لن يستطيع تكوين روابط بينهما قائمة على الاحترام المتبادل، وهذا يعني وُجود احتمالية كبيرة للصِّدام بينهما .
التاريخ المنسي في أعماق الإنسان - إبراهيم أبو عواد
1
الإشكالية الفكرية التي يقع فيها الإنسانُ أثناء مساره الحياتي، تتجلَّى في بَحثه عن تاريخ الأمم والشعوب ، ونِسيان تاريخه الشخصي الذي يعيش في أعماقه الداخلية. وهذه العملية ناتجة عن عدم تقدير الإنسان لنَفْسه، فهو يعتقد أنَّه مُجرَّد عُنصر هامشي في المجتمع الإنساني ، ورَقْم عابر في الحضارة الكَونية ، وهذه القناعة الوهمية التي تجذَّرت في أفكار الإنسان ومشاعره ناتجة عن ضغط النظام الاستهلاكي المادي ، الذي جَعل الإنسانَ مَحصورًا في دائرة الوعي السلبي ، ومُحَاصَرًا بالسلوكيات الاجتماعية التي تكرَّست كمُسلَّمات بفِعل العادات والتقاليد ، ولَيس بفِعل الحُجَّة والمنطق . وهذا أدَّى إلى دَوَرَان الإنسان حول نَفْسه دُون أن يُفكِّر في اكتشافِ نَفْسه ، وإخضاعِ أفكاره لقواعد المنهج العِلمي الذي يقوم على قُوَّة الأدلة وشرعية البراهين . والدَّوَرَان في هذه الحَلْقة المُفرَغة يُفَرِّغ الإنسانَ من طاقته الروحية ، ويُفقِده الثقةَ بالنَّفْس ، ويُجرِّده من امتداده المصيري في الوجود والمجتمع واللغة .
تفاهة الشر.. كيف تحول النظم الفاشية العاديين إلى أشرار؟ - إسلام كمال
عام 1995، كتب أستاذ القانون والقاضي الألماني "برنارد شيلنك" روايته "القارئ" التي حققت نجاحا هائلا كونها أعلى إيرادات للبيع، وتُرجِمت إلى أكثر من 27 لغة حول العالم، وأُدرِجت في مناهج دراسية حول أدب المحرقة، وتحوَّلت إلى فيلم سينمائي من بطولة "كيت وينسلت" عام 2008. تحكي الرواية عن شخصية ألمانية لامرأة عادية جدا، تعمل جابيةَ تذاكرٍ في إحدى المحطات في ألمانيا الغربية، يقع في غرامها شاب في مقتبل العمر، ليكتشف بعد اختفائها لسنوات أنها واقعة تحت محاكمة لارتكابها فعلا نازيًّا بإحراق مجموعة من اليهوديات داخل كنيسة.