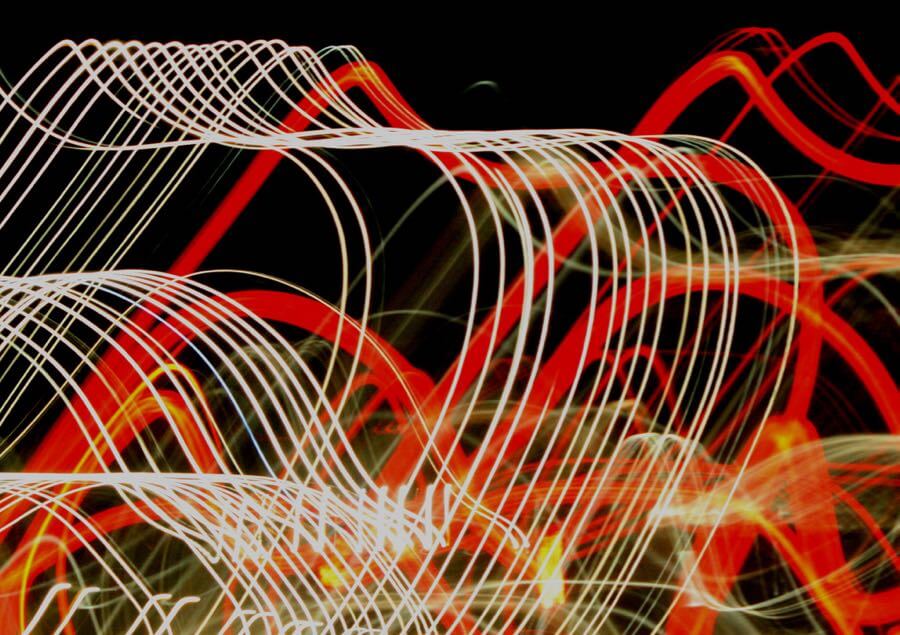أعياه المكوث في بيته على مدار الأيام المنصرمة. فجلوسه المنتظم في إحدى زوايا البيت كان قد أثارفي نفسيته انقباضا بلغ حد القرف.
هادئا كان الفضاء الذي يقطنه ويعيش على إيقاعه، ومع ذلك لم يدرك بشير في تلك اللحظة ارتسامات أناس حدثوه عن جاذبية هاته القرية. فانبهارهم برونق طبيعتها جعلهم يضفون عليها أسماء كزمردة الأطلس، وجوهرة سيمير اميس ثم جنة عدن. إلا أن بشير لم يكن من هؤلاء ولا من أولئك. كان بشير وحيدا في أعماق وحدته منذ أن حط رحاله هنا في منتصف شهر دجنبر حيث استقبله وابل من المطر و رياح باردة..
عن ميتافيزيقا الرغبة – نص: عبد الحفيظ أيت ناصر
أليس هذا غريبا، وهل هناك شيء يؤلم أكثر من الغربة، إن أي شيء ينتهي ليس صادقا او انه ليس موجودا، ولكن حتى الصباحات الجميلة تنتهي.
ليس الذي يؤلم الانسان هو ان ينتهي الصباح ولا حتى ان يسرع المساء الى الذهاب، الذي يؤلم حقيقة هو ان يعيش الانسان بين الصباحات والمساءات غريبا.
كانت هناك يمامة تعيش في شجرة خروب قديمة، لا ادري ان كانت تتألم لأنها تعيش لوحدها، على الاغلب كنت اراها حزينة ذلك لأني لم افهم الامر جيدا حينها. وبقليل من النور الساطع عرفت ان اليمامة كانت تعيش وحدتها ولم تكن تعيش وحيدة، وثمة فرق شاسع بين الامرين؛ ان يعيش المرء وحدته وأن يعيش وحيدا، والذي يثير الألم هو الأمر الثاني بينما الأمر الأول يثير البهجة. والبهجة غير السعادة، فلسنا اغبياء الى الدرجة التي نحاول فيها التحدت عن هذه الفكرة الفاسدة.
أمي الكبيرة – قصة: أمينة شرادي
جلست تشكو حالها الى نعجتها الوحيدة والهزيلة التي تؤنس وحدتها بكوخها الضارب في الكبر. سنوات وهي تنتظر يوم الفرج، يوم قد يأتي أو لا يأتي. تعيش بين كتل من الثلوج أيام فصل بارد وجفاف غاضب يوم يحل الصيف كعملاق يبتلع كل القرية. مرت عليها أيام ساخنة كسخونة بركان غاضب. لم تكن "أمي الكبيرة" تقوى على الصعود ان هي نزلت الى السفح لتبحث عن العشب لنعجتها ولجلب الماء بجسدها النحيل الذي يتأوه من شدة التعب. كانت تقضي يومها في المشي والاستراحة والعشب ينام على ظهرها المقوس بفعل الزمن ويمنعها من الحركة بكل حرية. يمضي نصف اليوم وهي ما تزال تئن من التعب مع ابتسامة غريبة تستوطن ملامحها الباهتة، هل هي ابتسامة الرضى ام السخرية من قدرها. لما تصل الى كوخها البئيس والحنون وتنفرج أسارير وجهها فتبدأ في النداء على نعجتها كأنها طفلتها كانت تنتظرها بعدما أنهكها الجوع.
عجوز المعبر – قصة: الحسين لحفاوي
لم تمنعها سنواتها الثمانون من الوقوف في آخر الطابور، فكم انتظرت مثل هذا اليوم لتكون على بعد معبر لتقبّل تراب وطن غابت عنه طويلا. وحيدة جاءت تكابد كي تحمل حقيبتها شبه الخاوية وعكازها الذي لازمها منذ عقد.
الصف ممتد وطويل كيوم قائظ، والعرق يتصبب من الجباه، والعيون تبحلق في الفراغ. انتظموا جميعا في صف ممتد كحبات عنقود، ألوان وأجناس من العابرين، الكل يرغب في المرور. سألت رجلا يتسمر جامدا أمامها كالتمثال، أرادت أن تفتح معه كوة للحديث "منذ متى وأنتم هنا"؟ أجابها بحياد دون أن يدير رأسه إليها: "منذ ما يزيد عن الساعتين". لم يرحم ضعفها ووحدتها وغربتها. وتساءلت في سرها أكان سيجيبها بهذا البرود لو أنها سألته هذا السؤال منذ خمسين عاما عندما كان خداها ينثران أريجهما وعندما كانت سنواتها الثلاثين تضج بأنوثتها؟ عله يكون غريبا ووحيدا مثلها، أو عله ضجر من طول الانتظار فلم يُبْدِ رغبة في الكلام وآثر الصمت، أم تراه من أولئك الذين يعتبرون المرأة شر لابد من تجنبه؟
نعيمة والفيلتر – د.السعيد اخي
يحكى ان فتاة بعثت لخطيبها صورا معدّلة ومفلترة لتظهر بمظهر حسن ولتسكن قلب الخطيب من أول نظرة، وكان ذلك كذلك، توصل الخطيب وكله شوق لرؤية الفتاة التي اختارتها السيدة الوالدة ، كان الشاب لا يرد للوالدة طلبا، نعم لقد كان وحيدها ، وكان بعيدا عنها بحكم عمله بايطاليا ، اختارت الام نعيمة بنت الجيران ووافق الشاب لانه يعرف نعيمة عندما كان سنها يوم رمق محياها عشرة أعوام ، تغيرت نعيمة ونال منها الزمن و الفقر وشمس قلعة السراغنة اللافحة ، والان سنها خمسة وعشرون عاما. عندما طلبت منها الوالدة ان ثبعت لولدها صورها اشترطت عليها ان تركز على الوجه والقامة والجيد ، احتارت نعيمة وسخّرت كل وسائل الاتصال ، لتكون في موعد التألق والنشوة ، كثيرات هن صاحبات الفضل على نعيمة كل واحدة زفّت لها بفتوى بل أخريات أخذن صورها فبدأ التعديل والفلترة والإضاءة ، تحولت نعيمة وكأنها نجمة نجمات هوليوود، من حقها مادامت الخديعة والتدليس وإخفاء العيب ممكنا، هكذا تجرأت نعيمة وأرسلت الصور دفعة واحدة للخطيب عبر تقنية واتساب والدته ، حيث لم تكن تملك رقم هاتف الخطيب .
يوميات حسن سعيد – قصة: فراس ميهوب
لا أحد يعرف سرَّ ابتسامة حسن سعيد التي لا تفارقه، طفولته لم تكن كلها سعيدة، لكنه كان يراها كذلك، لم يغير فيه موت الأم ولا فقدان الأب.
طُرِد حسن سعيد من المدرسة لأن مديرها اعتبر تعابير وجهه ساخرة أكثر مما يجب.
لم يكن له إلا صديق واحد، عزيز، كسب ثقته لأنه امتدح ملامحه الملائكية.
عمل حسن في مطبعة بدخل ضئيل، لم يشعر بالتعب، رآه بعين الرضى.
ابتسم يوم طرق الحبُّ بابه، طار من الفرح أسابيعا، أغرقته الحبيبة بالشروط، بيت مستقل، عرس في صالة أفراح فارهة، شهر عسل في فندق على شاطىء البحر، اعتبر مطالبها
التسكُّع – قصة: عمر بن عيسى
كنتُ تائها... شاردا.. أمشي في رواق الحرم الجامعي متَّئد الخطى... معلقا محفظتي على كتفي... لا أدري أين أمشي، ولا كيف أكون...
كنت أنظر حواليَّ في الطلبة والطالبات.. لأبحث عمَّن يشبهني.. عمَّن يقاسمني شرودي الذي ما عدتُ أفهمه... لكني في كل مرة لا أجد ضالتي...
طلبة مجتمعون هنا وهناك ليسوا إلا مختلفين عني، إن ضحكاتهم تتعالى..، لتصطدم بي، لترسم ملامح متعرجة على وجهي... أحاول أن أتصنع ابتسامة صفراء لأبدوَ مثلهم، لكن هنالك شيئا مّا في داخلي يمنعني، يخبرني ويلح أن أكون نفسي، ليس من الضروري في شيء أن أسايرهم...
وفي غمرة ذلك أرفع رأسي.. لأجد لافتة كبيرة معلقة في مدخل المدرَّج، أقرأها: "أنتم طلاب العلم، بكم نبني مستقبلنا..."
من الجبل إلى المحيط تذكرة ذهاب وإياب – نص: حسن إدحم
1
صفحات فارغة،
ما قيدته في هذا الكناش قليل، كنت أود أن يكون هذا الكناش بمثابة ذاكرة ورقية أستودعها بعضا من أحداث هذه السنوات الستة التي أمضيتها بالصويرة، ولكن عندما أطالعه اليوم أصاب بخيبة كبيرة، إني لا أكاد أعثر بين صفحاته إلا على جمل لا معنى لها، أو على فقرات كتبت على عجل بدون سياق.
أنهزم دوما أمام أوهام التأجيل المستمرة، لا أتغلب على نفسي التي تغريني بمتسع الوقت الذي أمامي لتدوين الوقائع العظام التي ستأتي تباعا، أما توافه الأمور اليومية، فلا تستحق عناء التقييد، فقد لا تكون بقدر ثمن الحبر الذي تدبج به. أقلب هذه الصفحات اليوم وأنظر فيها كأنها تلعنني قائلة: أين فتوحاتك الكبيرة، وفي أي موضع خلفت انتصاراتك المباركة؟ ولماذا لم ترسم على وجهي؟. فرق كبير دوما بين رغباتنا الكبيرة وما نستطيع أن نسرقه من الأيام ونجعله واقعا متحققا، فعندما حللت بالصويرة، أخذت هذا الكناش وقلت أنه سيكون رفيقا ومعينا، أعود إليه كل مرة لأستودعه ما أراه، وما أتوصل إليه من نظر في شؤون الحياة الجديدة بهذه المدينة، غير أن هذا كله لم يقع على الوجه الذي أردت.